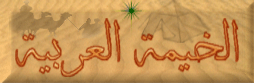
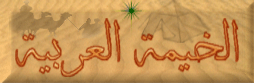 |
7- حَذْفُ المُنادى
قد يُحذّف المنادى بعد (يا) كقوله تعالى: {يا ليتني كنت معَهم، فأفوزَ فوزاً عظيماً}، وقولِكَ: (يا نَصَرَ اللهُ من يَنصُرُ المظلومَ)، وقول الشاعر: أَلاَ يا اسْلَمي يا دارَ مَيَّ، عَلى الْبَلى وَلا زالَ مُنْهَلاً بِجَرْعائِكِ الْقَطْرُ [الجرعاء: الرملة الطيبة، وأراد بها منزلها الذي تنزل فيه حيث هذه الرملة] (والتقدير يكون على حسب المقام. فتقديره في الآية الأولى: (يا قوم)، وفي الثانية: (يا عبادي)، وفي المثال الثالث، (يا قوم)، وفي الشعر: (يا دار)). والحقُّ أن (يا) أَصلُها حرفُ نداءٍ، فإن لم يكن مُنادَى بعدها كانت حرفاً يُقصَدُ به تنبيهُ السامع إلى ما بعدَها. وقيلَ: إن جاءَ بعدها فعلُ أَمر فهيَ حرفُ نداءٍ، والمنادَى محذوف، نحو: (ألا يا اسجدوا). والتقدير ألا يا قومُ. ونحو: (أَلا يا اسلمي) والتقدير أَلا يا عَبْلةُ .... وإلاّ فهيَ حرفُ تنبيهٍ، كقولهِ تعالى: (يا ليتَ قومي يَعلمونَ). 8- المُنادى المَضافُ إِلى ياءِ المُتَكلِّم المنادى المضافُ إلى ياءِ المتكلمِ على ثلاثة أنواعٍ: اسمٍ صحيحِ الآخرِ، واسمٍ مُعتلٍّ الآخرِ، وصفةٍ. والمُرادُ هنا اسمُ الفاعل واسمُ المفعولِ ومبالغةُ اسمِ الفاعل. فإن كان المضافُ إلى الياءِ اسماً صحيحَ الآخر، غيرَ أب ولا أُم، فالأكثرُ حذف ياءِ المتكلمِ والاكتفاءُ بالكسرةِ التي قبلَها، كقوله تعالى: {يا عبادِ فاتَّقُون}. ويجوز إثباتها ساكنةً أو مفتوحةً، كقولهِ عزَّ وجلَّ: {يا عبادِي لا خوفٌ عليكم} وقوله: {يا عباديَ الذينَ أَسرفوا على أَنفسهم}. ويجوزُ قلبُ الكسرةِ فتحةً والياءِ أَلفاً، كقوله تعالى: {يا حَسرتا على ما فرَّطتُ في جَنبِ الله}. وإن كانَ المضافُ إلى (الياءِ) معتلَّ الآخرِ، وجبَ إثباتُ الياءِ مفتوحةً لا غيرُ، نحو: (يا فتاي. يا حامِيَّ). وإن كان المضافُ إليها صفةً صحيحةَ الآخر، وجبَ إثباتُها ساكنةً أو مفتوحةً، نحو: (يا مكرميْ. يا مُكرمِيَ). وإن كان المضافُ إليها أباً أَو أُمّاً، جاز فيهِ ما جازَ في المنادَى الصحيح الآخر، فتقول: (يا أَبِ ويا أُمِّ. يا أَبي ويا أُمي. يا أَبيَ ويا أُميَ. يا أبا ويا أُمّا) ويجوزُ فيه أَيضاً حذفُ ياءِ المتكلم والتَّعويضُ عنها بتاءِ التأنيثِ مكسورةً أَو مفتوحةً، نحو: (يا أَبَتِ ويا أُمَّتِ. يا أَبَتَ يا أُمَّتَ). ويجوزُ إبدالُ هذهِ التاءِ هاء في الوقفِ، نحو: (يا أَبَهْ ويا أُمَّهْ). وإن كان المنادَى مضافاً إلى مضافٍ إلى ياءِ المتكلم، فالياءُ ثابتةٌ لا غيرُ، نحو: (يا ابنَ أَخي. يا ابنَ خالي) إلاّ إذا كان (ابنَ أُمّ) أو (ابن عمّ) فيجوزُ إثباتُها، والأكثر حذفُها والاجتزاءُ عنها بفتحةٍ أَو كسرةٍ. وقد قرئ قوله تعالى: {قال: يا ابنَ أمَّ، إنَّ القومَ استضعفوني}، وقوله: {قال: يا ابنَ أُمَّ لا تأخذْ بِلحيتي ولا برأسي}، بالفتح والكسر. فالكسر على نيّةِ الياءِ المحذوفة، والفتحُ على نيّةِ الألفِ المحذوفةِ التي أَسلُها ياءُ المتكلم. ومثلُ ذلكَ يُقال في (يا ابنَ عمَّ) قال الراجز: كُنْ لِيَ لاَ عَليَّ، يا ابنَ عَمَّا نَعشْ عَزِيزَينِ، ونُكْفَى الهَمّا ويجري هذا أيضاً مع (ابنةِ أُمِّ) و (ابنةِ عَم). واعلم أنهم لا يكادون يُثبتون ياءَ المتكلم، ولا الألفَ المنقلبةَ عنها، إلا في الضرورةِ، فإثباتُ الياء كقوله: يا ابنَ أُمِّي، ويا شُقَيِّقَ نَفْسِي أَنتَ خَلَّقْتَني لِدَهرٍ شَديدِ وإثباتُ الألف المنقلبة عنها، كقول الآخر: يا ابنةَ عَمَّا، لا تَلُومِي واهجَعي لا يَخْرُقُ اللَّوْمُ حِجابَ مِسْمَعي |
9- المُنادى المُسْتَعاثُ
الاستغاثةُ: هي نداءُ من يُعينُ من دفع بلاءٍ أو شدَّة، نحو: (يا للأَقوياءِ لِلضُّعفاءِ). والمطلوبُ منه الإعانةُ يسمّى (مُستغاثاً)، والمطلوبُ له الإعانةُ يُسمّى "مُستغاثاً لهُ). ولا يُستعملُ للاستغاثةِ من أحرف النداءِ إلا (يا). ولا يجوزُ حذفُها، ولا حذفُ المُستغاث. أما المستغاث له فحذفه جائز، نحو: (يا للهِ). وللمستغاث ثلاثةُ أوجهِ: أ- أن يُجرَّ بلامٍ زائدةٍ واجبةِ الفتحِ، كقول الشاعر: يا لَقَوْمي، ويا لأَمثالِ قَوْمي لأُناسٍ عُتُوُّهُمُ في ازدِيادِ! وقول الآخر: تَكَنَّفَني الوُشاةُ فأَزْعَجُوني فَيا لَلنَّاسِ لِلْواشي المُطَاع! وقولِ غيره: يا لَقَوْمي! مَنْ لِلْعُلاَ والْمَساعِي؟ يا لَقَوْمي! مَنْ لِلنَّدَى والسَّماحِ؟ يا لَعَطَّافِنا! ويَا لَرِياح وَأَبي الحَشْرَجِ الْفَتَى النَّفَّاحِ! [يرثي الشاعر رجالاً من قومه هذه أسماؤهم. يقول: لم يبق للعلى والمساعي من يقوم بها بعدهم. والنفاح: الكثير العطاء] ولا تُكسر هذه اللامُ إذا تكرَرَ المستغاثُ غيرَ مقترنٍ بـ (يا) كقول الشاعر: يَبْكيكَ ناءٍ، بَعِيدُ الدَّارِ، مُغْتَرِبٌ يا لَلْكهُولِ وَلِلشُّبَّانِ لِلْعَجَبِ! ب- أن يُختَم بألفٍ زائدةٍ لتوكيد الاستغاثة، كقول الشاعر: يا يَزِيدا لآمِلٍ نَيْلَ عِزٍّ وَغِنًى بَعْدَ فاقَةٍ وهَوَانٍ! [ يزيدا: مُنادى مفرد معرفة، مبني على ضمٍ مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال محله بالفتحة العارضة لمناسبة الألف الزائدة لتوكيد الاستغاثة] ج- أن يبقى على حاله، كقول الآخر: أَلا يا قَوْمُ لِلعَجَبِ الْعَجيبِ! ولِلْغَفَلاتِ تَعْرِضُ لِلأَديبِ! أمّا المُستغاثَ له، فإن ذُكِرَ في الكلام، وجبَ جرُّهُ بلامٍ مكسورة دائماً، نحو: (يا لَقومي لِلعلمِ!). وقد يجر بِـ (مِنْ)، كقول الشاعر: يَا لَلرِّجالِ ذَوي الأَلبابِ مِنْ نَفَرٍ لا يَبْرَحُ السَّفَهُ المُرْدِي لَهُمْ دِيناً! 10- المُنادى المُتَعَجَّبُ مِنهُ المُنادى المُتعجَّبَ منه، هو كالمُنادَى المُستغاثِ في أحكامهِ، فتقولُ: في التعجّب من كثرةِ الماءِ: (يا لَلماءِ!. يا ماءَا!. يا ماءُ!). وتقولُ: (يا لَلطربِ!. يا طرَبا. يا طَرَبُ!). [يا: حرف نداء للتعجب. واللام حرف جر زائد لتوكيد التعجب. والماء مجرور لفظاً باللام الزائدة، منصوب محلاً على النداء. وإعراب الأمثلة الباقية كإعراب أمثلة المُنادى المُستغاث] |
11- المُنادَى الْمَنْدوب النُّدبةُ: هي نداءُ المُتفجَّعِ عليه أو المُتوجَّعِ منه، نحو: (واسَيّداه!. واكَبِداه!). ولا تُستعملُ لنداءِ المندوب من الأدواتِ إلا (وَا). وقد تُستعملُ (يا)، إذا لم يَحصُلِ التباسٌ بالنداء الحقيقي. ولا يجوز في النُّدبةِ حذفُ المنادَى ولا حذفُ أداتهِ. وللمنادَى المندوب ثلاثةُ أوجه: أ- أن يُختَم بألفٍ زائدةٍ لتأكيد التَّفجُّعِ أو التوجُّع، نحو: (واكَبِدَا!). [وا: حرف نداء للندبة. كبدا: منادى مندوب، نكرة مقصودة، مبني على ضم مقدر، منع من ظهوره الفتحة العارضة لمناسبة الألف الزائدة لتأكيد الندبة] ب- أن يُختَم بالألفِ الزائدة وهاءِ السَّكتِ، نحو: (واحُسَيناه). (وأكثر ما تزاد الهاء في الوقف فان وصلت حذفتها، إلا في الضرورة، كقول المتنبي: (واحرّ قلباهُ ممن قلبه شبِمُ). ولك حينئذ أن تضمها، تشبيهاً لها بهاء الضمير. وان تكسرها على أصل التقاء الساكنين. وأجاز الفرّاء إثباتها في الوصل مضمومة أو مكسورة من غير ما ضرورة). ج- أن يبقى على حاله، نحو: (واحُسينُ!). ولا يكونُ المنادى المندوبُ إلا معرفةً غيرَ مبهَمةٍ. فلا يندَبُ الاسمُ النكرةُ، فلا يقال: (وَا رجلُ!)، ولا المعرفةُ المُبهمَة - كالأسماءِ الموصولة وأسماءِ الإشارة - فلا يقال: (وامَنْ ذهبَ شهيدَ الوفاءِ!)، إلا إذا كان المُبهمُ اسمَ موصولٍ مُشتهرِاً بالصّلة، فيجوزُ، نحو: (وا مَنْ حَفرَ بِئرَ زمزمَ). 12- المُنَادى المُرَخَّم التَّرخيمُ: هو حذفُ آخرِ المنادى تخفيفاً،، نحو: (يا فاطمَ). والأصلُ: (يا فاطمةُ). والمنادى الذي يُحذفُ آخرُهُ يُسمّى (مُرَخمّاً). ولا يُرخَّمُ من الأسماءِ إلا اثنان: أ- ما كان مختوماً بتاءِ التأنيث، سواءٌ أكان عَلَماً أو غيرَ عَلَم، نحو: (يا عائشَ. يا ثِقَ. يا عالِمَ)، في (عائشةَ وثِقَةٍ وعالمةٍ). ب- العَلمُ لمذكَّرٍ أو مؤنثٍ على شرط أن يكونَ غيرَ مركَّبٍ، وأن يكون زائداً على ثلاثة أحرفٍ، نحو: (يا جَعفَ. يا سُعا)، في (جعفرٍ وسعادَ). (فلا ترخم النكرة، ولا ما كان على ثلاثة أحرف ولم يكن مختوماً بالتاء، ولا المركب. فلا يقال: (يا إنسا)، في (إنسان)، لأنه غير علم، ولا (يا حسَ)، في (يا حسن)، لأنه على ثلاثة أحرف، ولا مثل: (يا عبدَ الرحمن). لأنه مركب. وأما ترخيم (صاحب) في قولهم (يا صاحِ)، مع كونه غير علم، فهو شاذّ لا يقاس عليه). ويُحذَفُ للتَّرخيم إمّا حرفٌ واحدٌ، وهو الأكثر، كما تقدّم، وإمّا حرفانِ، وهو قليل. فتقول: (يا عُثَم. يا مَنْصُ)، في (عُثمانَ ومنصورٍ). ولك في المنادى المرخَّمِ لغتانِ: أ- أن تُبقيَ آخرَهُ بعدَ الحذفِ على ما كان عليه قبلَ الحذف - من ضَمَّةٍ أو فتحةٍ أو كسرةٍ - نحو: (يا منصُ. يا جعفَ. يا حارِ)[في منصور وجعفر وحارث]. وهذهِ اللغةُ هي الأولى والأشهرُ. ب- أن تُحرّكهُ بحركة الحرف المحذوف، نحو: (يا جَعفُ. يا حارُ). (وتسمى اللغة الأولى: (لغة من ينتظر)، أي: من ينتظر الحرف المحذوف ويعتبره كأنه موجود. ويقال في المنادى حينئذ: أنه مبني على ضم الحرف المحذوف للترخيم. وتسمى اللغة الأخرى: (لغة من لا ينتظر)، أي: من لا ينتظر الحرف المحذوف، بل يعتبر ما في آخر الكلمة هو الآخر فيبنيه على الضم). 13- أَسْماءُ لازَمَتِ النِّداءَ منها: (يا فُلُ، ويا فُلَةُ)، بمعنى. يا رجل، ويا امرأةُ، و (يا لُؤمانُ) أي: يا كثيرَ اللؤم، و (يا نَوْمانُ)، أي: يا كثيرَ النَّومِ. وقالوا (يا مَخبَثانُ، ويا مَلأمانُ، ويا مَلكَعانُ، ويا مَكذَبانُ، ويا مَطيَبانُ، ويا مَكرَمانُ). والأنثى بالتاءِ. وقالوا في شتم المذكَّرِ: (يا خُبَثُ، ويا فُسَقُ، ويا غُدَرُ، ويا لُكَعُ). وكلُّ ما تقدَّم سَماعيٌّ لا يقاسُ عليهِ. وقاسهُ بعضُ العلماء فيما كان على وزنِ (مَفعَلان). وقالوا في شتم المؤنث: (يا لَكاعِ، ويا فَساقِ، ويا خَباثِ). ووزنُ (فَعالِ) هذا قياسيٌّ من كل فعلٍ ثلاثيٍّ. [الملكعان: اللئيم. وهو مأخوذ من لكع يلكع لكعاً، بوزن فرح يفرح فرحاً، أي: لؤم وحمق. و (لُكع ولكاع) من هذه المادة ومعناها. ويقال: لكع عليه الوسخ، أي لزمه ولصق به] وما ذُكرَ من هذه الأسماءِ كلّها لا يستعملُ إلا في النداءِ، كما رأيتَ. وأما قولُ الشاعر: أُطَوِّفُ ما أُطَوِّفُ، ثُمَّ آوِي إِلى بَيْتٍ قَعِيدَتُهُ لَكاعِ فضرورةٌ، لاستعمالهِ (لكاعِ) خَبراً، وهي لا تُستعملُ إلا في النداءِ. 14- تَتمَّةٌ في كلامِ العربِ ما هو على طريقةِ النداءِ ويُقصَدُ به الاختصاصُ لا النداءُ، وذلك كقولهم: (أمّا أنا فأفعلُ كذا أيّها الرجلُ)، وقولهم: (نحن نفعلُ كذا أيُّها القومُ)، وقولهم: (اللهمَّ اغفرْ لنا أيَّتُها العِصابة). فقد جعلوا (أيّا) معَ تابعها دليلاً على الاختصاص والتوضيح. ولم يُريدوا بالرجل والقوم إلا أنفسَهم. فكأنهم قالوا: (أما أنا فأفعلُ كذا متخصّصاً بذلك من بين الرجال، ونحن نفعلُ كذا متخصّصينَ من بين الأقوام. واغفر لنا اللهمَّ مخصوصينَ من بينِ العصائب). |
( حروف الجر )
حروفُ الجرِّ عشرون حرفاً، وهي: (الباء ومِن وإلى وعن وعلى وفي والكافُ واللاَّمُ وواوُ القَسَمِ وتاؤهُ ومُذْ ومُنذُ ورُبَّ وحتى وخَلا وَعدَا وحاشا وكي ومتى - في لُغَةِ هُذَيل - ولَعَلَّ في لغة عُقَيل). وهذهِ الحروف منها ما يختصّ بالدخولِ على الاسمِ الظاهر، وهي (رُبَّ ومُذْ ومُنذُ وحتى والكافُ وواوُ القسمِ وتاؤهُ ومتى). ومنها ما يدخلُ على الظاهر والمَضمَر، وهي البواقي. واعلم أنَّ من حروفِ الجرِّ ما لفظُهُ مُشترَكٌ بينَ الحرفيّةِ والاسميّة، وهي خمسةٌ: (الكافُ وعن وعلى ومُذْ ومُنذُ). ومنها ما لفظُهُ مُشتركٌ بينَ الحرفيّة والفعليّةِ، وهو: (خلا وعدا وحاشا). ومنها ما هو ملازم للحرفيّة، وهو ما بقي. وسيأتي بَيانُ ذلك في مواضعهِ. وسُمّيت حروف الجرّ، لأنها تَجرُّ معنى الفعل قبلَها إلى الاسم بعدَها، أو لأنها تجرُّ ما بعدَها من الأسماءِ، أي: تَخفِضُه. وتسمّى (حروفَ الخفض) أيضاً، لذلك. وتُسمّى أيضاً "حروف الإضافة"، لأنها تُضيفُ معانيَ الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدها. وذلك أنَّ من الأفعال ما لا يَقوَى علىالوصول إلى المفعول به، فَقوَّوه بهذه الحروف، نحو: (عجبتُ من خالدٍ، ومررتُ بسعيدٍ). ولو قلتَ: (عجبتُ خالداً. ومررتُ سعيداً)، لم يُجُز، لضعف الفعل اللازم وقُصورهِ عن الوصول إلى المفعول به، إلا أن يَستعينَ بحروف الإضافة وفي هذا المبحث تسعةُ مَباحث. أ- شرْحُ حُرُوفِ الجَرِّ 1- الباءُ الباءُ: لها ثلاثةَ عشرَ معنًى: 1- الإلصاقُ: وهو المعنى الأصليُّ لها. وهذا المعنى لا يُفارقُها في جميع معانيها. ولهذا اقتصرَ عليه سِيبويهِ. والإلصاقُ إمّا حقيقيّ، نحو: (أمسكتُ بيدِكَ. ومسحتُ رأسي بيدي)، وإمّا مجازيٌّ، نحو: (مررتُ بدارِكَ، أو بكَ)، أي: بمكانٍ يَقرُبُ منها أو منكَ. 2- الاستعانةُ، وهي الداخلةُ على المستعانِ به - أي الواسطة التي بها حصلَ الفعلُ - نحو: (كتبتُ بالقلم. وبَرَيتُ القلمَ بالسكينِ). ونحو: (بدأتُ عملي باسمِ الله، فنجحتُ بتوفيقهِ). 3- السّببيةُ والتَّعليلُ، وهي الداخلةُ على سبب الفعل وعِلَّتهِ التي من أجلها حصلَ، نحو: (ماتَ بالجوعِ)، ونحو: (عُرِفنا بفلانِ). ومنه قولهُ تعالى: {فَكُلاُّ أخَذْنا بذنبه}، وقولهُ: {فبِما نقضِهم ميثاقَهمْ لَعنّاهم}. 4ـ التعدية، وتسمى باء النقل، فهي كالهمزة في تصييرها الفعل اللازم متعدياً، فيصير بذلك الفاعل مفعولاً، كقوله تعالى { ذهب الله بنورهم}، أي أذهبه، وقوله: {وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة}، أي لتنيء العصبة وتثقلها. وهذا كما تقول: (ناء به الحمل، بمعنى أثقله). ومن باء التعددية قوله تعالى { سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى} أي سيره ليلاً. 5ـ القسم، وهي أصل أحرفه، ويجوز ذكر فعل القسم معها؛ نحو (أقسم بالله). ويجوز حذفه، نحو (بالله لاجتهدن). وتدخل على الظاهر، كما رأيت، وعلى المضمر، نحو (بك لأفعلن) 6ـ العِوض، وتسمى باء المقابلة أيضاً، وهي التي تدل على تعويض شيء من شيء في مقابلة شيءٍ آخر، نحو ( بعتك هذا بهذا. وخذ الدار بالفرس). 7ـ البدَلُ، وهي التي تدلَّ على اختيار أحدِ الشيئينِ على الآخرِ، بلا عِوَضٍ ولا مقابلةٍ، كحديث: (ما يَسُرُّني بها حُمْرُ النّعَم)، وقولِ بعضهم: (ما يَسُرُّني أني شَهِدتُ بَدْراً بالعقبة) أي: بَدَلها، وقول الشاعر: فَلَيْتَ لِي بِهِمِ قَوْماً إذا رَكِبُوا شَنُّوا الإِغارةَ فُرْساناً ورُكْبانا 8- الظرفيّةُ - أي: معنى (في) - كقوله تعالى: {لَقَد نَصرَكمُ اللهُ بِبَدْرٍ. وما كنتَ بجانبِ الغربي. نجّيناهم بِسَحر. وإنَّكم لَتَمُرون عليهم مصبِحينَ وباللّيلِ}. 9- المصاحبةُ، أي: معنى (معَ)، نحو: (بعتُكَ الفَرَسَ بسرجهِ، والدارَ بأثاثها)، ومنه قولهُ تعالى: (اهبط بسلام). 10- معنى (مِن) التَّبعيضيّةِ، كقولهِ تعالى: {عَيناً يشربُ بها عبادُ اللهِ}، أي: منها. 11- معنى (عن)، كقولهِ تعالى: {فاسأل به خبيراً}، أي: عنهُ، وقولهِ: {سأل سائلٌ بعذابٍ واقعٍ}، وقوله: {يَسعى نورُهم بينَ أيديهم وبأيمانِهم}. 12- الاستعلاءُ، أي معنى (على) كقوله تعالى: (ومن أهلِ الكتابِ مَن إن تَأمَنهُ بِقِنطارٍ يُؤدَّهِ إليكَ)، إي: على قنطار، وقولِ الشاعر: أَرَبٌّ يَبُولُ الثُّعلُبانُ بِرَأْسِهِ لَقَدْ ذَلَّ مَنْ بالتْ عَلَيْهِ الثَّعالِبُ 13- التأكيدُ، وهي الزائدةُ لفظاً، أي: في الإعراب، نحو: (بِحَسبِكَ ما فعلتَ)، أي: حَسبُك ما فعلتَ. ومنهُ قوله تعالى: {وكفى باللهِ شهيداً}، وقولهُ: {أَلم يعلم بأنَّ اللهَ يرى}، وقولهُ: {ولا تُلقوا بأيديكم إلى التّهلُكة}، وقولهُ: {أَليس الله بأحكمِ الحاكمين؟} وسيأتي لهذه الباء فضلُ شرح. 2- مِنْ مِنْ: لها ثمانيةُ مَعانٍ: 1- الابتداءُ، أَي: ابتداءُ الغايةِ المكانيّةِ أو الزمانيّةِ. فالأول كقولهِ تعالى: {سبحانَ الذي أسرى بعبدهِ ليلاً من المسجد الحرامِ إلى المسجد الأقصى}. والثاني كقوله: {لَمَسجدٌ أُسسَ على التّقوى من أوَّلِ يوم أَحَقُّ أَن تقومَ فيهِ}. وتَرِدُ أَيضاً لابتداء الغاية في الأحداث والأشخاص. فالأول كقولك: (عَجبتُ من إقدامك على هذا العمل)، والثاني كقولك: (رأيتُ من زهير ما أُحبُّ). 2- التّبعيضُ، أي: معنى (بعض)، كقولهِ تعالى: {لن تنالوا البرَّ حتى تُنفقوا ممّا تُحبُّونَ} أي: بعضَهُ، وقولهِ: {منهم من كلّمَ اللهَ}، أَي بعضُهم. وعلامتُها أَن يَخلُفَها لَفظُ (بعضٍ). 3- البيانُ، أي: بيانُ الجنس، كقوله تعالى: {واجتنبوا الرجسَ من الأوثانِ}. قولهِ: {يُحَلَّونَ فيها من أَساورَ من ذهبٍ}. وعلامتُها أَن يصحَّ الإخبارُ بما بعدَها عمّا قبلها، فتقول: الرجس هي الأوثانُ، والأساورُ هي ذهب. واعلم أَن (من) البيانيّةَ ومجرورَها في موضعِ الحال مما قبلَها، إن كان معرفةً، كالآية الأولى، وفي موضع النّعتِ له إن كان نكرة، كالآية الثانية. وكثيراً ما تَقَعُ (من البيانيّةُ) هذهِ بعد (ما ومهما)، كقوله تعالى: {ما يَفتَحِ اللهُ للناسِ من رحمةٍ فلا مُمسِكَ لها}، وقولهِ: {ما ننْسَخْ من آيةٍ}، وقولهِ: {مهما تأتِنا به من آية}. 4- التأكيدُ، وهي الزائدة لفظاً، أي: في الإعراب، كقوله تعالى: {ما جاءنا من بشيرٍ}، وقولهِ: {لجعَلَ منكم ملائكةً في الأرضِ يَخلُفون}أي: (بَدَلكم)، وقولهِ: {لن تُغنيَ عنهم أموالُهم ولا أولادُهم من الله شيئاً}، أي: بَدَلَ الله، والمعنى: بَدَلَ طاعتهِ أو رحمتهِ. وقد تقدَّم معنى البدل في الكلام على الباءِ. 6- الظَّرفيّة، أَي: معنى (في)، كقوله سبحانهُ: {ماذا خَلقوا من الأرض}، أي:فيها، وقولهِ: {إذا نُوديَ للصّلاة من يومِ الجمعة}، أي: في يومها.. 7- السّببيّةُ والتّعليلُ، كقوله تعالى: {مِمّن خطيئاتِهم أُغرِقوا}، قال الشاعر: يُغْضِي حَياءً، وَيغْضَى مِنْ مَهابَتهِ فَما يُكَلَّمَ إِلاَّ حِينَ يَبْتَسِم 8- معنى (عن)، كقولهِ تعالى: {فَوَيلٌ للقاسيةِ قُلوبُهم من ذِكر الله!}، وقولهِ: {يا وَيلَنا! لَقَد كُنّا في غفلة من هذا}. |
3- إِلى
إلى: لها ثلاثة معانٍ: أ- الانتهاءُ، أي: انتهاءُ الغايةِ الزمانيّة أو المكانيّة. فالأولُ كقولهِ تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصيامَ إلى الليل}، والثاني كقولهِ: {من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى}. وترِدُ أيضاً لانتهاء الغاية في الأشخاص والأحداث. فالأولُ نحو: (جئتُ إليك)، والثاني نحو: (صِلْ بالتّقوى إلى رضا الله). ومعنى كونها للانتهاءِ أنها تكونُ منتهًى لابتداء الغاية. أمّا ما بعدَها فجائزٌ أن يكون داخلاً جُزءٌ منه أو كلُّهُ فيما قبلَها، وجائزٌ أن يكونَ غيرَ داخل. فإذا قلتَ: "سرتُ من بيروتَ إلى دمَشقَ"، فجائزٌ أن تكون قد دخلتَها، وجائزٌ أنك لم تدخلها، لأنَّ النهايةَ تشملُ أولَ الحدّ وآخرَهُ. وإنما تمتنعُ مجاوزتُهُ. ومن دخول ما بعدَها فيما قبلَها قولهُ تعالى: {إذا قُمتُم إلى الصَّلاة فاغسِلوا وُجوهكُم وأيديَكُم إلى المَرافِق}. فالمَرافق داخلةٌ في مفهوم الغسل. ومن عدم دُخولهِ قولهُ عَزَّ وجلَّ: {ثمَّ أَتِمُّوا الصيامَ إلى الليل}. فالجزءُ من الليل غيرُ داخلٍ في مفهوم الصيام. وقالت الشيعةُ الجعفريةُ: إنه داخل. والآية - بظاهرها - مُحتملة للأمرينِ. فإن كان هناك قرينةٌ تدلُّ على دخول ما بعدَها فيما قبلَها، دخل، أو على عدم دخوله لم يدخل. فإن لم تكن قرينةٌ تدلُّ على دخوله أو خورجهِ، فإن كان من جنس ما قبلها جاز أن يدخل وأن لا يدخل، نحو: (سرتُ في النهار إلى العصر) وإلا فالكثير الغالبُ أنه لا يدخل. نحو: (سرتُ في النهار إلى الليل). وقال قوم: يدخل مطلقاً، سواءٌ أكان من الجنس أم لا. وقال قومٌ: لا يدخل مطلقاً. والحقّ ما ذكرناه. ب- المصاحبةُ، أي: معنى (معَ) كقوله تعالى: {قال: مَن أنصاري إلى الله؟} أي: معهُ، وقولهُ: {ولا تأكلوا أموالَهم إلى أموالكم}، ومنهُ قولهم: (الذَّوْدُ إلى الذَّوْدِ إبلٌ)، وتقولُ: (فلانٌ حليمٌ إلى أدبٍ وعلمٍ). ج- معنى (عند)، وتُسَمّى المُبَيّنَة، لأنها تُبينُ أن مصحوبها فاعلٌ لما قبلها. وهي التي تقعُ بعدَ ما يفيدُ حُباً أو بُغضاً من فعل تعجّبٍ أو اسمِ تفضيلٍ، كقوله تعالى: {قال: رب السّجنُ أحَب إليَّ مِمّا يدعونني إليه}، أي: أحبُّ عندي. فالمُتكلم هو المُحِبُّ. وقولِ الشاعر: أَمْ لا سَبيلَ إلى الشَّباب، وذِكْرُهُ أَشهى إِلَيَّ مِنَ الرَّحيقِ السَّلْسَلِ [الرحيق السلسل: الخمر، وأراد بها السهلة المساغ] 4- حَتَّى حتى: للانتهاء كإلى، كقوله تعالى: {سلامٌ هيَ حتى مَطلَعِ الفجر}. وقد يدخلُ ما بعدَها فيما قبلها، نحو: (بَذَلتُ ما لي في سبيل أُمَّتي، حتى آخر دِرهمٍ عندي). وقد يكون غيرَ داخلٍ، كقوله تعالى: {كلوا واشربوا حتى يَتبيّن لكمُ الخيطُ الأبيضُ من الخيط الأسود من الفجر}، فالصائم لا يُباحُ له الأكلُ متى بدا الفجر. ويَزعُمُ بعضُ النحاةِ أنّ ما بعدَ (حتى) داخلٌ فيما قبلها على كل حال. ويَزعُمُ بعضهم أنه ليس بداخلٍ على كل حال. والحقُّ أنه يدخلُ، إن كان جزءًا مما قبلها، نحو: (سِرتُ هذا النهارَ حتى العصرِ)، ومنه قولهم: (أكلتُ السمكة حتى رأسِها). وإن لم يكن جزءًا ممّا قبلها لم يدخلْ، نحو: (قرأتُ الليلةَ حتى الصَّباحِ) ومنه قولهُ تعالى {سلامٌ هيَ حتى مَطلَعِ الفجر}. واعلم أن هذا الخلافَ إنما هو في (حتى) الخافضة. وأما (حتى)العاطفة، فلا خلاف في أن ما بعدَها يجبُ أن يدخلَ في حكم ما قبلها، كما ستعلم ذلك في مبحث أحرف العطف. والفرق بينَ غلى وحتى أنَّ (إلى) تجرُّ ما كان أخراً لِما قبله، أو مُتّصلاً بآخره، وما لم يكن آخراً ولا متصلاً به. فالأولُ نحو: (سرتُ ليلةَ أمسِ إلى آخرها) والثاني نحو: (سهرتُ اليلةَ إلى الفجر)، والثالثُ نحو: (سرتُ النهارَ إلى العصر). ولا تجرُّ (حتى) إلا ما كان آخراً لِما قبلها، أو متّصلاً بآخره، فالأول نحو: (سرتُ ليلةَ امسِ حتى آخرِها)، والثاني كقوله تعالى: {سلامٌ هيَ حتى مَطلَعِ الفجر}. ولا تجرُّ، ما لم يكن آخراً ولا متصلاً به، فلا يقال: (سرتُ الليلةَ حتى نصفها). وقد تكونُ حتى للتَّعليل بمعنى اللام، نحو: (إتَّقِ اللهَ حتى تفوزَ برضاهُ)، أي: لتفوز. وقد تكونُ حتى للتَّعليل بمعنى اللام، نحو: (اتَّقِ اللهَ حتى تفوزَ برضاهُ)، أي: لتفوز. |
5- عَنْ
عن: لها ستة معانٍ: أ- المجاوزةُ والبُغدُ، وهذا أصلُها، نحو: (سرتُ عن البلدِ. رَغِبتُ عن الأمر. رَمَيت السهمَ عن القوس). ب- معنى (بَعد)، نحو: (عن قريبٍ أزُورُكَ)، قال تعالى: {عمّا قليلٍ لَتُصبحُنَّ نادمين}، وقال: {لَتركبُنَّ طَبَقاً عن طبَقٍ}، أي: حالاً بعدَ حالٍ. ج- معنى (على) كقولهِ تعالى: (ومَن يَبخَلْ فإنما بَبخَلُ عن نفسه)،أي عليها، ومنه قول الشاعر: لاَهِ ابنُ عَمِّكَ! لاَ أُفْضِلْتَ في حَسَبٍ عَنِّي. وَلا أَنتَ دَيَّاني فَتَخُزُوني د- التَّعليلُ، كقولهِ سبحانه: {وما نحنُ بتاركي آلهتِنا عن قولك}، أي: من أجل قولك، وقولهِ: {وما كان استغفارُ إبراهيمَ لأبيهِ إلا عن مَوعِدةٍ وعَدَها إيّاهُ}. هـ- معنى (مِن) كقوله سبحانه: {وهو الذي يَقبَلُ التَّوبةَ عن عبادهِ}، وقولهِ: {أُولئكَ الذين يَتقبّلُ عنهم احسنَ ما عَمِلوا}، أَي: منهم. و- معنى البَدَل كقولهِ تعالى: {واتَّقوا يوماً لا تجزي نَفسٌ عن نَفسٍ شيئاً}، أَي: بَدل نفس، وكحديثِ: (صومي عن أُمك)، وتقولُ: (قُمْ عني بهذا الأمر)، أَي: بَدَلي. واعلم أنَّ (عن) قد تكونُ اسماً بمعنى (جانِبٍ)، وذلك إذا سُبقت بِمن، كقول الشاعر: فَلَقَدْ أَراني لِلرِّماحِ دَريئَةً مِنْ عَنْ يَميني تارَةً وِشمالي وقول الآخر: وَقُلْتُ: اجعَلي ضَوْءَ الفَراقِدِ كُلِّها يَميناً. وَمَهْوى النَّجْمِ مِنْ عَنْ شِمالِكِ 6- عَلَى على: لها ثمانيةُ مَعانٍ: أ- الاستعلاءُ، حقيقةً كان، كقولهِ تعالى: {وعليها وعلى الفُلكِ تُحمَلونَ}، أو مجازاً، كقولهِ: {وفَضّلناهم بعضَهم على بعض}، ونحو: (لفلانٍ عليَّ دَينٌ). والاستعلاءُ أصلُ معناها. ب- معنى: (في)، كقوله تعالى: (ودخلَ المدينةَ على حين غَفلةٍ من أهلها) أي: في حين غفلة. ج ـ معنى (عن) كقول الشاعر: إذا رَضِيَتْ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ لَعَمْرُ اللهِ أَعْجَبَني رِضَاها أي: إذا رضِيت عني. د- معنى اللام، التي للتعليل، كقوله تعالى: {ولتُكَبّروا اللهَ على ما هداكم}، أي (لهِدايتهِ إيّاكم)، وقولِ الشاعر: عَلامَ تَقولُ: الرُّمْحُ يُثْقِلُ عاتِقي إِذا أَنا لَمْ أَطعنْ، إذا الخَيْلُ كَرَّتِ أي: لِمَ تقول؟ هـ- معنى (مَعَ)، كقولهِ تعالى: {وآتَى المالض على حُبّهِ}، أي: معَ حُبهِ، وقولهِ {وإنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغفرةٍ للناسِ على ظُلمهم}، مع ظُلمهم. و- معنى (من)، كقولهِ سبحانَهُ: {إذا اكتالوا على الناسِ يَستَوفونَ} أي: اكتالوا منهم. ز- معنى الباءِ، كقولهِ تعالى: {حَقيقٌ عليَّ أن لا أقولَ إلاّ الحق}، أي: حقيقٌ بي، ونحو: (رمَيتُ على القوس)، أي: رميتُ مستعيناً بها، ونحو: (اركبْ على اسمِ الله)، أي: مستعيناً به. ح- الاستدراكُ، كقولكَ: (فلانٌ لا يدخلُ الجنةَ لِسوءِ صنيعهِ، على أنهُ لا يَيأسُ من رحمة اللهِ)، أي: لكنَّهُ لا ييأسُ. ومنه قولُ الشاعر: بِكُلِّ تَداوَينا. فَلَمْ يَشْفِ ما بِنا عَلى أَنَّ قُرْبَ الدَّارِ خَيْرٌ مِنَ الْبُعْدِ عَلى أَنَّ قُرْبَ الدَّارِ لَيْسَ بِنافعٍ إِذا كانَ مَنْ تَهْواهُ لَيْسَ بِذي وُدِّ وقولُ الآخر: فَوَاللهِ لا أَنسى قَتيلاً رُزِئتُهُ بِجانِبِ قَوْسى ما بَقيتُ عَلى الأَرضِ عَلى أنَّها تَعْفو الْكُلومُ، وإِنَّما نُوَكَّلُ بالأَدنى، وَإِنْ جَلَّ ما يَمْضِي وإذا كانت للاستدراك، كانت كحرف الجر الشبيهِ بالزائد، غيرَ متعلقة بشيءٍ، على ما جنحَ إليه بعضُ المحقّقينَ. واعلم أنَّ (على) قد تكونُ اسماً للاستعلاء بمعنى (فَوْق)، وذلك إذا سُبِقتْ بِمِنْ كقوله: (غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ بَعْدَ ما تَمَّ ظِمْؤُها) أي من فوقه، وتقولُ: (سقطَ من على الجبل). |
7- في
في: لها سبعةُ مَعانٍ: أ- الظرفيّةُ، حقيقيّةً كانت، نحو: (الماءُ في الكوز. سرتُ في النّهار). وقد اجتمعت الظرفيّتانِ: الزمانيّة والمكانيّةُ في قولهِ تعالى: {غُلبتِ الرُّومُ في أَدنى الأرض. وهم مِن بَعْدِ غَلَبِهمَ سَيَغلِبونَ في بِضعِ سنينَ}، أَو مجازيَّةً، كقوله سبحانه: {ولَكُم في رسول اللهِ أُسوةٌ حسنةٌ}، وقولهِ: {ولَكُم في القصاصِ حياةٌ}. ب- السببيّة: والتّعليلُ، كقولهِ تعالى: {لَمَسّكم فيما أَفضتُم فيه عذابٌ عظيم} أي: بسبب ما أَفضتم فيه. ومنه الحديثُ: (دخلتِ امرأَةٌ النارَ في هِرَّةٍ حَبَستها) أي: بسبب هِرَّةٍ. ج- معنى (معَ) كقولهِ تعالى: {قال: ادخلوا في أمَمٍ قد خَلَت من قبلكم} أي: مَعَهم. د- الاستعلاءُ - بمعنى: (عَلى) - كقولهِ تعالى: {لأصلبنّكُم في جُذوعِ النّخلِ}، أي: عليها. هـ- المُقايَسةُ - وهيَ الواقعةُ بينَ مفضولٍ سابقٍ وفاضلٍ لاحقٍ، كقولهِ تعالى: {فما مَتاعُ الدنيا في الآخرةِ إلا قليلٌ}، أي: بالقياس على الآخرة والنسبة إليها. و- معنى الباءِ، التي للالصاقِ، كقول الشاعر: ويَرْكَبُ يَوْمَ الرَّوْعِ مِنَّا فَوارِسٌ بَصيرُونَ في طَعْنِ الأَباهِرِ والْكُلى أي: بصيرونَ بطعنِ الأباهر. [الأباهر: جمع أبهر: وهو عِرق إذا انقطع مات صاحبه. وهما أبهران يخرجان من القلب ثم يتشعب منهما سائر الشرايين. والكلى: جمع كلية. فإن كتبتها بالألف فهي جمع كلوة وكلاهما واحد] ز- معنى (إلى) كقولهِ تعالى: {فَرَدُّوا أيديَهم في أفواههم}. 8- الكاف الكافُ: لها أَربعةُ معانٍ: أ- التشبيهُ، وهو الأصلُ فيها، نحو: (عليٌّ كالأسد). ب- التّعليلُ، كقوله تعالى: {واذكرُوهُ كما هداكم}، أَي: لهدايتهِ إيّاكم. وجعلوا منه قوله تعالى: {وَيْ كأنّهُ لا يُفلحُ الكافرون!}. أَي: أعجبُ أَو تَعجّبْ لعَدم فلاحهم. فالكافُ: حرف جر بمعنى اللام، وأنَّ: هي الناصبةُ الرافعة. ج- معنى (على) نحو: (كُنْ كما أَنتَ)، أَي: كُن ثابتاً على ما أنت عليه. د- التّوكيدُ - وهي الزائدةُ في الإعراب - كقولهِ تعالى: {ليس كمِثلهِ شيءٌ}، أي: ليس مِثلهُ شيءٌ، وقولِ الرَّاجز يَصفُ خيلاً ضوامرَ: (لَواحِقُ الأقرابِ، فيها كالمقَق). [الأقراب: الخواصر. مفردها قُرُبْ بضمتين فسكون. والمقق بفتح الميم والقاف: الطول الفاحش مع رقة] واعلم أَنَّ الكاف قد تأتي اسماً بمعنى (مِثلٍ)، كقول الشاعر: أَتَنتَهونَ؟ وَلَنْ يَنْهى ذّوي شَطَطٍ كَالطَّعْنِ يَذْهَبُ فيهِ الزَّيتُ والفُتُلُ وقول الراجز: (يّضْحَكْنَ عَنْ أسنان كَالبَرَدِ المُنْهَمِّ) ومنهُ قول المُتنبي: وَما قَتَلَ الأَحرارَ كَالْعَفْوِ عَيْنُهمْ ومَنْ لَكَ بالحُرِّ الَّذِي يَحْفَظُ الْيَدا |
9- اللاَّم
اللامُ: لها خمسةَ عشرَ معنى: أ- الملِكُ - وهي الداخلة بين ذاتينِ، ومصحوبُها يَملِكُ - كقوله تعالى: {للهِ ما في السَّمواتِ والأرضِ}، ونحو: (الدارُ لسعيدٍ). ب- الاختصاصُ، وتُسمَّى: لامَ الاختصاصِ، ولامَ الاستحقاقِ - وهي الداخلة بين معنًى وذات - نحو: (الحمدُ للهِ) والنجاحُ للعاملين, ومنه قولهم: (الفصاحةُ لِقُرَيشٍ، والصبّاحةُ لِبَني هاشمٍ). ج- شِبهُ المِلك. وتُسمّى: لامَ النسبة - وهي الدَّاخلة بينَ ذاتينِ، ومصحوبُها لا يملِكُ - نحو: (اللجامُ للفرَس). د- التّبيينُ، وتُسمّى: (اللاّمَ المُبيّنة)، لأنها تُبيِّنُ (أن مصحوبَها مفعولٌ لما قبلَها)، من فعل تعَجُّبٍ أو اسمِ تفضيل، نحو: (خالدٌ أحب لي من سعيدٍ. ما أحبّني للعلم!. ما أحملَ عليّاً للمصائب!). فما بعدَ اللام هو المفعول به. وإنما تقول: (خالدٌ أحب لي من سعيد)، إذا كان هو المُحبَّ وأنت المحبوب. فإذا أردت العكسَ قلت: (خالدٌ أحبُّ إليَّ من سعيد)، كما قال تعالى: {ربِّ السجنُ أحبُّ إليَّ} وقد سبقَ هذا في (إلى). هـ- التّعليلُ والسببيَّةُ، كقوله تعالى: {إنَّا أنزلنا إليكَ الكتابَ بالحقِّ لتحكُمَ بينَ الناسِ بما أراكَ الله}، وقولِ الشاعر: وإِنِّي لَتَعْروني لِذِكْراكِ هزَّةٌ كما انْتَفَضَ الْعُصْفورُ بَلَّلَهُ القَطْرُ ومنهُ اللامُ الثانيةُ في قولكَ: (يالَلنَّاسِ لِلمظلوم!). و- التوكيدُ - وهي الزائدة في الإعراب لمُجرَّد توكيد الكلام - كقول الشاعر: وَمَلَكْتَ ما بَيْنَ الْعِراقِ ويَثْرِبٍ مُلْكاً أَجارَ لُمسْلِمٍ ومُعاهِدِ ونحو: (يا بُؤسَ لِلحرب!). ومنهُ لامُ المُستغاث، نحو: (يا لَلفضيلة!) ويه لا تَتعلَّق بشيءٍ، لأنَّ زيادتها لمجرَّد التوكيد. ز- التّقويةُ - وهيَ التي يُجاءُ بها زائدةً لتقويةِ عاملٍ ضَعُف بالتأخيرِ، بكونه غيرَ فعلٍ. فالأول كقولهِ تعالى: {الذينَ هم لربهم يَرهبُون} وقوله: {إن كنتم للرُّؤْيا تَعبُرونَ}. والثاني كقوله سبحانه: {مُصَدِّقاً لِما مَعَهمْ} وقولهِ: {فعّالٌ لِما يُريدُ}. وهي - معَ كونها زائدةً - مُتعلّقةٌ بالعامل الذي قوَّتهُ، لأنها - مع زيادتها - أفادته التَّقوية، فليست زائدةً مَحضة. وقيل: هي كالزائدة المحضة، فلا تتعلَّق بشيء. ح- انتهاءُ الغاية - أي: معنى (إلى) - كقوله سبحانه: {كلٌّ يجري لأجل مُسمًّى}، أي: إليه، وقولهِ: {ولو رُدُّوا لعادوا لِما نُهُوا عنه}، وقولهِ: {بأنّ ربكَ أوحى لها}. ط- الاستغاثةُ: وتُستعمَلُ مفتوحةً معَ المستغاث، ومكسورةً معَ المُستغاثِ لهُ، نحو: (يا لَخالِدٍ لِبَكر!). ي- التعجبُ: وتُستعملُ مفتوحةً بعد (يا) في نداءِ المُتعجَّب منه، نحو: (يا لَلفرَحِ!)، ومنهُ قول الشاعر: فَيا لَكَ مِنْ لَيْلٍ! كأنَّ نُجُومَهُ بِكُلِّ مُغارِ الْفَتْل شُدَّتْ بِيَذْبُلِ وتُستعملُ في غير النداءِ مكسورةٌ، نحو: (للهِ دَرُّهُ رجلاً!)، ونحو: (للهِ ما يفعلُ الجهلُ بالأممِ!) ك- الصّيرورةُ (وتُسمَّى لامَ العاقبةِ ولامَ المآلِ أيضاً) وهي التي تدلُّ على أنَّ ما بعدَها يكونُ عاقبةً لِمَا قبلها ونتيجةً له، عِلةَّةً في حصوله. وتخالفُ لامَ التَّعليل في أنّ ما قبلها لم يكن لأجل ما بعدها، ومنه قوله تعالى: {فالتقطهُ آلُ فِرعونَ ليكونَ لهم عدواً وحَزَناً}، فَهُم لم يلتقطوهُ لذلك، وإنما التقطوهُ فكانتِ العاقبةُ ذلك. قال الشاعر: لِدُوا لِلْمَوْتِ، وَابنُوا لِلْخرابِ فَكُلُّكُمء يَصيرُ إِلى الذَّهابِ فالإنسان لا يَلِدُ للموت، ولا يبني للخراب، وإنما تكونُ العاقبةُ كذلك. ل- الاستعلاءُ - أي: معنى (على) - إما حقيقةً كقوله تعالى: {يَخِرُّونَ للأذقانِ سُجَّداً}، وقولِ الشاعر: ضَمَمْتُ إِليهِ بالسِّنانِ قميصَهُ فَخَرَّ صَريعاً لِلْيَدَيْنِ ولِلفَم وإمّا مجازاً كقوله تعالى: {إن أسأتُم فَلَها}، أي: فعليها إساءتُها، كما قال في آية أخرى: {وإن أسأتُم فعليها}. م- الوقتُ (وتُسمَّى: لامَ الوقت ولامَ التاريخ) نحو: (هذا الغلامُ لِسنةٍ)، أي: مرَّت عليه سَنةٌ. وهي عندَ الإطلاق تدلُّ على الوقت الحاضر، نحو : (كتبتُهُ لِغُرَّةِ شهر كذا)، أي: عند غُرّتِهِ، أو في غُرَّتهِ. وعندَ القرينة تدلُّ على المُضيِّ أو الاستقبال، فتكونُ بمعنى ( قبَلٍ) أو (بَعدٍ)، فالأولُ كقولك: (كتبتُهُ لستٍّ بَقينَ من شهر كذا)، أي قبلها، والثاني كقولك: (كتبتُهُ لخمسٍ خَلَوْن من شهر كذا)، أي: بعدها. ومنهُ قولهُ تعالى: {أقمِ الصّلاةَ لِدلوكِ الشمس}، أي: بعدَ دلُوكها. ومنه حديثُ: (صُوموا لِرُؤيتهِ وأفطِروا لِرؤيته)، أي: بعد رؤيته. ن- معنى (معَ)، كقول الشاعر: فَلَمَّا تَفَرَّقْنا كأَنِّي ومالِكاً - لِطولِ اجتماعٍ - لم نَبِتْ ليْلَةً مَعا س- معنى )في(، كقوله تعالى: {ويَضَعُ الموازينَ القسطَ ليومِ القِيامة}، أي: فيها، وقولهِ: {لا يُجلّيها لوقتها إلاّ هُو}، أي: في وقتها. ومنه قولهم: )مضى لسبيله(، أي: في سبيلهِ. |
10 و 11- الواوُ والتَّاءُ
والواوُ والتاءُ: تكونان للقسم، كقوله تعالى: {والفجرِ وليالٍ عَشرٍ}، وقولهِ {تاللهِ لأكيدَنَّ أصنامَكم}. والتاءُ لا تدخُلُ إلا على لفظ الجلالة. والواوُ تدخلُ على كل مقسم به. 12 و 13- مُذ ومُنْذُ مُذْ ومُنذُ: تكونان حرفيْ جَرّ بمعنى (منْ)، لابتداءِ الغاية، إن كان الزمانُ ماضياً، نحو: (ما رأيتكَ مُذْ أو منذُ يومِ الجمعة)، وبمعنى (في)، التي للظرفيّة، إن كان الزمان حاضراً، نحو: (ما رأيتهُ مُنذُ يومنا أو شهرِنا) أي: فيهما. وحينئذٍ تُفيدان استغراقَ المدَّة، وبمعنى (من وإلى) معاً، إذا كان مجرورهما نكرةً معدودةً لفظاً أو معنى. فالأول نحو: (ما رأيتكَ مُذ ثلاثةِ أيام)، أي: من بَدئها إلى نهايتها. والثاني نحو: (ما رأيتكَ مذ أمدٍ، أو مُنذُ دَهرٍ). فالأمدُ والدهرُ كِلاهما مُتعدِّدٌ معنًى، لأنه يقالْ لكل جزءٍ منها أمدٌ ودهرٌ. لهذا لا يقالُ: (ما رأيتُهُ مُنذ يومٍ أو شهرٍ)، بمعنى: ما رأيتهُ من بدئهما إلى نهايتهما، لأنهما نكرتانِ غيرَ معدودتينِ، لأنهُ لا يقالُ الجزءِ اليومِ يومٌ، ولا لجزءِ الشهر شهرٌ. واعلم أَنهُ يشترطُ في مجرورهما أن يكون ماضياً أو حاضراً، كما رأيتَ. ويشترطُ في الفعل قبلَهما أن يكون ماضياً منفيّاً، فلا يقالُ: (رأيتهُ منذُ يومِ الخميس)، أَو ماضياً فيه معنى التَّطاوُلِ والامتدادِ، نحو: (سِرتُ مُذْ طلوعِ الشمسِ). وتكونُ (مُذ ومُنذُ) ظرفينِ منصوبينِ مَحلاً، فَيُرفعُ ما بعدَهما. ويُشترَطُ فيهما أَيضاً ما اشتُرطَ فيهما وهما حرفان. وقد سبقَ الكلامُ عليهما في المفعول فيهِ، عندَ الكلامِ على شرحِ الظروف المبنية فراجعهُ. ومُذ: أصلُها (منذُ) فَخُفّفت، بدليل رجوعهم إلى ضم الذَّال عند ملاقاتها ساكناً، نحو: (انتظرتكَ مذُ الصباح). ومُنذُ: أصلُها (من) الجارَّةُ و (إذ) الظرفيّة، فَجُعلتا كلمةً واحدةً. ولذا كسرت مِيمُها - في بعض اللُّغات - باعتبار الأصل. 14- رُبَّ رُبَّ: تكونُ للتّقليلِ وللتّكثير، والقرينةُ هي التي تُعيّنُ المرادَ. فمن التقليل قولُ الشاعر: أَلا رُبَّ مَوْلودٍ، وَلَيْسَ لَهُ أَبٌ وذي وَلَدٍ لَمْ يَلْدَهُ أَبَوانٍ يُريدُ بالأول عيسى، وبالثاني آدمَ، عليهما السلامُ. ومن التكثيرِ حديثُ: (يا رُب كاسِيةٍ في الدنيا عاريةٌ يومَ القيامةِ)، وقولُ بعضِ العرب عند انقضاءِ رَمضانَ: (يا رُبَّ صائمهِ لن يَصومَهُ: ويا رُبَّ قائمهِ لن يَقومهُ). واعلم أنهُ يُقالُ: (رُبَّ ورُبَّةَ ورُبّما ورُبَّتما). والتاءُ زائدة لتأنيث الكلمة، و (ما) زائدةٌ للتوكيد. وهي كافةٌ لها عن العمل. وقد تُخَفّفُ الباءُ. ومنه قوله تعالى: {رُبَما يَودُّ الذين كفروا لو كانوا مُسلمينَ}. ولا تَجُرُّ (رُبَّ) إلا النكرات، فلا تُباشِرُ المعارفَ. وأمّا قولهُ: (يا رُبَّ صائمهِ، ويا رُبَّ قائمهِ) المتقدَّمُ، فإضافة صائم وقائم إلى الضمير لم تُفدهما التعريفَ، لأنَّ إضافةَ الوصف إلى معمولهِ غير محضةٍ، فهي لا تُفيدُ تعريفَ المضاف ولا تخصيصَهُ، لأنها على نيّة الانفصال، ألا ترى أنك تقول: (يا رُبَّ صائم فيه، ويا ربَّ قائم فيه). والأكثر أن تكون هذه النكرة موصوفة بمفردٍ أو جملة. فالأول نحو: (رُبَّ رجلٍ كريمٍ لقيته). والثاني نحو: (رُبَّ رجلٍ يفعل الخيرَ أكرمته). وقد تكونُ غيرَ موصوفة، نحو: (رُبَّ كريم جبانٌ). وقد تُجُرُّ ضميراً مُنكَّراً مُميّزاً بنكرةٍ. ولا يكونُ هذا الضميرُ إلا مُفرداً مُذَكَّراً. أما مُميّزُهُ فيكونُ على حسب مُراد المتكلم: مفرداً أو مُثَنَّى أو جمعاً أو مذكراً أو مؤنثاً، تقول: (رُبّهُ رجلاً. رُبّهُ رَجلَينِ. رُبّهُ رجالاً. رُبّهُ امرأةً. رُبَّهُ امرأتينِ. رُبّهُ نساءً). قال الشاعر: رُبَّهُ فِتَيَةً دَعَوْتُ إلى ما يُورِثُ الْحَمَدَ دائباً، فأَجابُوا وسيأتي الكلامُ على محل مجرور (رُبَّ) من الإعراب، في الكلام على موضع المجرور بحرف الجر. 15 و 16 و 17- خَلاَ وَعَدا وحَاشا خَلا وعدا وحاشا: تكون أَحرف جرٍّ للاستثناء، إذا لم يتقدَّمهنَّ (ما). وقد سبق الكلام عليهنَّ في مبحث الاستثناء فراجعه. 18- كَيْ كي: حرفُ جرَّ للتعليل بمعنى اللام. وإنما تَجُرُّ (ما) الاستفهامية، نحو: (كيْمَهْ؟)، نقولُ: (كيمَ فعلتَ هذا؟)، كما تقولُ: (لمَ فعلته؟). والأكثرُ استعمالُ (لمهْ؟) وتُحذَفُ أَلِفُ (ما) بعدَها كما تُحذَفُ بعدَ كلِّ جارٍّ، نحو: (مِمّهْ وعَلامهْ وإلامَهْ). وإذا وقَفُوا ألحقوا بها هاء السكت، كما رأيتَ. وإذا وصلوا حذفوها، لعدم الحاجة إليها في الوصل. وقد تَجرُّ المصدرَ المؤوّلَ بما المصدرية كقول الشاعر: إِذا أَنتَ لَم تَنْفَعْ فَضُرَّ، فإنَّما يُرادُ الْفَتَى كيْما يَضُرُّ وَيَنْفَعُ (فكي: حرف جر. وما: مصدرية، فما بعدها في تأويل مصدر مجرور بكي. أي: يراد الفتى للضر والنفع. ويجوز أن تكون (كي) هنا هي المصدرية الناصبة للمضارع. فما. بعدها. زائدة كافةٌ لها عن العمل). 19- مَتَى مَتى: تكونُ حرفَ جرٍّ - بمعنى: (مِنْ) - في لُغةِ "هُذَيلٍ"، ومنهُ قولهُ: شَرِبْنَ بِماءٍ البَحْرِ، ثُمَّ تَرَفَّعْتْ مَتَى لُجَج خُضْرٍ لَهُنَّ نَئيجُ 20- لعَلَّ لَعَلَّ: تكونُ حرفَ جرٍّ في لغة (عُقَيلٍ) وهي مبنيّةٌ على الفتح أو الكسر، قال الشاعر: فَقُلْتُ ادْعُ أُخرَى وارفَعِ الصَّوْتَ جَهْرَةً لَعَلَّ أَبي المِغْوارِ منْكَ قَريبُ وقد يُقال فيها (عَلّ) بحذف لامِها الأولى. وهي حرفُ جرّ شبيهٌ بالزائد، فلا تتعلَّقُ بشيءٍ. ومجرورها في موضع رفعٍ على أَنه مبتدأ. خبرهُ ما بعدَه. وهي عندَ غير (عُقَيل)ناصبةٌ للاسم رافعةٌ للخبر، كما تقدَّم. |
2- مَا الزَّائدَةُ بعْدَ الجارِّ
قد تُزادُ (ما) بعدَ (من وعن والباء)، فلا تَكفُّهنَّ عن العمل، كقوله تعالى: {مِمّا خَطيئاتهم أُغرِقوا}، وقولهِ: {عَمّا قَليلٍ ليُصبحنَّ نادمينَ}، وقولهِ: {فَبما رَحمةٍ من الله لِنتَ لَهُم}. وقد تُزادُ بعدَ (رُبَّ والكافِ) فيبقى ما بعدَهما مجروراً، وذلك قليلٌ، كقول الشاعر: رُبَّما ضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ صَقيلٍ بَيْنَ بُصْرى وَطَعْنَةٍ نَجْلاءُ وقولِ غيره: وَنَنْصُرُ مَوْلانا، ونَعْلَمُ أَنَّهُ كمَا النَّاسِ، مَجْرومٌ عَلَيْهِ وجارِمُ وإنما وجبَ أَن تكونا هنا عاملتينِ، غيرَ مكفوفتينِ، لأنهما لم تُباشِرا الجملة، وإنما باشرتا الاسم. والاكثرُ أن تُكُفّهما (ما) عن العملِ، فيدخلانش حينئذٍ على الجُمَلِ الاسميّة والفعليّة كقول الشاعر: أَخٌ ماجِدٌ لَمْ يُخْزِني يَومَ مَشْهَدٍ كمَا سَيْفُ عَمْرٍ ولَمْ تَخُنْهُ مَضارِبُهْ وقولِ الآخر: رُبَّما أَوْفَيتُ في عَلَمٍ تَرْفَعَنْ ثَوْبي شَمَالاتُ والغالب على (رُبَّ) المكفوفةِ أَن تدخلَ على فعلٍ ماضٍ، كهذا البيت. وقد تدخلُ على فعلٍ مضارع، بشرط أن يكونَ مُتَحققَ الوقوع، فيُنزّلُ منزلة الماضي للقطع بحصولهِ، كقولهِ تعالى: {رُبَما يَودُّ الذينَ كفروا لو كانوا مُسلمينَ}. ونَدَرَ دخولها على الجملة الاسميّة، كقول الشاعر: رُبَّما الْجَامِلُ المُؤَبَّلُ فيهِمْ وعَناجيجُ بَيْنَهُنَّ المِهارُ 3- واوُ رُبَّ وفاؤُها قد تُحذَف (ربَّ)، ويبقى عملُها بعد الواو كثيراً، وبعد الفاء قليلاً، كقول الشاعر: وَلَيْلٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، أَرْخى سُدُولَهُ عَلَيَّ. بِأَنْواعِ الهُمومِ، لِيَبتَلي وقولهِ: فَمِثْلِكِ حُبْلى قَدْ طَرَقْتُ وَمُرْضِعٍ فَألْهيْتُها عَنْ ذي تَمائِمَ مُحْوِلِ 4- حَذْفُ حَرْفِ الجَرِّ قِياساً يُحذَفُ حرفُ الجَرِّ قِياساً في ستَّة مواضع: أ- قبلَ أنْ، كقوله تعالى: {وعَجِبوا أن جاءَهم مُنذرٌ منهم}، أي: لأنْ جاءهم، وقولهِ: {أوَ عَجِبتُمْ أنْ جاءكم ذِكرٌ من ربكم على رجلٍ منكم}، وقولِ الشاعر: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّا لا نُحِبُّكُمُ وَلا نَلومُكُمُ أَن لا تُحِبُّونا أي: على أن لا تُحبُّونا. ب- قبلَ أنَّ، كقولهِ تعالى: {شهِدَ اللهُ أنهُ لا إِله إلا هو}، أي: شَهِدَ بأنهُ. واعلم أنهُ إنما يجوزُ حذفُ الجارِّ قبلَ (أن وأنَّ)، إن يُؤمَنِ اللَّبسُ بحذفهِ. فإن لم يُؤمَن لم يَجز حذفهُ، فلا يقالُ: (رغِبتُ أن أفعلَ)، لإشكالِ المراد بعدَ الحذفِ، فلا يَفهمُ السامعُ ماذا أردتَ: أرَغبَتك في الفعلِ، أم رغبَتَكَ عنه؟ فيجبُ ذكرُ الحرف ليتعيَّن المرادُ، إلا إذا كان الإبهامُ مقصوداً من السامع. ج- قبلَ (كي) الناصبةِ للمضارع، كقولهِ تعالى: {فرَددناهُ إلى أمهِ كي تَقرَّ عينُها}، أي: لكي تَقرَّ. واعلم أن المصدرَ المؤوَّل بعد (أنْ وأنَّ وكيْ) في موضع جرَّ بالحرف المحذوف، على الأصحَّ. وقال بعض العلماءِ: هو في موضعِ النصب بنزعِ الخافض. د- قبلَ لفظِ الجلالة في القسم، نحو: (اللهِ لأخدمنَّ الأمةَ خدمةً صادقةً)، أي: والله. هـ- قبلَ مُميّز (كم) الاستفهامية، إذا دخل عليها حرفُ الجرِّ، نحو: (بكم درهم اشتريتَ هذا الكتابَ؟) أي: بكم من درهم؟ والفصيحُ نصبُهُ، كما تقدَّم في باب التمييز، نحو: (بكم درهماً اشتريته؟). و- بعدَ كلامٍ مُشتملٍ على حرف جرّ مثله، وذلك في خمس صُوَر: الأولى: بعد جوابِ استفهامٍ، تقول: (مِمَّنْ أخذتَ الكتاب؟)، فيقالُ لك: (خالدٍ)، أي: من خالد. الثانية: بعد همزةِ الاستفهام، تقولُ: (مررتُ بخالدٍ)، فيقالُ: (أخالدِ ابنِ سعيدٍ؟) أي: أبخالدِ بنِ سعيد؟. الثالثة: بعدَ (إن) الشرطّيةِ، تقولُ: (إذهبْ بِمنْ شئتَ، إنْ خليلٍ، وإنْ حسَنٍ) أي: إن بخليلٍ، وإن بحسنٍ. الرابعةُ: بعدَ (هَلاَ)، تقولُ: (تصدَّقتُ بدرهمٍ)، فيقالُ: (هَلاّ دينار)، أي: هلاّ تَصدَّقتَ بدينار. الخامسة: بعد حرف عطفٍ مَتْلُوٍّ بما يصحُّ أن يكونَ جملةً، لو ذُكرَ الحرفُ المحذوفُ، كقولك: (لخالدٍ دارٌ، وسعيدٍ بُستانٌ)، أي: ولسعيد بستانٌ، وقولِ الشاعر: ما لِمحُبٍّ جَلَدٍ أَنْ يَهْجُرا وَلا حَبيبٍ رَأْفةٌ فَيَجْبُرَا وقولِ الآخر: *أَخْلِقْ بِذي الصَّبْرِ أَنْ يَحْظى بِحاجتِهِ ومُدْمِنِ الْقَرْعِ لِلأَبوابِ أَنْ يَلِجا أي: وبِمُدمنِ القرع. ومنهُ قولهُ تعالى: {وفي خَلقكم وما يَبُثُّ من دآبَّةٍ آياتٌ لقومٍ يُوقنونَ، واختلافِ الليلِ والنهار وما أنزلَ اللهُ من السماءِ من رزقٍ، فأحيا به الأرضَ بعد موتها، وتصريفِ الرِّياح، آياتٌ لقومٍ يعقلون}. |
5- حَذْفُ حَرْفِ الجَرِّ سَمَاعاً
قد يُحذَف الجَرِّ سَمَاعاً، فينتصبُ المجرورُ بعدَ حذفهِ تشبيهاً لهُ بالمفعول به. ويُسمى أيضاً المنصوب على نزعِ الخافض، أي: الاسمَ الذي نُصبَ بسبب حذفِ حرفِ الجرِّ، كقولهِ تعالى: {ألا إنَّ ثمودَ كفروا ربَّهم}، أي: بربهم، وقولهِ: {واختارَ موسى قومَهُ أربعينَ رجلاً} أي: من قومه، وقولِ الشاعر: تَمُرُّونَ الدِّيارَ وَلَمْ تَعُوجُوا كَلامُكُمُ عَلَيَّ إذاً حَرامُ أي: تَمُرُّونَ بالديار، وقولِ الآخر: أَمَرْتُكَ الخَيْرَ: فافْعَلْ مَا أُمرْتَ بهِ فَقَدْ تَرْكْتُكَ ذا مَالٍ وَذا نَشَبِ أي: أمرتُك بالخير، وقولِ غيرهِ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ ذَنباً لَسْتُ مُحْصِيَهُ رَبَّ الْعِبادِ، إِلَيهِ الْوَجْهُ والعَمَلُ أي: أستغفرُ اللهَ من ذنب. ويُسمّى هذا الصنيعُ بالحذف والإيصال، أي: حذفِ الجارَّ وإيصالِ الفعل الى المفعول بنفسهِ بلا واسطة. وقال قومٌ: إنهُ قياسي. والجمهورُ على انهُ سماعيٌّ. ونَدَرَ بقاءُ الاسمِ مجروراً بعد حذف الجارِّ، في غير مواضع حذفهِ قياساً. ومن ذلك قولُ بعضِ العربِ، وقد سُئلَ: (كيف أصبحتَ؟) فقال: (خيرٍ، إن شاءَ اللهُ)، أي: (على خير)، وقولُ الشاعر: إذا قيلَ: أَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَبيلَةً أَشارَتْ كُلَيْبٍ بالأَكُفِّ الأَصابِعُ أي: إلى كليب. ومثلُ هذا شُذوذٌ لا يُلتفتُ إليه. 6- أَقسامُ حَرفِ الجَرِّ حرفُ الجرَّ على ثلاثة أقسام: أصليٍّ وزائدٍ وشبيه بالزائد. فالأصليُّ: ما يحتاجُ الى مُتعلَّق. وهو لا يُستغنى عنه معنًى ولا إعراباً، نحو: (كتبتُ بالقلم). والزائدُ: ما يُستغنى عنه إعراباً، ولا يحتاجُ إلى مُتعلّق. ولا يُستغنى عنه معنًى، لأنهُ إنما جيءَ به لتوكيد مضمونِ الكلام، نحو: (ما جاءَنا من أحدٍ) ونحو: (ليسَ سعيدٌ بمسافرٍ). والشِّبيهُ بالزائدِ: ما لا يُمكن الاستغناءُ عنهُ لفظاً ولا معنى، غيرَ أنهُ لا يحتاجُ إلى مُتعلّق. وهو خمسةُ أحرفٍ: (رُبَّ وخَلاَ وعدا وحاشا ولَعَلَّ). (وسمي شبيهاً بالزائد لأنه لا يحتاج إلى متعلّق. وهو أيضاً شبيهٌ بالأصلي من حيث أنه لا يستغنى عنه لفظاً ولا معنى. والقول بالزائد هو من باب الاكتفاء، على حد قوله تعالى: {سرابيل تقيكم الحرّ}، أي: وتقيكم البرد أيضاً). |
7- مَواضِعُ زِيادَةِ الجارِّ
لا يُزادُ من حروفِ الجرّ إلا (من والباءُ والكافُ واللام). وزيادتها إنما هي في الإعراب، وليستْ في المعنى، لأنها إنما يُؤتى بها للتَّوكيدِ. أمّا الكافُ، فزيادتها قليلةٌ جداً. وقد سُمعت زيادتها في خبر (ليس)، كقوله تعالى: {ليسَ كمثلهِ شيءٌ}، أي: (ليس مثلَه شيءٌ)، وفي المبتدأ، كقول الراجل: (لَواحِق الأقرابِ فيها كالمَقَقْ). وزيادتها سماعيّة. [الأقراب: الخواصر. مفردها قُرُبْ بضمتين فسكون. والمقق بفتح الميم والقاف: الطول الفاحش مع رقة، وهو يصف خيلاً] وأمّا اللامُ فتُزادُ سماعاً بينَ الفعل ومفعوله. وزيادتها في ذلك رديئةٌ. قال الشاعر: وَمَلَكْتَ ما بَيْنَ الْعِراقِ ويَثْرِبٍ مُلْكاً أَجارَ لِمُسْلِمٍ وَمُعاهِدِ أي: أجار مسلماً ومعاهداً. وتُزادُ قياساً في مفعولٍ تأخَّرَ عنه فِعلُهُ تقويةً للفعل المتأخر لضَعفهِ بالتأخُّر، كقولهِ تعالى: {الذينَ هم لربهم يَرهبون}، أي: ربهم يَرهبون، وفي مفعول المشتقِّ من الفعل تقويةً لهُ أيضاً، لأنَّ عملَهُ فَرعٌ عن عملِ فعلهِ المشتقَّ هو منه، كقوله تعالى: {مُصَدِّقاً لِما مَعَهم}، أي: مصدقاً لما معهم، وقولهِ: {فَعَالٌ لما يُريد}، أي: فَعّالٌ ما يريد وقد سبق الكلام عليها. وأمّا (مِن) فلا تُزادُ إلا في الفاعل والمفعول به والمبتدأ، بشرط أن تُسبَقَ بنفيٍ أو نهي أو استفهامٍ بهَلْ، وأن يكون مجرروها نكرةً. وزيادتها فيهنَّ قياسيّةٌ. ولم يشترط الأخفش تَقدُّمَ نفي أو شبههِ، وجعل من ذلك قولهُ تعالى: {ويكفّر عنكم من سيئاتكم}، وقولهُ: {فَكلُوا مِمّا أمسكنَ عليكم}. و (من) في هاتين الآيتين تحتملُ معنى التبعيض أيضاً. وبذلك قال جمهور النُّحاة. وأقوى من هذا الاستشهاد الاستدلالُ بقوله تعالى: {ويُنَزِّلُ من السماء، من جبال فيها، من بَرَدٍ}. فمن في قوله: (من برد) لا ريب في زيادتها، وإن قالوا: إنها تحتمل غيرَ ذلك، لأنَّ المعنى: أن يُنزَّل بَرَداً من جبالٍ في السماءِ. فزيادتها في الفاعل، كقوله تعالى: {ما جاءَنا من بشير}. وزيادتها في المفعول، كقوله: {تَحِسُّ منهم من أحد}. وزيادتها في المبتدأ، كقوله: {هل من خالقٍ غيرُ اللهِ يَرزُقُكم!}. وأما الباءُ فهي أكثر أخواتها زيادةً. وهي تزادُ في الإثباتِ والنفي. وتزاد في خمسةِ مواضعَ: أ- في فاعل (كفى)، كقوله تعالى: {وكفى بالله وليّاً، وكفى بالله نصيراً}. ب- في المفعول به، سماعاً نحو: (أخذتُ بزمامِ الفَرَس)، ومنه قولهُ تعالى: {ولا تُلقوا بأيديكم إلى التّهلُكةِ}، وقولهُ: {وهُزِّي إليكِ بِجِذعِ النَّخلة}، وقوله: {ومَنْ يُرِدْ فيه بإِلحادٍ}، وقولُهُ: {فَطفِقَ مَسحاً بالسُّوقِ والأعناقِ}. ومنهُ زيادتُها في مفعولِ (كفى) المُتعدَّيةِ إلى واحدٍ، كحديثِ: (كفى بالمرءِ إثماً أن يُحدِّثَ بكلِّ ما سَمِعَ). وتُزادُ في مفعولِ (عَرَف وعَلِمَ - التي بمعناها - ودَرَى وجَهِلَ وسَمِعَ وأحسَّ). ومعنى زيادتها في المفعول به سَماعاً أنها لا تُزادُ إلا في مفعول الأفعال التي سُمعت زيادتها في مفاعيلها، فلا يُقاسُ عليها غيرها من الأفعال. وأمّا ما وَرَد، فلك أن تَزيدَ الباءَ في مفعوله في كل تركيب. ج- في المبتدأ، إذا كان لفظَ (حَسْب) نحو: (بِحَسبِكَ درهمٌ)، أو كان بعدَ لفظِ (ناهيكَ)، نحو: (ناهيكَ بخالدٍ شجاعاً)، أو كان بعدَ (إذا الفُجائيّةِ، نحو: خرجتُ فإذا بالأستاذِ)، أو بعدَ (كيفَ)، نحو: (كيفَ بِكَ، أو بخليل، إذا كان كذا وكذا؟). د- في الحال المنفيّ عاملَها. وزيادتها فيها سَماعيّةٌ، كقولِ الشاعر: فَما رَجعَتْ بِخائِبَةٍ رِكابٌ حَكيمُ بْنُ المسيِّبِ مُنْتَهاها وقولِ الآخر: كائِنْ دُعيتُ إلى بَأْساءَ داهِمَةٍ فَما انبَعَثْتُ بِمَزءُودٍ وَلا وَكَلِ [المزءُود: المذعور. (زأده: أخافه وأذعره)، والوَكَل: العاجز الضعيف] وجعلَ بعضهُم زيادَتها فيها مَقيسةً، والذوقُ العربيُّ لا يأبى زيادَتها فيها. هـ- في خبر (ليسَ وما) كثيراً، وزيادتها هنا قياسيّةٌ. فالأولُ كقوله تعالى: {أَليسَ اللهُ بِكافٍ عبدَه}، وقولهِ: {أَليسَ اللهُ بأحكمِ الحاكمين}. والثاني كقوله سبحانهُ: {وما رَبُّكَ بِظلاّمٍ للعبيد}، وقولهِ: {وما اللهُ بغافلٍ عمّا تعملونَ}. وإنما دخلت الباءُ في خبر (إنَّ) في قوله تعالى: {أَوَ لَمْ يَرَوا أنَّ اللهَ الذي خَلَقَ السّمواتِ والأرضَ، ولم يَعيَ بخلقهنَّ، بقادرٍ على أنْ يُحييَ المَوتى، بَلَى، إنهُ على كلِّ شيءٍ قديرٌ}، لأنه في معنى (أَوَلَيسَ) بدليلِ أَنهُ مُصَرحٌ بهِ في قولهِ عز وجلّ: {أَوَ لَيس الذي خلقَ السمواتِ والأرضَ بقادرٍ على أن يَخلُقَ مِثلَهم، بَلَى، وهو الخلاّقُ العليمَ}. |
8- مُتَعَلَّقُ حَرْفِ الجَرِّ الأَصلِيِّ
مُتعلًَّقُ حرفِ الجرِّ الأصليِّ: هو ما كانَ مُرتبطاً به من فعلٍ أو شَبهِهِ أو معناهُ. فالفعلُ نحو: (وقفتُ على المِنبرِ). وشِبهُ الفعلِ، نحو: (أَنا كاتبٌ بالقلم). ومعنى الفعل نحو: (أُفٍّ للكُسالى). وقد يَتعلَّقُ باسمٍ مُؤوَّلٍ بما يُشبهُ الفعلَ، كقولهِ تعالى: {وهو اللهُ في السّموات وفي الأرض}، فحرفُ الجرِّ متعلقٌ بلفظ الجلالة لأنه مُؤوَّلٌ بالمعبود، أي: وهو المعبودُ في السموات وفي الأرض، أو: وهو المُسمّى بهذا الاسم فيهما. ومثلُ ذلك أَن تقولَ: (أَنتَ عبدُ اللهِ في كلِّ مكان) [أي: أنت المعروف والمسمى بهذا الاسم. وحرف الجر متعلق بعبد الله] و (خالدٌ لَيثٌ في كل موقعةٍ). [أي: هو الشجاع في كل موقعة. فحرف الجر متعلق بليث] ومن ذلك قول الشاعر: وَإن لِساني شُهْدَةٌ يُشْفى بِها وَهُوَّ عَلى مَنْ صَبَّهُ اللهُ عَلْقَمُ [الشُهدة، بضم الشين: العسل في شهده. وهوّ، بفتح الواو مشددة وهي لغة همدان] فحرفُ الجرّ: (على) متعلق بعلقم، لأنه بمعنى (مُرّ)، وأراد به أَنه صعب أو شديد، وقولُ الآخر: ما أُمُّكَ اجتاحَت الْمَنايا كَلُّ فُؤَادٍ عَلَيْكَ أُمُّ [ اجتاحت: أهلكت] فحرف الجر متعلق بأم، لأنها بمعنى (مُشفِق). وقد يَتعلقُ بما يُشيرُ إلى معنى الفعلِ، كأداةِ النفي، كقوله تعالى: {ما أَنتَ بنعمةِ ربكَ بمجنونٍ}. فحرفُ الجر في (بنعمة) مُتعلقٌ بما، لأنهُ بمعنى (انتفى). وقد يُحذَفُ المتعلَّقُ. وذلك على ضربين: جائزٍ وواجبٍ. فالجائزُ أَن يكون كوناً خاصاً، بشرطِ أن لا يضيعَ الفهم بحذفه، نحو: (بالله)، جواباً لمن قال لك: (بِمَن تَستعينُ؟). والواجبُ أَن يكون كوناً عاماً، نحو: (العلمُ في الصُّدورِ. الكتابُ لخليلْ, نظرتُ نورَ القمر في الماءِ. مررت برجلٍ في الطريق). 9- محَلُّ الْمَجُرورِ مِنَ الإِعرابِ حكمُ المجرور بحرف جرّ زائدٍ أَنهُ مرفوعُ المحلِّ أَو منصوبهُ، حَسبَ ما يَطلبهُ العاملُ قبلهُ. (فيكون مرفوع الموضع على أنه فاعل في نحو: (ما جاءنا من أحد). والأصل: ما جاءنا أحدٌ. وعلى أنه نائب فاعل في نحو: (ما قيل من شيء). والأصل: ما قيل شيءٌ. وعلى أنه مبتدأ في نحو: (بحسبك الله)؛ والأصل: حسبُك الله. ويكون منصوب الموضع على أنه مفعول به في نحو: (ما رأيت من أحد)، والأصل: ما سعى سعياً يُحمد عليه. وعلى أنه خَبر (ليس) في نحو: {أليس الله بأحكم الحاكمين}. والأصل: أليس الله أحكم الحاكمين). أمَّا المجرورُ بحرفِ جرٍّ شبيهٍ بالزائد، فإن كان الجارُّ (خَلا وعَدا وحاشا)، فهو منصوب محلاً على الاستثناءِ. وإن كان الجارُّ (ربَّ) فهوَ مرفوعٌ محلاً على الابتداءِ، نحو: (رُبَّ غَنيٍّ اليومَ فقيرٌ غداً. رُبَّ رجلٍ كريمٍ أكرمتُهُ). إلاّ إذا كان بعدها فعلٌ مُتعدٍّ لم يَأخذ مفعولهُ، فهو منصوبٌ محلاًّ على أَنهُ مفعولٌ به للفعل بعدَهُ، نحو: (ربَّ رجلٍ كريمٍ أَكرمتُ). فإن كان بعدَها فعلٌ لازم، أَو فعلٌ متعدّ ناصبٌ للضمير العائدِ على مجرورها فهو مبتدأ، والجملةُ بعدَهُ خبرهُ، نحو: (رُبَّ عاملٍ مجتهدٍ نَجَحَ. ربَّ تلميذٍ مجتهدٍ أكرمتُهُ). وأمّا المجرورُ بحرفِ جَرّ أصليّ فهو مرفوعٌ محلاًّ، إن ناب عن الفاعل بعد حذفهِ، نحو: (يؤخذُ بِيَدِ العاثرِ. جيءَ بالمُجرم الفارِّ) أو كان في موضع خبرِ المبتدأ، أو خبرِ (إنَّ) أو إحدى أخواتها، أَو خبر (لا) النافية للجنسِ، نحو: (العلمُ كالنور. إن الفَلاَحَ في العمل الصالحِ لا حَسَبَ كحُسنِ الخُلُقِ). وهو منصوب محلاًّ على أَنهُ مفعولٌ فيه، إن كان ظرفاً، نحو (جلستُ في الدار. سرتُ في الليل). وعلى أنه مفعولٌ لأجله غيرُ صريحٍ، إن كان الجارّ حرفاً يُفيد التّعليلَ والسببيّة، نحو: (سافرتُ للعلم، ونَصِبتُ من أَجلهِ، واغتربتُ فيه). وعلى أنه مفعولُ مُطلَق، إن ناب عن المصدر، نحو: (جرى الفرسُ كالرِّيح). [أي جرى جرياً كجري الريح. فلما حُذف المصدر نابت عنه صفته]. وعلى أنه خبرٌ للفعل الناقص، إن كان في موضع خبرهِ. نحو: (كنت في دِمَشقَ) . وإن وقعَ تابعاً لِمَا قبلهُ كان محلُّهُ من الإعراب على حسَب متبوعهِ، نحو: (هذا عالمٌ من أَهل مِصرَ. رأَيتُ عالماً من أَهل مَصر. أَخذتُ عن عالمٍ من أَهل مَصر). فإن لم يكن، أي المجرور، شيئاً ممّا تقدَّمَ كان في محلِّ نصبٍ على أنهُ مفعولٌ به غيرُ صريحٍ، نحو: (مررتُ بالقومِ، وَقفتُ على المِنبر. سافرتُ من بيروت إلى دِمشقَ). |
( الإضافة )
الإضافةُ: نِسبةٌ بينَ اسمين، على تقديرِ حرفِ الجر، توجِبُ جرَّ الثاني أبداً، نحو: (هذا كتابُ التلميذِ. لَبِستُ خاتمَ فِضَّة. لا يُقبلُ صِيامُ النهارِ ولا قيامُ اللَّيلِ إلا من المُخلِصينَ). ويُسمّى الأوَّلُ مضافاً، والثاني مضافاً إليهِ. فالمضافُ والمضافُ إليه: اسمانِ بينهما حرفُ جَرّ مُقدَّرٌ. وعاملُ الجرِّ في المضاف إليه هو المضافُ، لا حرفُ الجرّ المقدَّرُ بينهما على الصحيح. وفي هذا المبحث سبعةُ مَباحثَ: 1- أَنواعُ الإِضافةِ الإضافةُ أَربعةُ أنواع: لاميّةٌ وبَيانيّةٌ وظرفيةٌ وتَشبيهيَةٌ. فاللاميّةُ: ما كانت على تقدير (اللام). وتُفيدُ المِلكَ أَو الاختصاصَ. فالأولُ نحو: (هذا حصان عليٍّ). والثاني نحو: (أخذتُ بلِجامِ الفرس). والبَيانيّة: ما كانت على تقدير (مِن). وضابطُها أَن يكون المضاف إليه جنساً للمضاف، بحيثُ يكونُ المضافُ بعضاً من المضافِ إليه، نحو: (هذا بابُ خشبٍ. ذاك سِوارُ ذَهبٍ. هذه أثوابُ صوفٍ). (فجنس الباب هو الخشب., وجنس السوار هو الذهب. وجنس الأثواب هو الصوف. والباب بعض من الخشب. والسوار بعض من الذهب. والأثواب بعض من الصوف. والخشبُ بيَّن جنس الباب. والذهب بَيَّن جنسِ السوار. والصوف بَيَّن جنس الأثواب.والإضافة البيانية يصح فيها الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف. ألا ترى أنك إن قلت: (هذا البابُ خشبٌ، وهذا السوارُ ذهبٌ، وهذه الأثوابُ صوفٌ) صحّ). والظَّرفيةُ: ما كانت على تقدير (في). وضابطُها أن يكون المضاف إليه ظرفاً للمضاف. وتفيدُ زمانَ المضافِ أَو مكانَهُ، نحو: (سَهَرُ الليلِ مُضنٍ: وقُعودُ الدارِ مُخْمِلٌ). ومن ذلك أَن تقول: (كان فلانٌ رفيقَ المدرسةِ، وإلفَ الصّبا، وصديقَ الأيام الغابرة). قال تعالى: {يا صاحبَي السّجنِ}. والتشبيهيّةُ: ما كانت على تقدير (كاف التَّشبيهِ). وضابطُها أن يَضافَ المُشبَّهُ بهِ إلى المشبَّه، نحو: (انتثرَ لُؤْلؤُ الدمعِ على وَردِ الْخدودِ) ومنه قول الشاعر: وَالرِّيحُ تَعبَثُ بِالْغُصُونِ، وقَدْ جَرَى ذَهَبُ الأَصيلِ عَلى لُجَيْنِ الْمَاءِ 2- الإِضافةُ الْمَعنَويَّةُ وَالإِضافةُ اللَّفْظيَّة تنقسمُ الإضافة أَيضاً إلى معنويَّةٍ ولفظيّة. فالمعنويّةُ: ما تُفيدُ تَعريفَ المضافِ أَو تخصيصهُ. وضابطُها أَن يكون المضافُ غيرَ وَصفٍ مَضافٍ إلى معمولهِ. بأن يكون غيرَ وصف أَصلاً: كمفتاحِ الدَّارِ، أو يكونَ وصفاً مضافاً إلى غير معمولهِ: ككاتبِ القاضي، ومأكولِ الناس، ومشربهم وملبوسهم. وتفيدُ تعريفَ المضافِ إن كان المضافُ إليهِ معرفةً، نحو: (هذا كتابُ سعيدٍ)، وتخصيصَهُ، إن كان نكرةً، نحو: (هذا كتابُ جلٍ). إلاّ إذا كان المضافُ مُتَوغِّلاً في الإبهام والتّنكير، فلا تُفيدُهُ إضافتُهُ إلى المعرفة تعريفاً، وذلك مثل صغيرٍ ومِثلٍ وشِبهٍ ونظيرٍ، نحو: (جاءَ رجلٌ غيرُك، أَو مثل سليمٍ، أو شبهُ خليلٍ، أَو نظيرُ سعيدٍ)، أَلا ترى أَنها وقعت صفةً لرجلٍ، وهو نكرةٌ، ولو عُرِّفت بالإضافة لَمَا جاز أَن تُوصفَ بها النكرةُ، وكذا المضافُ إلى ضمير يعودُ إلى نكرة، فلا يتعرَّف بالإضافة إليه، نحو: (جاءني رجلٌ وأخوه. رُبَّ رجلٍ وولدهِ. كم رجلٍ وأَولادهِ). وتُسمّى الإضافةُ المعنويةُ أَيضاً (الإضافةَ الحقيقيّةَ) و (الإضافةَ المحضةَ). (وقد سُميت معنوية لأنَّ فائدتها راجعة إلى المعنى، من حيث أنها تفيد تعريف المضاف أو تخصيصه. وسميت حقيقية لأنّ الغرض منها نسبة المضاف إلى المضاف إليه. وهذا هو الغرض الحقيقي من الإضافة. وسميت محضة لأنها خالصة من تقدير انفصال نسبة المضاف من المضاف إليه. فهي على عكس الإضافة اللفظية، كما سترى). والإضافةُ اللفظيّةُ: ما لا تُفيدُ تعريف المضاف ولا تخصيصَهُ وإنما الغرَضُ منها التّخفيفُ في اللفظ، بحذفِ التنوينِ أَو نوني التّثنيةِ والجمع. وضابطُها أَن يكون المضاف اسمَ فاعلٍ أو مُبالغةَ اسمِ فاعلٍ، أو اسمَ مفعولٍ، أو صفةً مُشبّهةً، بشرط أن تضافَ هذهِ الصفاتُ إلى فاعلها أو مفعولها في المعنى، نحو: (هذا الرجلُ طالبُ علمٍ. رأَيتُ رجلاً نَصّارَ المظلومِ. أنصرْ رجلاً مهضومَ الحقِّ. عاشِرْ رجلاً حسَنَ الخُلُق). والدليلُ على بقاءِ المضافِ فيها على تنكيرهِ أنهُ قد وُصفت به النكرةُ، كما رأَيت، وأنهُ يقعُ حالاً، والحالُ لا تكون إلا نكرةً، كقولك: (جاءَ خالدٌ باسمَ الثَّغرِ)، وقولِ الشاعر: فَأتَتْ بِهِ حُوشُ الفُؤَادِ مُبَطَّناً سُهُداً إذا ما نامَ لَيْلُ الهَوْجَلِ [حوش الفؤاد وحشية، وذلك لحدته وتوقده. مبطناً: ضامر الخصر. والهوجل: الثقيل الكسلان] وأنه تُباشرُهُ (رُبّ)، وهي لا تُباشرُ إلا النَّكراتِ، كقول بعضِ العرب، وقد انقضى رمضانُ: (يا رُبَّ صائمه لن يَصومَهُ، ويا رُبَّ قائمهِ لن يَقومَهُ). وتُسمّى هذه الإضافةُ أيضاً (الإضافةَ المجازيَّةَ) و (الإضافةَ غيرَ المحضة). (أما تسميتها باللفظية فلانّ فائدتها راجعة إلى اللفظ فقط، وهو التخفيف اللفظي، بحذف التنوين ونوني التثنية والجمع. وأما تسميتها بالمجازية فلأنها لغير الغرض الأصلي من الإضافة. وانما هي للتخفيف، كما علمت. وأما تسميتها بغير المحضة فلأنها ليست اضافة خالصة بالمعنى المراد من الإضافة: بل هي على تقدير الانفصال، ألا ترى أنك تقول فيما تقدَّم: (هذا الرجل طالبٌ علماً. رأيت رجلاً نصاراً للمظلوم. انصر رجلاً مهضوماً حقّه. عاشر رجلاً حسناً خلقُه)). 3- أَحكامُ المُضافِ يجبُ فيما تُراد إضَافتهُ شيئانِ: 1- تجريدُهُ من التَّنوين ونونيِ التَّثنيةِ وجمعِ المذكرِ السّالم: ككتابٍ الأستاذٍ، وكتابَيِ الأستاذِ، وكاتِبي الدَّرسِ. 2- تجريدُهُ من (ألْ) إذا كانت الإضافةُ معنويَّة، فلا يُقالُ: (الكتابُ الأستاذِ). وأمّا في الإضافةِ اللفظيَّة. فيجوز دخولُ (أل) على المضافِ، بشرطِ أن يكونَ مُثنّى، (المُكرما سليمٍ)، أو جمعَ مذكرٍ سالماً، نحو: (المُكرمو عليٍّ)، أو مضافاً إلى ما فيه ( أل)، نحو: (الكاتبُ الدَّرسِ)، أو لاسمٍ مضافٍ إلى ما فيه (أل) نحو: (الكاتبُ درسِ النَّحوِ)، أو لاسمٍ مضافٍ إلى ضمير ما فيه (أل)، كقول الشاعر: الوُدُّ، أَنتِ المُسْتَحِقَّةُ صَفْوِهِ مِنّي وإنْ لَمْ أَرْجُ مِنْك نَوالا (ولا يقال: (المكرم سليم، والمكرمات سليم، والكاتب درس)، لأن المضاف هنا ليس مثنى، ولا جمعَ مذكر سالماً، ولا مضافاً الى ما فيه (ألى) أو الى اسم مضاف الى ما فيه (أل). بل يقال: (مكرم سليم، ومكرمات سليم، وكاتب درس). بتجريد المضاف من (أل)). وجوَّزَ الفَرّاءُ إضافةَ الوصفِ المقترنِ بأل إلى كل اسمِ معرفةٍ، بلا قيدٍ ولا شرطٍ. والذوقُ العربيُّ لا يأبى ذلك. |
4- بَعْضُ أَحكامٍ للإِضافة
أ- قد يكتسبُ المضافُ التأنيثَ أو التذكيرَ من المضاف إليه، فيُعامَلُ معاملةَ المؤنثِ، وبالعكس، بشرطِ أن يكون المضافَ صالحاً للاستغناءِ عنه، وإقامةِ المضافِ إليه مُقامَهُ، نحو: (قُطعتْ بعضُ أصابعهِ)، ونحو: (شمسُ العقلِ مكسوفٌ بِطَوعِ الهَوى)، قال الشاعر: أَمُرُّ عَلى الدِّيارِ، دِيارِ لَيْلى أُقَبِّلُ ذا الجِدارَ وذَا الجِدارا وما حُبُّ الدِّيارِ شَغَفْنَ قَلْبي وَلكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيارا والأولى مُراعاةُ المضاف، فتقولُ: (قُطعَ بعضُ أصابعهِ. وشمسُ العقل مكسوفةٌ بِطَوع الهوى. وما حبُّ الديار شغفَ قلبي). إلا إذا كان المضافُ لفظَ (كُلّ) فالأصلحُّ التأنيث، كقوله تعالى: (يومَ تَجِدُ كلُّ نفسٍ ما عَمِلتْ من خير مُحضَراً)، وقولِ الشاعر: جادَتْ عَلَيْهِ كُلُّ عَيْنٍ ثَرَّةٍ فَتَرَكْنَ كُلَّ حَديقَةٍ كَالدِّرْهَمِ [العين: مطر يدوم أياماً لا ينقطع. [يطلق عليه في حوران لزبة] وثرة: غزيرة] أما إذا لم يصحَّ الاستغناءُ عن المضاف، بحيثُ لو حُذفَ لَفَسدَ المعنى، فمُراعاةُ تأنيثِ المضاف أو تذكيرِهِ واجبةٌ، نحو: (جاءَ غُلامُ فاطمةَ، وسافرتْ غلامةُ خليلٍ)، فلا يقالُ: (جاءَت غلامُ فاطمةَ)، ولا (سافر غلامةُ خليل)، إذ لو حُذف المضافُ في المثالين، لفسدَ المعنى. ب- لا يَضافُ الاسمُ إلى مرادِفه، فلا يقالُ: (ليثُ أسدِ)، إِلا إِذا كانا عَلمينِ فيجوزُ، مثل: (محمدُ خالدٍ)، ولا موصوفٌ إلى صفتهِ، فلا يقال: (رجلُ فاضلٍ). وأما قولهم: (صلاةُ الأولى، ومَسجدُ الجامعِ، وحَبَّةُ الحَمقاءِ، ودارُ الآخرةِ، وجانبُ الغربي، فهو على تقدير حذفِ المضافِ إليه وإقامةِ صفتهِ مُقامَهُ. والتأويلُ: (صلاةُ الساعةِ الأولى، ومسجدُ المكان الجامع، وحبةُ البَقلة الحمقاءِ، ودارُ الحياة الآخرة، وجانبُ المكانِ الغربي). وأمّا إضافةُ الصفةِ إلى الموصوف فجائزةٌ، بشرط ان يصحَّ تقديرُ (مِن) بين المضافِ والمضافِ إليه، نحو: (كرامُ الناسِ، وجائبةُ خبرٍ، ومُغَرِّبةُ خَبرٍ، وأخلاقُ ثياب، وعظائمُ الأمورِ، وكبيرُ أمرٍ). والتقديرُ: (الكرام من الناس، وجائبةٌ من خبر الخ). أمّا إذا لم يصحْ (مِن) فهيَ ممتنعةٌ، فلا يقالُ: (فاضلُ رجلٍ، وعظيمُ أمير). ج- يجوز أن يُضافَ العامُّ إلى الخاصّ. كيوم الجُمعة، وشهر رمضانَ. ولا يجوزُ العكسُ، لعدم الفائدة، فلا يقالُ: (جُمعة اليوم، ورمضان الشهر). د- قد يضافُ الشيءُ إلى الشيءُ لأدنى سَببٍ بينَهما (ويُسمُّونَ ذلك بالإضافةِ لأدنى مُلابَسةٍ)، وذلكَ أنك تقولُ لرجلٍ كنتَ قد أجتمعتَ به بالأمسِ في مكان: (انتظرني مكانَكَ أمسِ)، فأضفتَ المكانَ إليه لأقلَّ سببٍ، وهو اتفاقُ وُجوده فيه، وليس المكانُ ملكاً لهُ ولا خاصاً به، ومنه قول الشاعر: إذا كَوْكَبُ الخَرْقاءِ لاحَ بِسُحْرَةٍ سُهَيْلٌ، أَذاعَتْ غَزْلَها في القَرائِبِ [سهيل: هو النجم المعروف. وهو بدل من كوكب. والخرقاء: امرأة كانت لا تعتني بعملها إلا إذا طلع هذا الكوكب] هـ- إذا أمِنوا الالتباسَ والإبهامَ حذفوا المضافَ وأقاموا المضافَ إليه مُقامَهُ، وأعربوهُ بإِعرابهِ، ومنه قولهُ تعالى: {واسألِ القريةَ التي كنّا فيها والعِيرَ التي أقبلنا فيها}، والتقديرُ: واسألْ أهل القريةَ وأصحابَ العِيرِ. أما إن حصلَ بحذفه إبهامٌ والتباسٌ فلا يجوزُ، فلا يُقالُ: (رأيتُ عليّاً)، وأنتَ تُريدُ (رأيتُ غلامَ عليّ). و- قد يكونُ في الكلام مضافانِ اثنانِ، فيُحذَفَ المضافُ الثاني استغناءً عنهُ بالأوَّل، كقولهم: (ما كلُّ سَوداءَ تَمرةً، ولا بيضاءَ شَحمةً)، فكأنَّكَ قلتَ: (ولا كلُّ بيضاءَ شحمة). فبيضاء: مُضافٌ إلى مضافٍ محذوف. ومثلُهُ قولُهم: (ما مثلُ عبد اللهِ يقولُ ذلك، ولا أخيهِ)، وقولُهم: (ما مثلُ أبيكَ، ولا أخيكَ يقولان ذلك). ز- قد يكونُ في الكلام اسمانِ مضافٌ إليهما فيُحذَفُ المضاف إليه الأول استغناءً عنه بالثاني، نحو: (جاءَ غلامُ وأخو عليّ). والأصلُ: (جاءَ غلامُ عليَّ وأخوهُ). فلمّا حُذِفَ المضافُ إليه الأول جعلتَ المضافَ إليه الثاني اسماً ظاهراً، فيكون (غلام) مضافاً، والمضافُ إليه محذوف تقديرُه: (علي)، ومنه قول الشاعر: يا مَنْ رَأَى عارِضاً أُسَرُّ بهِ بَيْنَ ذِراعَيْ وَجَبْهَةِ الأَسَدِ [العارض: السحاب المعترض في الأفق. والأسد: أراد به برج الأسد] والتقديرُ: (بينَ ذراعيِ الأسد وجبهتهِ). وليس مثلُ هذا بالقويِّ والأفضلُ ذكرُ الاسمين المضاف إليهما معاً. 5- الأَسماءِ المُلاَزِمةُ للإِضافة من الأسماءِ ما تمتنعُ إضافتُه، كالضمائرِ وأسماءِ الإشارةِ والأسماءِ الموصولةِ وأسماءِ الشرط وأسماءِ الاستفهام، إلاّ (أيّاً)، فهي تُضافُ. ومنها ما هو صالحُ للاضافة والإفراد (أي: عدمِ الإضافة)، كغلامٍ وكتابٍ وحصانٍ ونحوهما. ومنها ما هو واجبُ الإضافة فلا ينفكُّ عنها. وما يُلازِمُ الإضافة على نوعين: نوعٍ يلازِمُ الإضافةَ إلى المفرد. ونوعٍ يُلازمُ الإضافةً إلى الجملة. |
6- المُلازِمُ الإِضافةِ إلى المُفْرَد
إنَّ ما يُلازمُ الإضافةَ إلى المفرد نوعان: نوعٌ لا يجوزُ قطعُه عن الإضافة، ونوعٌ لا يجوزُ قطعهُ عنها لفظاً لا معنًى، أي يكونُ المضافُ إليه مَنوِياً في الذِّهن. فما يلازمُ الاضافةَ إلى المفردِ، غيرَ مقطوعٍ عنها، هو: (عِند وَلدَى وَلدُن وبين ووَسط (وهي ظروف) وشِبْهٌ وقابٌ وكِلاَ وكِلتا وسوَى وذُو وذاتٌ وذَوَا وذَوَاتا وذَوُو وذواتِ وأُولُو وأَولات وقُصارَى وسُبحان ومَعاذ وسائر ووَحْد ولبَّيْك وسَعدَيكَ وحَنانَيكَ ودَواليكَ)(وهي غيرُ ظروف). وأمّا ما يُلازم الإضافةَ إلى المفرد، تارةً لفظاً وتارةً معنًى، فهو (أوَّل ودون وفَوق وتحت ويمين وشِمال وأمام وقُدَّام وخَلف وورَاء وتِلقاء وتجاه وإزاء وحِذاء وقبل وبعد ومَع (وهي ظروف) وكلٌّ وبعضٌ وغير وجميعٌ وحَسْبٌ وأيُّ)(وهي غيرُ ظروف). أحكام ما يلازم الاضافة إلى المفرد أ- ما يُلازمُ الاضافةَ إلى المفرد لفظاً، منه ما يضافُ إلى الظاهر والضميرِ، وهوَ: (كِلاَ وكِلتا ولَدى وَلدُنْ وعند وسوى وبين وقُصارَى ووسَط ومِثل وذَوُو ومَع وسُبحان وسائر وشِبه). ومنه ما لا يُضافُ إلا إلى الظاهر، وهو: (أُولو وأُولات وذُو وذات وذَوَا وذَوَاتا وقاب ومَعاذ). ومنه ما لا يضافُ إلا إلى الضميرِ، وهو: (وَحْد)، ويضافُ إلى كلِّ مَضمَرٍ فتقولُ: (وحدَهُ ووحدَكَ ووحدَها ووحدَهما ووحدَكم) الخ، و (لبَّيكَ وسَعدَيكَ وحنانيكَ ودَواليكَ) ولا تُضاف إلا إلى ضمير الخطاب، فتقول: (لبَيَّكَ ولَبيّكما وَسعدَيكمُ) الخ. (وهي مصادر مثناة لفظاً، ومعناها التكرار، فمعنى (لبيك): اجابة لك بعد اجابة. ومعنى (سعديك): اسعاداً لك بعد اسعاد. وهي لا تُستعمل الا بعد (لبيك). ومعنى (حنانيك): تحنّناً عليك بعد تحنن. ومعنى (دواليك): تداولاً بعد تداول. وهذه المصادر منصوبة على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف، اذ التقدير: (ألبيك تلبيةً بعد تلبيةٍ. وأسعدك إسعاداً بعد اسعاد) الخ. وعلامة نصبها الياء لأنها تثنية). ب- كِلا وكلتا: إن أُضيفتا إلى الضمير أُعربتا إعرابَ المُثنّى، بالألف رفعاً، وبالياءِ نصباً وجراً، نحو: (جاءَ الرجلانِ كلاهما. رأيتُ الرجلين كليهما. مررتُ بالرجلين كليهما). وإن أُضيفتا إلى اسمٍ غيرِ ضمير أُعربتا إِعرابَ الاسم المقصور، بحركاتٍ مُقدَّرةٍ على الألف للتعذُّر، رفعاً ونصباً وجراً. نحو: (جاءَ كِلا الرجلين. رأيتُ كلا الرجلين. مررتُ بكلا الرجلين). وحُكمُهُما أنهما يَصحُّ الإخبارُ عنهما بصفةٍ تحملُ ضميرَ المفرد، باعتبار اللفظِ، وضميرَ المثنّى، باعتبار المعنى، فتقول: (كِلا الرجلين عالم) و (كلا الرجلين عالمان). ومراعاةُ اللفظ أكثر. وهما لا تُضافان إلا إلى المعرفة، وإلى كلمةٍ واحدة تدُلُّ على اثنين، فلا يُقال: (كِلا رجلينِ)، لأن (رجلين) نكرة، ولا (كِلا عليٍّ وخالدٍ)، لأنها مضافةٌ إلى المفرد. ج- أيُّ. على خمسة أنواعٍ: موصوليّةٍ ووصفيّةٍ وحاليّةٍ واستفهاميّةٍ وشرطيّة. فإن كانت اسماً موصولاً فلا تُضاف إلا إلى معرفةٍ، كقولهِ تعالى: {ثُمَّ لَنَنزِعنَّ من كلِّ شيعةٍ أيُّهم أشدُّ على الرَّحمنِ عِتِياً}. وإن كانت منعوتاً بها، او واقعةً حالاً، فلا تُضافُ إلا إلى النكرةِ، نحو: (رأيتُ تلميذاً أيَّ تلميذٍ)، ونحو: (سرَّني سليمٌ أيَّ مجتهدٍ). وإن كانت استفهاميّةً، أو شرطيّةً، فهي تُضافُ إلى النكرة والمعرفة، فتقولُ في الاستفهاميّة: (أي رجلٍ جاءَ؟ وأيُّكم جاءَ؟)، وتقولُ في الشرطيّة (أيُّ تلميذٍ يجتهدْ أكرمْهُ. وأيكم يجتهدْ أُعطهِ). وقد تُقطَعُ (أيُّ)، الموصوليّةُ والاستفهاميّة والشرطيّةُ، عن الاضافة لفظاً، ويكونُ المضافُ إليه مَنوياً، فالشرطيّةُ كقولهِ تعالى: {أيّاً ما تَدعُوا فلَهُ الأسماءُ الحُسنى}. والتقديرُ: (أيَّ اسمٍ تدعو)، والاستفهاميّةُ نحو: (أيٌّ جاءَ؟ وأيّاً أكرمتَ؟)، والموصوليّةُ نحو: (أيٌّ هوَ مجتهدٌ يفوزُ. وأكرمْ أيّاً هو مجتهدٌ). أما (أيُّ) الوصفيّةُ والحاليّةُ فملازمةٌ للاضافة لفظاً ومعنًى. د- مَعَ وَقبل وبَعد وأوَّل ودون والجهاتُ الستُّ وغيرُها من الظُّروف، قد سبقَ الكلامُ عليها مُفصلاً في مبحث الأسماءِ المبنية، وفي مبحث أحكام الظروف المبنيةِ، في باب المفعول فيه. فراجع ذلك. هـ- غير: اسمٌ دال على مخالفةِ ما بعدَه لحقيقةِ ما قبلَهُ. وهو ملازمٌ للاضافةِ. وإذا وقعَ بعدَ (ليس) أو (لا) جازَ بقاؤه مضافاً، نحو: (قبضتُ عشرة ليس غيرها، أو لا غيرها): وجازَ قطعهُه عن الاضافة لفظاً وبناؤه على الضمَّ، على شرط أن يُعلَمَ المضاف إليهِ، فتقول: (ليس غيرُ أو لا غيرُ). و- حَسب: بمعنى ( كافٍ). ويكون مضافاً، فيعرَبُ بالرفع والنصب والجر. وهو لا يكون إلا مبتدأ، مثل: (حسبُكَ اللهُ)، أو خبراً نحو: (اللهَ حَسبي)، أو حالاً نحو: (هذا عبدُ اللهِ حسبَكَ من رجلٍ)، أو نعتاً نحو: (مررتُ برجلٍ حَسبِكَ من رجلٍ. رأيتُ رجلاً حَسبَكَ من رجلٍ. هذا رجلٌ حَسبُكَ من رجل). ويكونُ مقطوعاً عن الاضافة، فيكون بمنزلةِ (لا غيرُ) فيُبنى على الضمِّ، ويكونُ إعرابهُ محليّاً، نحو: (رأيتُ رجلاً حسبُ. رأيت علياً حسبُ. هذا حسبُ). فحسبُ، في المثالِ الأول، منصوبٌ محلاً، لأنه نعتٌ لرجلاً، وفي المثال الثاني منصوبٌ محلاً، لأنه حالٌ من (عليّ) وفي المثال الثالث مرفوعٌ محلاً لأنه خبر المبتدأ. وقد تَدخلُه الفاءُ الزائدةُ تزييناً لِلَّفظِ، نحو: (أخذت عشرةً فحسبُ). ز- كلٌّ وبعضٌ: يكونان مُضافينِ، نحو: (جاءَ كلُّ القومِ أو بعضُهم) ومقطوعينِ عن الاضافة لفظاً، فيكون المضافُ إليه مَنوياً، كقوله تعالى: {وكُلاًّ وعدَ اللهُ الحُسنى}، أي: كلاًّ من المجاهدينَ والقاعدينَ، أي: كلَّ فريق منهم، وقولهِ: {وفضّلنا بعض النّبيينَ على بعضٍ}، أي: على بعضهم. ح- جميعٌ: يكونُ مضافاً، نحو: (جاءَ القومُ جميعُهم). ويكون مقطوعاً عن الاضافةِ منصوباً على الحال، نحو: (جاءَ القومُ جميعاً)، أي: مجتمعينَ. |
7- المُلاَزِمُ الإضافة إِلى الجُمْلَةِ
ما يلازمُ الاضافةَ إلى الجملة هو: (إذْ وحيثُ وإذا ولمّا ومذ ومُنذ). فإذْ وحيثُ: تُضافانِ إلى الجُملِ الفعليّة والاسميّة، على تأويلها بالمصدر. فالأولُ كقوله تعالى: {واذكروا إذْ كُنتم قليلاً}، وقولهِ: {فأتوهنَّ من حيثُ أمرَكمَ اللهُ}، والثاني كقوله عزَّ وجلَّ: {واذكروا إذْ أنتم قليلٌ}، وقولِكَ: (اجلِسْ حيث العلمُ موجودٌ). و (إذا ولمّا). تُضافانِ إلى الجملِ الفعليةِ خاصةً، غير أن (لمّا) يجبُ أن تكونَ الجملةُ المضافةُ إليها ماضيّةً، نحو: (إذا جاءَ عليٌّ أكرمتُه) و (لمّا جاءَ خالدٌ أعطيته). و (مُذْ ومنذُ) : إن كانتا ظرفينِ؛ أُضيفتا إلى الجمل الفعليّةِ والاسميّة، نحو: (ما رأَيتُكَ مُذْ سافرَ سعيدٌ. وما اجتمعنا منذُ سعيدٌ مسافرٌ). وإن كانتا حرفيْ جرٍّ، فما بعدَهما اسمٌ مجرورٌ بهما. كما سبق الكلام عليهما في مبحث حروف الجرّ. واعلم أنَّ (حيثُ) لا تكون إلا ظرفاً. ومن الخطأ استعمالُهما للتعليلِ، بمعنى: (لأن)، فلا يُقالُ: (أكرمتُه حيث إنه مجتهدٌ)، بل يُقالُ: (لأنه مجتهدٌ). وما كان بمنزلةِ (إذْ) أَو (إذا)، في كونه اسمَ زمانٍ مُبهماً لِمَا مضَى أَو لما يأتي، فإنهُ يُضافُ إلى الجمل، نحو: (جئتك زمنَ عليٌّ والٍ)، أَو (زمنَ كان عليٌّ والياً)، ومنه قوله تعالى: {يومَ لا ينفعُ مالٌ ولا بَنونَ، إلا من أتى اللهَ بقلبٍ سليم}، وقوله: {هذا يومُ ينفعُ الصادقينَ صِدقُهُم}. |
التوابع وإعرابها
قدمنا في الكلام عن مرفوعات الأسماء ومنصوباتها ومجروراتها، أن الاسم يُرفع إن كان تابعاً لمرفوع، ويُنصب، إن كان تابعاً لمنصوب، ويُجر إن كان تابعاً لمجرور. والتوابع هي الكلمات التي لا يَمَسُّها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها. بمعنى أنها تُعرب إعراب ما قبلها. وهي خمسة أنواع. 1ـ النعت. 2ـ التوكيد 3ـ البدل 4ـ عطف البيان 5ـ المعطوف بالحرف ( النعت ) النّعتُ (ويُسمّى الصَّفَةَ أَيضاً): هو ما يُذكرُ بعدَ اسمٍ ليُبيَّنَ بعض أَحوالهِ أَو أَحوال ما يَتعلَّقُ به. فالأوَّلُ نحو: (جاءَ التلميذُ المجتهدُ)، والثاني نحو: (جاءَ الرجلُ المجتهدُ غلامُهُ). (فالصفة في المثال الأول بينت حال الموصوف نفسه. وفي المثال الثاني لم تبين حال الموصوف، وهو الرجل، وإنما بينت ما يتعلق به، وهو الغلام). وفائدةُ النَّعتِ التَّفرقةُ بينَ المشتركينَ في الاسم. ثمَّ إن كان الموصوفُ معرفةً ففائدةُ النّعتِ التَّوضيح. وإن كانَ نكرةً ففائدتهُ التّخصيصُ. (فان قلت: (جاء عليّ المجتهد) فقد أوضحت من هو الجائي من بين المشتركين في هذا الاسم. وإن قلت: (صاحب رجلاً عاقلاً)، فقد خصصت هذا الرجل من بين المشاركين له في صفة الرجولية). وفي هذا المبحث خمسةُ مباحثَ: 1- شَرْطُ النَّعْتِ الأصلُ في النعتِ أن يكونَ اسماً مُشتقاً، كاسم الفاعل واسمِ المفعول والصفةِ المُشبّهة واسم التّفضيل. نحو: (جاء التلميذُ المجتهدُ. أكرِمْ خالداً المحبوبَ. هذا رجلٌ حسنٌ خُلقُهُ. سعيدٌ تلميذٌ أعقلُ من غيره). وقد يكونُ جملةً فعليّةً، أو جملةً اسميةً على ما سيأتي. وقد يكون اسماً جامداً مُؤوَّلاً بمشتقٍّ. وذلك في تسعِ صُوَرٍ: أ- المصدرُ، نحو: (هو رجلٌ ثِقةٌ)، أي: موثوقٌ بهِ، و (أنتَ رجلٌ عَدلٌ)، أي: عادلٌ. ب- اسمُ الاشارةِ، نحو: (أكرِمْ عليّاً هذا)، أي: المشارُ إليه. ج- (ذُو)، التي بمعنى صاحب، و (ذات)، التي بمعنى صاحبة، نحو: (جاءَ رجلٌ ذُو علمٍ، وامرأةٌ ذاتُ فَضلٍ)، أي: صاحبُ علمٍ، وصاحبة فضلٍ. د- الاسمُ الموصولُ المقترنُ بألْ، نحو: (جاءَ الرجلُ الذي اجتهدَ)، أي: المجتهدُ. هـ- ما دلَّ على عَدَد المنعوتِ، نحو: (جاءَ رجالٌ أربعةُ)، أي: مَعْدُودُونَ بهذا العَدَد. و- الاسمُ الذي لحقتهُ ياءُ النسبة، نحو: (رأيتُ رجلاً دِمَشقيّاً)، منسوباً إلى دِمَشق. ز- ما دلَّ على تشبيهٍ، نحو: (رأيتُ رجلاً أسداً)، أي: شجاعاً، و (فلانٌ رجلٌ ثَعلبٌ)، أي: محتالٌ. والثعلبُ يُوصفُ بالاحتيالِ. ح- (ما) النكرةُ التي يُرادُ بها الابهامُ، نحو: (أُكرِمُ رجلاً ما) أي: رجلاً مُطلقاً غيرَ مُقيّدٍ بصفةٍ ما. وقد يُرادُ بها معَ الابهامِ التهويلُ، ومنهُ المثلُ: (لأمرٍ ما جَدَعَ قَصيرٌ أنفَهُ)، أي لأمرٍ عظيمٍ. ط- كَلِمتا (كلٍّ وأيٍّ)، الدَّالتينِ على استكمال الموصوفِ للصفةِ، نحو: (أنتَ رجلٌ كلُّ الرجلِ)، أي: الكاملُ في الرُّجوليّةِ، و (جاءَني رجلٌ أيُّ رجلٍ)، أي: كاملٌ في الرجوليّةِ. ويقال أيضاً: (جاءَني رجلٌ أيُّما رجلٍ)، بزيادةِ (ما). |
2- النَّعْتُ الحَقيقِيُّ وَالنَّعْتُ السَّبَبِيُّ
ينقسمُ النعتُ إلى حقيقيٍّ وسببيٍّ. فالحقيقيُّ: ما يُبيِّنُ صفةً من صفاتِ مَتبوعهِ، نحو: (جاءَ خالدٌ الأديبُ). والسَّببيُّ: ما يُبيِّنُ صفةً من صفاتِ ما لهُ تَعلقٌ بمتبوعهِ وارتباطٌ به نحو: (جاءَ الرجلُ الحسنُ خطُّهُ). (فالأديب بين صفة مبتوعه، وهو خالد. أما الحسن فلم يبين صفة الرجل، إذ ليس القصد وصفه بالحسن، وإنما بين صفة الخط الذي له ارتباط بالرجل، لأنه صاحبه المنسوب إليه). والنعتُ: يجبُ أن يَتْبعَ منعوتَهُ في الاعراب والافرادِ والتَّثنية والجمعِ والتذكيرِ والتأنيث والتعريفِ والتنكير. إلا إذا كان النَّعتُ سببيّاً غيرَ مُتحمّلٍ لضميرٍ المنعوتِ، فيَتبعُهُ حينئذٍ وجوباً في الاعراب والتعريف والتنكير فقط. ويراعَى في تأنيثهِ وتذكيره ما بعدَهُ. ويكونُ مُفرَداً دائماً. فتقولُ في النَّعت الحقيقي: (جاءَ الرجلُ العاقلُ. رأيتُ الرجلَ العاقلَ.مررتُ بالرجلِ العاقلِ. جاءَت فاطمةُ العاقلةُ. رأيت فاطمةَ العاقلةَ. مررت بفاطمةَ العاقلةِ. جاءَ الرجلانِ العاقلانِ. رأَيتُ الرجلين العاقلين. جاءَ الرجالُ العُقلاءُ. رأيتُ الرجالَ العُقلاءَ. مررتُ بالرجالِ العقلاءِ. جاءَت الفاطماتُ العاقلاتُ. رأيت الفاطماتِ العاقلاتِ. مررتُ بالفاطماتِ العاقلاتِ). وتقولُ في النعتِ السّببيِّ، الذي لم يَتحمّل ضميرَ المنعوت: (جاءَ الرجلُ الكريمُ أَبوه، والرجلانِ الكريمُ أَبوهما، والرجالُ الكريمُ أَبوهم، والرجلُ الكريمة أُمُّهُ. والرجلانِ الكريمةُ أُمُّهما، والرجالُ الكريمةُ. أُمُّهم، والمرأةُ الكريمُ أبوها، والمرأتانِ الكريمُ أَبوهما، والنساءُ الكريمُ أبوهنَّ، والمرأَة الكريمةُ أُمُّها، والمرأَتانِ الكريمةُ أُمُّهما، والنساءُ الكريمةُ أُمُّهنَّ). أَمَّا النّعتُ السبَبيُّ، الذي يَتحمّلُ ضميرَ المنعوتِ، فيطابقُ منعوتَهُ إفراداً وتثنيةً وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً، كما يُطابقهُ إعراباً وتعريفاً وتنكيراً، فتقولُ: (جاءَ الرجلانِ الكريما الأبِ، والمرأتانِ الكريمتا الأبِ، والرجالُ الكرامُ الأبِ، والنساءُ الكريماتُ الأبِ). واعلم أنهُ يُستثنى من ذلكَ أربعةُ أشياء: أ- الصفاتُ التي على وزنِ (فَعُول) - بمعنى (فاعل) نحو: (صَبُورٍ وغَيورٍ وفَخُورٍ وشكُورٍ)، أو على وزن (فَعِيل) - بمعنى (مفعول) - نحو: (جريح وقَتيل وخَضيبٍ)، أو على وزن (مفعالٍ)، نحو: (مِهذار ومِكسال ومِبسامٍ)، أو على وزن (مِفعيلٍ) نحو: (مِعطيرٍ ومِسكينٍ)، أو على وزن (مِفعَلٍ)، نحو: (مِغشَمٍ ومِدعسٍ ومِهذَرٍ). فهذه الأوزان الخمسةُ يَستوي في الوصفِ بها المذكرُ والمؤنثُ، فتقولُ: (رجلٌ غيورٌ، وامرأةٌ غيورٌ، ورجلٌ جريحٌ، وامرأة جريح) الخ. [المدعس: الطعان. وهو صفة مبالغة من الدعس، وهو الطعن. والدعس أيضاً: الوطء. والمدعس أيضاً: الرمح. والطريق الذي لينته المارة] ب- المصدرُ الموصوفُ به، فإنه يبقى بصورةٍ واحدةٍ للمفردِ والمثنّى والجمع والمذكّرِ والمؤنث، فتقولُ: (رجلٌ عدلٌ، وامرأة عدلٌ. ورجلانِ عَدلٌ. وامرأتانِ عدلٌ. ورجالٌ عَدلٌ. ونساءٌ عَدلٌ). ج- ما كان نعتاً لجمعِ ما لا يَعقلُ، فإنهُ يجوز فيه وجهان: أن يُعاملَ مُعاملةَ الجمعِ، وأن يُعامَلَ مُعاملةَ المفردِ المؤنث، فتقولُ: (عندي خيولٌ سابقاتٌ، وخيولٌ سابقة). وقد يوصفُ الجمعُ العاقلُ، إن لم يكن جمعٌ مُذكرٍ سالماً، بصفة المفردة المؤنثة: كالأمم الغابرة. 4- ما كان نعتاً لاسمِ الجمع، فيجوزُ فيه الإفرادُ، باعتبارِ لفظِ المنعوتِ والجمعُ، باعتبارِ معناهُ، فتقولُ: (إنَّ بَني فلان قومٌ صالحٌ وقومٌ صالحون). |
3- النَّعْتُ المُفْرَدُ والجُمْلَةُ وشِبْهُ الجُمْلَة
ينقسم النّعتُ أيضاً إلى ثلاثةِ أقسامٍ: مُفرَدٍ وجملةٍ وشِبهِ جُملة. فالمفردُ: ما كانَ غيرَ جملةٍ ولا شِبهَها، وإن كان مُثنًى أو جمعاً، نحو: (جاءَ الرجلُ العاقلُ، والرجلان العاقلانِ، والرجالُ العُقلاءُ). والنّعتُ الجملةُ: أن تقعَ الجملةُ الفعليّةُ أو الاسميّة منعوتاً بها، نحو: (جاءَ رجلٌ يَحملُ كتاباً) و (جاءَ رجلٌ أبوهُ كريمٌ). ولا تقعُ الجملةُ نعتاً للمعرفة، وإنما تقعُ نعتاً للنكرةِ كما رأيتَ. فإن وقعت بعد المعرفة كانت في موضع الحال منها، نحو: (جاءَ عليٌّ يحملُ كتاباً). إلاّ إذا وقعت بعد المعرَّفِ بأل الجنسيّةِ، فيصح أن تُجعَلَ نعتاً له، باعتبار المعنى، لأنهُ في المعنى نكرةٌ، وأن تُجعل حالاً منهُ، باعتبار اللفظ، لأنهُ مُعرَّفٌ لفظاً بألْ، نحو: (لا تُخالطِ الرجلَ يَعملُ عملَ السُّفهاءِ)، ومنه قولُ الشاعر: وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئيمِ يَسُبُّني فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ: لا يَعنيني وقولِ الآخر: وَإني لَتَعروني لِذِكْراكِ هَزَّةٌ كمَا انْتَفَضَ العُصفورُ بَلَّلَهُ القَطْرُ (فليس القصد رجلاً مخصوصاً، ولا لئيماً مخصوصاً، ولا عصفوراً، مخصوصاً، لأنك ان قلت: (لا تخالط رجلاً يعمل عمل السفهاء. لقد أمرّ على لئيم يسبني. كما انتفض عصفورٌ بلله القطر) صح). ومثلُ المعرَّفِ بألِ الجنسيّةِ ما أُضيفَ إلى المُعرَّف بِها، كقولِ الشاعر: وَتُضِيءُ في وَجْهِ الظَّلاَمِ مُنيرَةً كَجُمانَةِ الْبَحْرِيِّ سُلَّ نِظامُها أي: كجُمانة بحرِيٍّ سُل نظامها.وشرطُ الجملةِ النعتيّة (كالجملة الحاليّة والجملة الواقعةِ خبراً) أن تكونَ جملةً خبريَّةً (أي: غيرَ طلبيّة)، وان تشتملَ على ضمير يَربِطُها بالمنعوت، سواءُ أكان الضميرُ مذكوراً نحو: (جاءَني رجلٌ يَحملُهُ غلامُهُ)، أم مستتراً، نحو: "جاءَ رجلٌ يحملُ عَصاً، أو مُقدَّراً، كقولهِ تعالى: {واتَّقوا يوماً لا تُجزَى نفسٌ عن نفسٍ شيئاً}، والتقديرُ: (لا تُجزَى فيه). (ولا يقال: (جاءَ رجل أكرمهُ) على أن جملة (أكرمْه) نعت لرجل. ولا يقال: (جاء رجلٌ هل رأيت مثله، أو ليته كريم) لأن الجملة هنا طلبية. وما ورد من ذلك فهو على حذف النعت؛ كقوله: (جاءوا بمذقٍ هل رأيت الذئب قط). والتقدير: (جاءوا بمذقٍ مقولٍ فيه: هل رأيت الذئب). [والمذق بفتح الميم وسكون الذال: اللبن المخلوط بالماء فيشابه لونُه لونَ الذئب]. والنعتُ الشبيهُ بالجملة أن يقعَ الظرفُ أو الجارُّ والمجرورُ في موضع النعت، كما يَقَعانِ في موضع الخبر والحال، على ما تَقدَّمَ، نحو: (في الدار رجلٌ أمامَ الكُرسيّ)، (ورأيتُ رجلاً على حصانهِ). والنعتُ في الحقيقة إنما هو مُتعلِّقُ الظرفِ أو حرفِ الجرّ المحذوفُ. (والأصل: في الدار رجل كائن، أو موجود، أمام الكرسي. رأيت رجلاً كائناً، أو موجوداً، على حصانه). واعلم أنه إذا نُعتَ بمفردٍ وظرفٍ ومجرور وجملةٍ، فالغالب تَأخيرُ الجملة، كقولهِ تعالى: {وقالَ رجلٌ من آلِ فرعون يَكتُمُ إيمانَهُ} وقد تُقدَّمُ الجملة، كقولهِ سبحانهُ: {فسوفَ يأتي اللهُ بقومٍ يُحبّهم ويُحبُّونهُ، أذلَّةٍ على المؤمنينَ، أعزَّةٍ على الكافرين}. 4- النَّعْتُ الْمَقْطوع قد يُقطعُ النعت، عن كونهِ تابعاً لِما قبلهُ في الإعراب، إلى كونه خبراً لمبتدأ محذوف، أو مفعولاً به لفعل محذوف. والغالبُ أن يُفعلَ ذلك بالنعت الذي يُؤتى به لمجرَّدِ المدح، أو الذَّمِّ، أو التَّرحُّمِ، نحو: (الحمدُ للهِ العظيمُ، أو العظيمَ). [الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: هو العظيم. والنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف، والتقدير: أمدح العظيم] ومنهُ قولهُ تعالى: {وامرَأتُهُ حَمّالةَ الحطب}. [حمّالة: مفعول لفعل محذوف، والتقدير: أذم حمالة الحطب] وتقولُ: (أحسنتُ إلى فلانٍ المِسكينُ، أو المسكينَ). وقد يُقطَعُ غيرُهُ مما لم يُؤتَ بهِ لذلك، نحو: (مررتُ بخالد النجارُ أو النجارَ). وتقديرُ الفعل، إن نصبتَ، وأَمدَحُ، فيما أريدَ به المدحُ، (وأَذمُّ)، فيما أُريدَ به الذمُّ، و (أَرحَمُ)، فيما أُريدَ به التُّرحُّمُ، و (أَعني) فيما لم يُرَد به مدحٌ ولا ذمٌّ ولا ترحُّمٌ. وحذفُ المبتدأ والفعل، في المقطوع المراد به المدحُ أو الذمُّ أو الترحم، واجبٌ، فلا يجوزُ إظهارُهما. ولا يُقطَعُ النعتُ عن المنعوت إلا بشرط أن لا يكونَ مُتمّماً لمعناهُ، بحيثُ يستقلُّ الموصوف عن الصفة. فإن كانت الصفة مُتمّمةً معنى الموصوف، بحيثُ لا يَتَّضِحُ إلاّ بها، لم يَجُز قطعُهُ عنها، نحو: (مررتُ بسليمٍ التاجرِ)، إذا كان سليم لا يُعرَفُ إلا بذكر صفته. وإذا تكرّرتِ الصفاتُ، فإن كان الموصوفُ لا يتعيَّنُ إلاّ بها كلّها، وجبَ إتباعها كلّها له، نحو: (مررتُ بخالدٍ الكاتب الشاعرِ الخطيبِ)، إذا كان هذا الموصوف (وهو خالدٌ) يُشاركهُ في اسمه ثلاثةٌ: أحدهم كاتبٌ شاعر، وثانيهم كاتبٌ خطيب. وثالثهم شاعر خطيب. وإن تعيّنَ ببعضها دونَ بعضٍ وجبَ إتباعُ ما يَتعَيَّن بهِ، وجاز فيما عداهُ الإتباعُ والقطعُ. وإن تكرَّرَ النّعتُ، الذي لمجرَّد المدح أو الذمِّ أو الترحُّم، فالأوْلى إما قطعُ الصفاِت كلّها، وإما إتباعها كلّها. وكذا إن تكرَّرَ ولم يكن للمدح أو الَّم. غيرَ أن الاتباع في هذا أولى على كل حال، سواءٌ أتكرَّرت الصفةُ أم لم تكرَّر. |
5- تَتمَّةٌ
أ- الاسمُ العلمُ لا يكونُ صفةً، وإنما يكونُ موصوفاً. ويُوصفُ بأربعةِ أَشياءَ: بالمعرَفِ بألْ، نحو: (جاءَ خليلٌ المجتهدُ) وبالمضاف إلى معرفةٍ، نحو: (جاءَ علي صديقُ خالدٍ)، وباسمِ الاشارةِ، نحو: (أُكرِمُ علياً هذا)، وبالاسم الموصولِ المُصدَّرِ بأل، نحو: (جاءَ عليٌّ الذي اجتهد). ب- المعرَّف بألْ يُوصفُ بما فيه (أَلْ)، وبالمضاف إلى ما فيه (أَلْ)، نحو: (جاءَ الغلامُ المجتهدُ) و (جاءَ الرجلُ صديقُ القومِ). ج- المضافُ إلى العَلمِ يُوصفُ بما يُوصفُ به العلَمُ، نحو: (جاءَ تِلميذُ عليٍّ المجتهدُ. جاءَ تِلميذُ عليٍّ صديقُ خالدٍ. جاءَ تلميذ عليٍّ هذا. جاء تلميذُ عليٍّ الذي اجتهدَ). د- اسمُ الاشارة و (أيُّ) يُوصفانِ بما فيه (ألْ) مثلُ: (جاءَ هذا الرجل)، ونحو: (يا أيُّها الانسانُ). وتوصفُ (أَيُّ) أَيضاً باسم الاشارةِ، نحو: (يا أَيُّها الرَّجلُ). هـ- قال الجمهورُ: من حقِّ الموصوفِ أن يكون أخصَّ من الصفة وأعرفَ منها أو مساوياً لها. لذلك امتنعَ وصفُ المعرَّف بألْ باسم الاشارة وبالمضاف إلى ما كان مُعرَّفاً بغيرِ (أَلْ). فإن جاءَ بعده معرفةٌ غيرُ هذين فليست نعتاً له، بل هي بدل منه أو عطفُ بيانٍ، نحو: (جاءَ الرجلُ هذا، أو الذين كان عندنا، أو صديق علي، أَو صديقُنا). والصحيحُ أَنه يجوزُ أَن يُنعَتَ الأعمُّ بالأخصّ، كما يجوزُ العكسُ، فتوصفُ كلُّ معرفةٍ بكلّ معرفة، كما تُوصفُ كلُّ نكرةٍ بكل نكرة. و- حقُّ الصفةِ أَن تَصحَبَ الموصوفَ. وقد يُحذَفُ الموصوف إذا ظهرَ أَمرُهُ ظُهوراً يُستغنى معه عن ذكره. فحينئذٍ تقومُ الصفةُ مَقامَهُ كقوله تعالى: {أَنِ اعمَلْ سابغاتٍ}، أَي: (دُروعاً سابغاتٍ)، ونحو: (نحنُ فريقانِ: منّا ظَعَنَ ومنا أَقامَ)، والتقدير: (منا فريقٌ ظعنَ، ومنّا فريقٌ أَقامَ) . ومنه قولهُ تعالى أَيضاً: {وعندهم قاصراتُ الطرفِ عينٌ}، والتقديرُ: (نساءٌ قاصراتُ الطّرفِ)، وقولُ الشاعر: أَنا ابْنُ جَلاَ وَطَلاَّعُ الثَّنَايا مَتى أَضَعِ الْعِمامَةَ تَعرِفوني والتقدير: (أَنا ابنُ رجلٍ جلاَ)، أَي: جلا الأمور بأعماله وكشفها. وقد تُحذَفُ الصفةُ، إن كانت معلومةً، كقوله تعالى: {يأخذُ كلَّ سفينة غَصباً}، والتقدير: {يأخذُ كلَّ سفينةٍ صالحةٍ}. ز- إذا تكرَّرت الصفاتُ، وكانت واحدةً، يُستغنى بالتثنية أو الجمع عن التفريق، نحو: (جاءَ عليٌّ وخالدٌ الشاعرانِ، أو عليٌّ وخالدٌ وسعيدٌ الشعراءُ، أو الرجلان الفاضلان. أَو الرجالُ الفضَلاءُ). وان اختلفت وجبَ التفريقُ فيها بالعطفِ بالواو، نحو: (جاءَني رجلانِ: كاتبٌ وشاعرٌ، أَو رجالٌ: كاتب وشاعرٌ وفقيهٌ). ح- الأصلُ في الصفة أَن تكونَ لبيانِ الموصوفِ. وقد تكونُ لمجرَّدِ الثناءِ والتعظيمِ، كالصفاتِ الجاريةِ على اللهِ سبحانهُ، أو لمجرَّد الذّم والتّحقيرِ نحو: (أعوذُ باللهِ من الشيطانِ الرجيمِ) أو للتأكيدِ نحو: (أمسِ الدابرُ لا يعودُ)، ومنه قولهُ تعالى: {فإذا نُفِخَ في الصور نَفخةٌ واحدةٌ}. |
( التَّوكيد )
التَّوكيدُ (أو التأكيدُ): تكريرٌ يُرادُ به تثبيتُ أمرِ المُكرَّر في نفس السامعِ، نحو: (جاءَ عليٌّ نفسُهُ)، ونحو: (جاءَ عليٌّ عليٌّ). وفي التّوكيدِ ثلاثةُ مباحث: 1- التَّوْكيدُ اللَّفْظيُّ التّوكيدُ قسمانِ: لفظيٌّ ومعنويٌّ.فاللفظي: يكونُ بإعادةِ المُؤكّدِ بلفظهِ أو بمرادفه، سواءٌ أكان اسماً ظاهراً، أم ضميراً، أم فعلاً، أم حرفاً، أم جملةً. فالظاهرُ نحو: (جاءَ عليٌّ عليٌّ). والضمير نحو: (جئتَ أنتَ. وقُمنا نحنُ). ومنه قوله تعالى: {يا آدمُ اسكُنْ أنتَ وزَوجُكَ الجنّةَ} [أنت: ضمير منفصل في محل رفع توكيد للفاعل المستتر في اسكن] والفعلُ نحو: (جاءَ جاءَ عليٌّ). والحرفُ نحو: (لا، لا أبوحُ بالسرّ). والجملةُ نحو: (جاءَ عليٌّ، جاءَ عليٌّ، وعليٌّ مجتهدٌ، عليٌ مجتهدٌ). والمرادفُ نحو: (أتى جاءَ عليٌّ). وفائدةُ التوكيدِ اللفظيِّ تقريرُ المؤكدِ في نفسِ السامعِ وتمكينُهُ في قلبِهِ، وإزالةُ ما في نفسهِ من الشُّبهة فيه. (فانك ان قلت: (جاءَ علي)، فان اعتقدَ المخاطب أن الجائي هو لا غيره ادعيت بذلك وأن أنكرَ، أو ظهرت عليه دلائل الانكار، كرّرت لفظ (علي) دفعاً لإنكاره، أو ازالة للشبهة التي عرضت له. وان قلت: (جاءَ علي، جاء علي)، فانما تقول ذلك اذا أنكر السامع مجيئه، أو لاحت عليه شبهةٌ فيه، فتثبت ذلك في قلبه وتُميط عنه الشبهة). 2- التَّوْكيدُ الْمَعنَوِيُّ التّوكيدُ المعنوي: يكونُ بذكرِ (النّفسِ أو العينِ أو جميع أو عامّةٍ أو كلاَ أو كلتا، على شرطِ أن تُضاف هذه المؤكّداتُ إلى ضميرٍ يُناسِبُ المؤكّدَ، نحو: (جاءَ الرجلُ عينُه، والرجلانِ أنفُسهُما. رأيتُ القومَ كلّهم. أحسنتُ إلى فُقراءِ القريةِ عامَّتِهم. جاءَ الرجلانِ كلاهما، والمرأتانِ كلتاهما). وفائدةُ التوكيدِ بالنفس والعينِ رفعُ احتمالِ أن يكون في الكلام مجازٌ أو سهوٌ أو نسيانٌ. (فان قلت: (جاء الأميرُ) فربما يتوهم السامع أن اسناد المجيء إليه، هو على سبيل التجوّز أو النسيان أو السهو، فتؤكده بذكر النفس أو العين، رفعاً لهذا الاحتمال، فيعتقد السامع حينئذ أن الجائي هو لا جيشه ولا خدمه ولا حاشيته ولا شيء من الأشياء المتعلقة به). وفائدةُ التوكيد بكلٍّ وجميعٍ وعامَّةٍ الدلالةُ على الاحاطة والشُّمول. (فاذا قلت: (جاء القوم)، فربما يتوهم السامع أن بعضهم قد جاء، والبعض الآخر قد تخلّف عن المجيء. فتقول: (جاء القوم كلهم)، دفعاً لهذا التوهم. لذلك لا يقال: (جاء علي كله)، لأنه لا يتجزأ. فاذا قلت: (اشتريت الفرس كله) صح، لأنه يتجزأ من حيث المبيع). وفائدةُ التوكيد بكِلا وكِلتا اثباتُ الحُكم للاثنين المُؤكّدينِ معاً. (فاذا قلت: (جاء الرجلان)، وأنكر السامع أن الحكم ثابت للاثنين معاً، أو توهم ذلك، فتقول: (جاء الرجلان كلاهما)، دفعاً لإنكاره، أو دفعاً لتوهمه أن الجائي أحدهما لا كلاهما. لذلك يمتنع أن يقال: (اختصم الرجلان كلاهما، وتعاهد سليم وخالد كلاهما)، بل يجب أن تحذف كلمة (كلاهما)، لأن فعل المخاصمة والمعاهدة لا يقع إلا من اثنين فأكثر، فلا حاجة الى توكيد ذلك، لأنّ السامع لا يعتقد ولا يتوهم أنه حاصل من أحدهما دون الآخر). 3- تتِمَّةٌ أ- إذا أُريدَ تقوية التوكيدِ يُؤتى بعدَ كلمة (كله) بكلمة (أجمع)، وبعدَ كلمةِ (كلها) بكلمة (جمعاء)، وبعدَ كلمة (كلهم) بكلمة (أجمعينَ)، وبعدَ كلمة (كلهنَّ) بكلمة (جُمَع)، تقولُ: (جاءَ الصفُّ كلُّهُ أجمعُ) و (جاءَت القبيلةُ كلُّها جمعاءُ)، قال تعالى: {فسجدَ الملائكةُ كلُّهُم أجمعونَ} وتقولُ: (جاءَ النساءُ كلُّهنَّ جُمَعُ). وقد يُؤكدُ بأجمعَ وجمعاءَ وأجمعينَ وجُمَعَ، وإن لم يَتقدَّمهنَّ لفظ (كلّ) ومنه قوله تعالى: {لأغوينَّهُم أجمعينَ}. ب- لا يجوزُ تثنيةُ (أجمع وجمعاءَ)، استغناءً عن ذلك بِلَفظيْ (كِلا وكلتا) فيقالُ: (جاءا جمعانِ) ولا (جاءَتا جمعاوانِ) كما استَغنوا بتثنيةِ (سِيٍّ) عن تثنية (سواءٍ)، فقالوا: (زيدٌ وعمرٌو سِيّانِ في الفضيلة)، ولم يقولوا: (سواءَانِ). ج- لا يجوزُ توكيدُ النكرة، إلا إذا كان توكيدُها مفيداً، بحيثُ تكونَ النكرةُ المؤكَّدةَ محدودةً، والتوكيدُ من ألفاظ الإحاطة والشُّمول نحو: (اعتكفتُ أُسبوعاً كلَّهُ). ولا يقالُ: (صُمتُ دهراًَ كلَّهُ)، ولا (سِرتُ شهراً نفسَهُ)، لأنّ الأول مُبهَمٌ، والثاني مؤكدٌ بما لا يفيدُ الشُّمولَ. د- إذا أُريدَ توكيدُ الضميرِ المرفوعِ، المُتَّصلِ أو المستتر، بالنفس أو العين؛ وجبَ توكيدُهُ أوَّلاً (وكذا إن كان التوكيدُ غيرَ النّفس والعين)، نحو: (قاموا كلُّهم. وسافرنا كلُّنا). هـ- الضميرُ المرفوعُ المنفصلُ يُؤكد به كل ضميرٍ مُتّصل، مرفوعاً كان، نحو: (قمتَ أنت)، أَو منصوباً، نحو: (أَكرمتكَ أَنتَ)، أَو مجروراً، نحو: (مررتُ بكَ أنتَ). ويكون في محلِّ رفع، إن أُكِّدَ به الضميرُ المرفوعُ، وفي محلِّ نصبٍ، إن أُكِّدَ به الضميرُ المنصوب، وفي محلِّ جرٍّ، إن أُكِّدَ به الضميرُ المجرورُ. و- يُؤكدُ المُظهَرُ بمثلهِ، لا بالضمير، فيقال: (جاءَ عليٌّ نفسُهُ). ولا يُقالُ: (جاءَ عليُّ هوُ). والمُضمَرُ يُؤكدُ بمثله وبالمُظهَر أيضاً. فالأوَّلُ نحو: (جئتَ أنتَ نَفسُكَ)، والثاني نحو: (أحسنتُ إليهم أنفسِهم). ز- إن كان المؤكَّدُ بالنَّفسِ أو العين مجموعاً جمعتَهما، فتقولُ: (جاءَ التلاميذُ أَنفسُهم، أَو أَعينُهم). وإن كان مثنًّى فالأحسنُ أن تجمعهما، نحو: (جاءَ الرجلانِ أَنفسُهما، أَو أَعينهما). وقد يجوزُ أَن يُثنيَّا تَبعاً لِلَفظِ المؤكدِ، فتقولُ: (جاءَ الرَّجلانِ نَفساهما أو عيناهما) وهذا أُسلوبٌ ضعيفٌ في العربيّة. ح- يجوزُ أَن تُجرَّ (النفسُ) أَو (العينُ) بالباءِ الزائدةِ، نحو: (جاءَ عليٌّ بنفسهِ). والأصلُ: (جاءَ عليٌّ نفسُهُ)، فتكونُ (النفس) مجرورة لفظاً بالباءِ الزائدة، مرفوعةً محلاً، لأنها توكيد للمرفوع، وهو (عليٌّ). |
( البدل )
البَدَلُ: هو التّابعُ المقصودُ بالحُكمِ بلا واسطةٍ بينهُ وبينَ متبوعهِ نحو: (واضعُ النحوِ الإمامُ عليٌّ). (فعليٌّ: تابع للإمام في إعرابه. وهو المقصود بحكم نسبة وضع النحو إليه. والإمام انما ذكر توطئة وتمهيداً له، ليستفاد بمجموعهما فضلُ توكيد وبيان، لا يكون في ذكر أحدهما دون الآخر. فالإمام غير مقصود بالذات، لأنك لو حذفته لاستقلّ (عليٌّ) بالذكر منفرداً، فلو قلت: (واضع النحو عليٌّ)، كان كلاماً مستقلاً. ولا واسطة بين التابع والمتبوع. أما ان كان التابع مقصوداً بالحكم، بواسطة حرف من أحرف العطف، فلا يكون بدلاً بل هو معطوف، نحو: (جاء علي وخالد) وقد خرج عن هذا التعريف النعت والتوكيد أيضاً، لأنهما غير مقصودين بالذات وانما المقصود هو المنعوت والمؤكد). وفي البدل مبحثهان: 1- أَقْسامُ الْبَدَل البَدلُ أربعةُ أقسامٍ: البدلُ المطابِقُ (ويُسمّى أيضاً بَدَلَ الكُل من الكل)، وبَدلُ البعضِ من الكلِّ، وبدلُ الاشتمالِ، والبدلُ المُبايِنُ. فالبدلُ المُطابقُ (أو بَدَلُ الكل من الكُلِّ): هو بَدَلُ الشيءِ مِمّا كان طَبقَ معناهُ، كقولهِ تعالى: {إهدنِا الصراطَ المستقيمَ، صِراطَ الذينَ أنعمت عليهم}. فالصراطُ المُستقيم وصِراطُ المُنعَمِ عليهم مُتطابقانِ معنًى، لأنهما، كلَيهما، بدلانِ على معنًى واحدٍ. وبدلُ البعضِ من الكُل: هو بدل الجزء من كُلِّهِ، قليلاً كان ذلكَ الجزءُ، أو مُساوياً للنّصفِ، أو أكثرَ منهُ، نحو: (جاءتِ القبيلةُ رُبعُها. أو نصفُها، أو ثُلُثاها)، ونحو: (الكلمةُ ثلاثة أقسامٍ: اسمٌ وفعلٌ وحرف)، ونحو: (جاءَ التلاميذُ عشرونَ منهم). وبدلُ الاشتمالِ: هو بدلُ الشيءِ مِمّا يشتملُ عليه، على شرط أن لا يكونَ جزءاً منه، نحو: (نفعني المُعلِّمُ عِلمُهُ. أحببتُ خالداً شجاعتَهُ. أُعجِبتُ بعليٍّ خُلقهِ الكريمِ). فالمعلِّمُ يشتملُ على العلم، وخالدٌ يشتملُ على الشجاعة، وعليٌّ يشتملُ على الخُلُق. وكلٌّ من العلم والشجاعة والخُلق، ليس جزءاً مِمّن يشتملُ عليه. ولا بُدَّ لبدلِ البعضِ وبدلِ الاشتمالِ من ضميرٍ يربطُهما بالبدل، مذكوراً، كان، كقوله تعالى: {ثمَّ عَمُوا وصَمُّوا، كثيرٌ منهم}، وقولهِ: {يَسألونكَ عن الشّهرِ الحرامِ. قِتالٍ فيه}، أو مُقدَّراً، كقوله سبحانهُ: {وللهِ على النّاس حِجُّ البيت من استطاعَ إليه سبيلاً}، وقولهِ: {قُتِلَ أصحابُ الأخدودِ، النّارِ ذاتِ الوَقود}. والبَدَلُ المباينُ: هو بدلُ الشيءِ مِمّا يُباينُهُ، بحيثُ لا يكون مطابقاً لهُ، ولا بعضاً منه، ولا يكونُ المُبدَلُ منه مُشتملاً عليه. وهو ثلاثةُ أنواعٍ: بدَلُ الغَلَطِ، وبَدلُ النسيان، وبدلُ الاضراب. فبَدَلُ الغلطِ: ما ذكرَ ليكونَ بدلاً من اللفظ الذي سبقَ إليه اللسانُ، فذكرَ غلطاً، نحو: (جاءَ المعلِّمُ، التلميذُ)، أردتَ أن تذكرَ التلميذ، فسبقَ لسانُكَ، فذكرتَ المعلمَ غلطاً، فتَذكَّرتَ غَلَطَكَ، فأبدلتَ منه التلميذَ. وبدلُ النسيان: ما ذُكرَ ليكونَ بدلاً من لفظٍ تَبيَّنَ لكَ بعدَ ذكرهِ فسادُ قصدهِ، نحو: (سافرَ عليٌّ إلى دِمَشقَ، بَعلبكَّ)، توهمتَ أنه سافرَ إلى دمشقَ، فأدرككَ فسادُ رأيك، فأبدلتَ بعلبكَّ من دمشقَ. فبدلُ الغلطِ يتعلَّقُ باللسانِ، وبدلُ النسيانِ يَتعلَّق بالجَنان. وبَدلُ الاضراب: ما كان في جملةٍ، قصدُ كلٍّ من البلد والمُبدَل منه فيها صحيحٌ، غيرَ أنَّ المتكلم عدلَ عن قصد المُبدَلِ منه إلى قصدِ البدل، نحو: (خُذِ القلمَ، الوَرَقةَ)، أمرتَهُ بأخذ القلم، ثم أضربتَ عن الأمر بأخذهِ إلى أمرهِ بأخذ الورقة، وجعلتَ الأوَّل في حكم المترُوك. والبَدَلُ المُباينُ بأقسامهِ لا يقعُ في كلامِ البُلغَاءِ. والبليغُ إن وقع في شيءٍ منها، أتى بين البدل والمبدَل منه بكلمةِ: (بَلْ)، دلالةً على غلطهِ أو نسيانهِ أو إِضرابه. 2- أَحكامٌ تَتَعَلَّقُ بالْبَدَل أ- ليسَ بمشروطٍ أن يتطابَقَ البدلُ والمُبدَل منه تعريفاً وتنكيراً. بل لكَ أن تُبدِلَ أيَّ النوعينِ شئتَ من الآخر، قال تعالى: {إلى صراط مُستقيم، صراطِ الله}، فأبدلَ (صراط الله)، وهو معرفةٌ، من (صراطٍ مُستقيم)، وهو نكرة، وقالَ: {لنفسعاً بالناصيةِ، ناصيةٍ كاذبةٍ خاطئةٍ}، فأبدلَ (ناصية)، وهي نكرةٌ، منَ (الناصية)، وهي معرفةٌ. غيرَ أنه لا يَحسُنُ إِبدالُ النكرة من المعرفة إلا إذا كانت موصوفةً كما رأيتَ في الآية الثانية. ب- يُبدَلُ الظاهرُ من الظاهرِ، كما تقدَّمَ. ولا يُبدَلُ المُضمَر من المُضمَر. وأما مثلُ: (قُمتَ أنتَ. ومررتُ بكَ أنت)، فهو توكيد كما تقدَّم. ولا يُبدلُ المضمرُ من الظاهر على الصحيح. قال ابنُ هشام: وأمّا قولهم: (رأيتُ زيداً أياهُ)، فمِنْ وضعِ النحويينَ، وليس بمسموع. ويجوز إبدالُ الظاهر من ضميرِ الغائبِ كقولهِ تعالى: {وأسَرُّوا النّجوى، الذينَ ظلموا} فأبدلَ (الذينَ) من (الواو)، التي هي ضميرُ الفاعلِ. ومن ضمير المخاطبِ والمتكّلم، على شرط أن يكونَ بدلَ بعضٍ من كلٍّ، أو بدلَ اشتمالٍ، فالأول كقوله تعالى: {لَقد كانَ لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ، لِمَنْ كان يَرجو اللهَ واليومَ الآخرَ} فأبدلَ الجارَّ والمجرورَ، وهما "لِمن" من الجارّ والمجرورِ المُضمر وهما "لكم" وهو بدلُ بعضٍ من كلٍّ، لأنَّ الأسوةَ الحسنةَ في رسولِ اللهِ ليست لكلِّ المخاطبين، بل هيَ لمن كان يرجو اللهَ واليومَ الآخرَ منهم. والثاني كقولك: (أعجبتني، علمُكَ)، فعلمُك بدلٌ من (التاءِ)، التي هي ضميرُ الفاعل، وهو بدلُ اشتمال، ومنه قول الشاعر: بَلَغْنا السَّماءَ مَجْدُنا وسَناوُّنا وإِنَّا لَنَرْجُو فَوْقَ ذلِكَ مَظْهرا فأبدلَ (مجدنا) من (نا)، التي هي ضمير الفاعلِ، وهو بدلُ اشتمال أيضاً. ج- يُبدَلُ كلٌّ من الاسمِ والفعلِ والجملة من مثله. فإبدالُ الاسمِ من الاسمِ قد تقدَّم. وإبدالُ الفعل من الفعل كقوله تعالى: {ومَنْ يفعلْ ذلكَ يَلق أثاماً، يُضاعفْ له العذابُ}، أبدل (يُضاعف) من (يلقَ). وإبدالُ الجملة من الجملة كقوله تعالى: {أمَدَّكم بما تَعلمونَ، أمدَّكم بأنعامٍ وبنينَ}، فأبدل جملة (أمدَّكم بأنعامٍ وبَنينَ) من جملة (أمدَّكم بما تَعلمون). وقد تُبدَلُ الجملةُ من المُفرَدِ، كقول الشاعر: ِلى اللهِ أَشْكُو بِالْمَدينَةِ حاجةً وبالشَّامِ أُخْرى، كَيْفَ يَلْتَقِيانِ؟! أبدلَ (كيفَ يَلتقيانِ) من حاجةٍ وأخرى، والتقديرُ الإعرابيُّ: (أشكو هاتينِ الحاجتينِ، تَعذُّرَ التقائهما). والتقديرُ المعنويُّ: (أشكو إلى الله تَعَذُّرَ التقاءِ هاتينِ الحاجتينِ). د- إذا أُبدِلَ اسمٌ من اسم استفهام، أو اسم شرط، وجب ذكرُ همزةِ الاستفهام، أو (إن) الشرطيّةِ معَ البدلِ، فالأولُ نحو: (كم مالُكَ؟ أعشرونَ أم ثلاثون؟. من جاءَك؟ أعليٌّ أم خالد؟. ما صنعتَ؟ أخيراً أم شرًّا؟). [كم: اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم. ومالك: مبتدأ مؤخر. وعشرون: بدل من كم][ من: اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، وجملة (جاءك) خبره. وعلي: بدل من (مَن) الاستفهامية][ ما: اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم لصنعت، والهمزة في أخيراً: حرف استفهام، وخيراً بدل من (ما) الاستفهامية] والثاني نحو: (مَنْ يَجتهدْ، إنْ عليٌّ، وإن خالدٌ، فأكرمهُ. ما تَصنعْ، إنْ خيراً، وإنْ شرًّا، تُجزَ بهِ. حيثما تنتظرني، إنْ في المدرسة، وإن في الدَّار أُوافِك). |
( عَطفُ البيانِ )
عطفُ البيانِ: هو تابعٌ جامدٌ، يُشبهُ النّعتَ في كونه يكشفُ عن المراد كما يكشفُ النّعتُ. ويُنزّلُ من المتبوع مَنزلةَ الكلمةِ الموضّحة لكلمةٍ غريبةٍ قبلها، كقول الراجز: (أقسمَ باللهِ أبو حَفصٍ عُمَر). (فعمر: عطف بيان على (أبو حفص)، ذُكر لتوضيحه والكشف عن المراد به، وهو تفسير له وبيان، وأراد به سيدنا عمر بن الخطاب، رضي الله عنه). وفائدته إيضاحُ متبوعهِ، إن كان المتبوعُ معرفةً، كالمثال السابق، وتخصيصه إن كان نكرةً، نحو: (اشتريتُ حُلِيّاً: سِواراً). ومنه قولهُ تعالى: {أو كفّارةٌ: طَعامُ مَساكينَ}. ويجبُ أن يُطابقَ متبوعَهُ في الإعرابِ والإفرادِ والتّثنيةِ والجمع والتّذكير والتأنيث والتعريفِ والتنكير. ومن عطفِ البيان ما يقعُ بعد (أَيْ وأنْ) التّفسيريتينِ. غيرَ أنَّ (أَيْ) تُفسّرُ بها المُفرداتُ والجُمَلُ، و (أَنْ) لا يفسَّر بها إلا الجُمل المشتملةُ على معنى القول دونَ أحرفهِ. تقول: (رأيتُ ليثاً، أيأَسداً) و (أشرتُ إليهِ، أي: اذهبْ). وتقولُ: (كتبتُ إليهِ، أنْ: عَجَّلْ بالحضور). وإذا تضمّنتْ (إذا) معنى (أي) التفسيريَّةِ، كانت حرفَ تفسيرٍ مثلها، نحو: (تقولُ: امتطيتُ الفرسَ: إذاركبتَه). وسيأتي لهذا البحث فضلُ بيانٍ في باب الحروف. أَحكامٌ تَتَعَلَّقُ بِعَطْفِ البَيَان أ ـ يجبُ أن يكون عطفُ البيان أوضح من متبوعهِ وأشهر، وإلا فهو بدلٌ نحو: (جاءَ هذا الرجل)، فالرجلُ. بدلٌ من اسم الإشارة، وليس عطفَ بيان، لأنَّ اسمَ الإشارةِ أوضح من المعرَّف بأل. وأجازَ بعضُ النّحويين أن يكونَ عطفَ بيان، لأنهم لا يشترطون فيه أن يكون أوضعَ من المتبوع. وما هو بالرأي السديد، لأنه إنما يُؤتى به للبيان والمبيِّنُ يجبُ أن يكونَ أوضحَ من المُبيَّن. ب- الفرقُ بين البدلِ وعطف البيان أنَّ البدلَ يكونُ هو المقصودَ بالحكم دُون المُبدلِ منه. وأمّا عطفُ البيان فليس هو المقصودَ، بل إنَّ المقصود بالحُكم هو المتبوعُ، وإنما جيءَ بالتابع (أي عطف البيان) تَوضيحاً له وكشفاً عن المراد منه. ج- كلُّ ما جازَ أن يكونَ عَطفَ بيانٍ جازَ أن يكونَ بدلَ الكلِّ من الكلِّ، إذا لم يُمكن الاستغناءُ عنه أو عن متبوعهِ، فيجبُ حينئذٍ أن يكون عطفَ بيان. فمثالُ عدمِ جواز الاستغناء عن التابع قولكَ: "فاطمةُ جاء حسينٌ أخوها"، لأنكَ لو حذفتَ "أخوها" من الكلام لفسد التركيبُ. ومثالُ عدَم جواز الاستغناءِ عن المتبوعِ قولُ الشاعر: أَنا ابنُ التَّارِكِ الْبَكْرِيِّ بِشْرٍ عَلَيْهِ الطَّيْرُ تَرْقُبُهُ وقُوعا فبشر: عطفُ بيانٍ على (البكري)، لا بدلٌ منه، لأنكَ لو حذفت المتبوعَ، وهو (البكري) لوجب أن تضيفَ (التّارك) إلى (بشر)، وهو ممتنعٌ، لأنّ إضافةَ ما فيه (ألْ) إذا كان ليس مُثنى أو مجموعاً جمعَ مذكرٍ سالماً، إلى ما كان مُجرَّداً عنها غيرُ جائزة، كما علمتَ في مبحث الإضافة. ومن ذلك قول الآخر: أَيا أَخَوَيْنا، عَبْدَ شَمْسٍونَوْفَلاً أُعِيذُ كُما بِاللهِ أَنْ تُحْدِثا حَربا فعبدَ شمس: معطوفٌ على (أخوينا) عطفَ بيان، و (نوفلاً) : معطوف بالواو على (عبد شمس)، فهو مثله عطف بيان. ولا تجوزُ البدليَّةُ هنا، لأنه لا يُستغنى عن المتبوع، إذ لا يصحُّ أن يقال (أيا عبدَ شمسٍ ونوفلاً)، بل يجبُ أن يقال: (ونوفلُ) بالبناءِ على الضم، لأن المنادى إذا عُطف عليه اسمٌ مُجرَّد من (ألْ) والإضافة، وجبَ بناؤه، لأنك إن ناديتَهُ كان كذلك، نحو: (يا نوفلُ). كما عرفتَ ذلك في مبحث (أحكام توابع المنادى). ومن ذلكَ أن تقول: (يا زيدُ الحارث). فالحارث: عطفُ بيان على (زيد). ولا يجوز أن يكون بدلاً منه، لأنك لو حذفتَ المتبوع، وأحللتَ التابعَ محلَّهُ، لقلتَ: (يا الحارثُ). وذلك لا يجوز، لأنَّ (يا) و (أل) لا يجتمعان إلا في لفظ الجلالة. د- يكونُ عطفُ البيان جملةً، كقوله تعالى: {فَوَسوسَ إليه الشيطانُ قال يا آدمُ هل أدُلُّك على شجرةِ الخُلدِ ومُلكٍ لا يَبلَى}، فجملةُ: (قال يا آدمُ هل أدُلُّك): عطفُ بيان على جملة: (فوسوَس إليه الشيطان). وقد منعَ النُّحاة عطفَ البيانِ في الجُمل، وجعلوه من باب البدل. وأثبتهُ علماء المعاني، وهو الحقُّ. ومنه قولهُ تعالى أيضاً: {ونُودُوا أن تِلكُمُ الجنةُ}، فجملة: (أن تلكُمُ الجنةُ) : عطف بيانٍ على جملة: (نُودوا). http://www.arab-unity.net/forums/3ei...ser_online.gif http://www.arab-unity.net/forums/3ei...reputation.gif http://www.arab-unity.net/forums/3ei...ons/report.gif http://www.arab-unity.net/forums/3ei...c/progress.gif |
(المعطوفُ بالحرف )
المعطوفُ بالحرف: هو تابعٌ يتوسّط بينه وبينَ متبوعه حرفٌ من أحرف العطفِ، نحو: (جاءَ عليٌّ وخالدٌ. أكرمتُ سعيداً ثم سليماً). ويُسمّى العطفُ بالحرف (عَطفَ النَّسَقِ) أيضاً. وفيه ثلاثةُ مباحث: 1- أَحْرُفُ العَطْفِ احرفُ العَطفِ تسعةٌ. وهي: (الواو والفاءُ وثُمَّ وحتى وأَو وأَم وبَلْ ولا ولكنْ). فالواوُ والفاءُ وثمَّ وحتَّى: تُفيدُ مشاركةَ المعطوفِ للمعطوف عليه في الحُكم والإعرابِ دائماً.وأَو، وأَمْ، إن كانتا لغير الإضراب على المعطوفِ عليه إلى المعطوف، فكذلك، نحو: (خُذ القلمَ أو الورقةَ)، ونحو: (أخالدٌ جاءَ أم سعيدٌ؟). وإن كانتا للاضرابِ فلا تفيدانِ المشاركةَ بينهما في المعنى، وإنما هما التَّشريك في الإعراب فقطْ، نحو: (لا يَذهبْ سعيدٌ أو لا يَذهبْ خالدٌ)، ونحو: (أذهبَ سعيدٌ؟! أم أذهبَ خالدٌ؟). وبَل: تُفيدُ الاضرابَ والعدولَ عن المعطوف عليه إلى المعطوف، نحو: (جاءَ خالدٌ، بَل عليٌّ). ولكنْ: تُفيدُ الاستدراكَ، نحو: (ما جاءَ القومُ، لكنْ سعيدٌ). ولا: تفيدُ معَ العطفِ نفيَ الحكم عمّا قبلها وإثباتَهُ لِمَا بعدَها نحو: (جاءَ عليٌّ لا خالدٌ). 2- مَعاني أَحرُفِ الْعَطْفِ أ- الواو: تكونُ للجمع بين المعطوفِ والمعطوف عليه في الحُكم والاعرابِ جمعاً مطلقاً، فلا تُفيدُ ترتيباً ولا تعقيباً. فإذا قلتَ: (جاءَ عليٌّ وخالدٌ)، فالمعنى أنهما اشتركا في حكم المجيء، سواءٌ أكان عليٌّ قد جاءَ قبل خالد، أم بالعكس، أم جاءَا معاً، وسواءٌ أكان هناك مُهلةٌ بين مجيئهما أم لم يكن. ب- الفاءُ: تكونُ للترتيب والتعقيب. فإذا قلتَ: (جاء عليّ فسعيدٌ). فالمعنى أنَّ عليّاً جاءَ أوَّلُ، وسعيداً جاءَ بعدَهُ بلا مُهلةٍ بينَ مجيئهما. ج- ثمَّ: تكون للتَّرتيبِ والتَّراخي. فإذا قلتَ: (جاءَ عليٌّ ثمَّ سعيدٌ)، فالمعنى أن (عليّاً) جاءَ أولُ، وسعيداً جاءَ بعدهُ، وكان بينَ مجيئهما مُهلة. د- حتى: العطفُ بها قليلٌ. وشرطُ العطفِ بها أن يكونَ المعطوفُ اسماً ظاهراً، وأن يكون جزءاً من المعطوف عليهِ أو كالجزء منه،وأن يكون أشرفَ من المعطوف عليه أو أخسَّ منه، وأن يكونَ مفرداً لا جملةً، نحو: (يموتُ الناسُ حتى الأنبياءُ. غلبكَ الناسُ حتى الصبيانُ. أعجبني عليٌّ حتى ثوبُهُ). واعلم أنَّ (حتى) تكونُ أيضاً حرف جرّ، كما تقدم. وتكون حرف ابتداء، فما بعدها جملةٌ مُستأنفة، كقول الشاعر: فَما زالَت الْقَتْلى تَمُجُّ دِماءَها بِدِجْلَةَ، حَتَّى ماءُ دِجْلَةَ أَشْكَلُ هـ- أو: إن وقعت بعدَ الطَّلب، فهي إمّا للتَّخيير، نحو: (تَزوَّجْ هنداً أو أختها)، وإما للاباحة، نحو: (جالس العلماءَ أو الزُهّادَ). وإما للاضراب، نحو: (إذهبْ إلى دِمَشقَ، أو دَع ذلكَ، فلا تَذهب اليومَ)، أي: بَلْ دَعْ ذلك، أُمرتَهُ بالذهاب، ثمَّ عدلتَ عن ذلك. والفرق بينَ الإباحة والتَّخيير، أن الاباحةَ يجوز فيها الجمعُ بين الشيئين، فإذا قلتَ: (جالس العلماءَ أو الزُّهّادَ)، جاز لك الجمعُ بين مجالسةِ الفريقينِ، وجاز أن تُجالسَ فريقاً دُون فريق. وأما التّخييرُ فلا يجوزُ فيه الجمعُ بينهما، لأن الجمعَ بينَ الأختين في عقد النكاح غير جائز. وإن وقعت (أو) بعد كلامٍ خبريٍّ، فهي إمّا للشّك، كقوله تعالى: {قالوا لبِثنا يوماً أو بعَض يومٍ}، وإمّا للابهام، كقوله عزَّ وجل: {وإنا وإياكم لَعلَى هُدًى أو في ضلالٍ مُبين}. ومنه قولُ الشاعر: نَحْنُ أَوْ أَنْتُمُ الأُلى أَلِفُوا الحَقَّ فُبُعْداً لِلمُبْطِلينَ وَسُحْقا وإما للتقسيم، نحو: (الكلمةُ أسمٌ أَو فعلٌ أو حرفٌ)، وإِمّا للتّفصيل بعدَ الإجمال، نحو: (اختلفَ القومُ فيمن ذهب، فقالوا: ذهب سعيدٌ أَو خالدٌ أو عليٌّ). ومنه قولهُ تعالى: {قالوا ساحرٌ أو مجنونٌ} أي: بعضُهم قال: كذا، وبعضهم قال: كذا. وإمّا للاضراب بمعنى (بل)، كقوله تعالى: {وأرسلناهُ إلى مِئَة ألفٍ، أو يزيدونَ}. أي: بل يزيدون، ونحو: (ما جاءَ سعيد، أو ما جاء خالدٌ). |
ز- أم: على نوعين: مُتّصلةٍ ومنقطعة.
فالمتصلةُ: هي التي يكونُ ما بعدَها متّصلاً بما قبلَها، ومشاركاً له في الحكم وهي التي تقعُ بعدَ همزةِ الاستفهام أو همزةِ التسويةِ، فالأولُ كقولك: (أَعليٌّ في الدار أم خالدٌ؟)، والثاني كقوله تعالى: {سواءٌ عليهم أَأَنذَرتَهُم أَم لم تُنذِرهم}. وإنما سُميت متصلةً لأنَّ ما قبلَها وما بعدَها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. و (أم) المنقطعةُ: هي التي تكونُ لقطعِ الكلام الأول واستئناف ما بعدَه. ومعناها الإضرابُ، كقوله تعالى: {هل يستوي الأعمى والبصيرُ؟ أم هل تستوي الظُّلماتُ والنُّورُ؟ أم جعلوا للهِ شُرَكاء}. والمعنى: (بل جعلوا لله شركاء)، قال الفرَّاءُ: (يقولون: هل لكَ قِبَلنا حقٌّ؟ أم أنتَ رجلٌ ظالمٌ) يريدون: (بل أنت رجلٌ ظالمٌ) وتارة تَتضمَّنُ معَ الإضراب استفهاماً إنكاريّاً، كقوله تعالى: {أَم لهُ البناتُ ولكمُ البَنون؟}. ولو قَدَّرت (أم) في هذه الآية للاضراب المحضِ، من غير تَضَمُّنِ معنى الانكار، لزمَ المُحال. ح- بَل: تكونُ للاضراب والعُدول عن شيءٍ إلى آخرَ، إن وقعت بعدَ كلام مُثبَتٍ، خبراً أَو أَمراً، وللاستدراك بمنزلة (لكنْ)، إن وقعت بعدَ نفيٍ أو نهي. ولا يُعطَفُ بها إلا بشرط أَن يكونَ معطوفُها مفرداً غيرَ جملةٍ. وهي، إن وقعت بعدَ الإيجاب أو الأمرِ، كان معناها سَلبَ الحكم عما قبلَها، حتى كأنهُ مسكوتٌ عنه، وجعلَهُ لِمَا بعدَها، نحو: (قام سليمٌ، بل خالدٌ) ونحو: (لِيَقُمْ عليٌّ. بل سعيدٌ). وإن وقعت بعد النفي أو النهي، كان معناها إثباتَ النفي أو النّهي لِمَا قبلها وجعلَ هذه لِمَا بعدَها، نحو: (ما قام سعيدٌ بل خليلٌ)، ونحو: (لا يَذهبْ سعيدٌ بل خليلٌ). فإن تلاها جملةٌ لم تكن للعطفِ، بل تكونُ حرفَ ابتداءٍ مُفيداً للاضراب الإبطالي أو الإضراب الانتقالي. فالأولُ كقولهِ تعالى: {وقالوا اتَّخذَ الرحمنُ ولداً، سبحانَهُ، بَل عِبادٌ مُكرَمُون}، أي: بل هُم عبادٌ، وقولهِ: {أو يقولونَ بهِ جِنَّةٌ، بل جاءهم بالحق}. والثاني كقولهِ تعالى: {قد أَفلحَ من تَزكّى، وذكرَ اسمَ رَبهِ فَصَلَّى، بل تُؤثرونَ الحياةَ الدُّنيا}، وقولهِ: {وَلدَينا كتابٌ يَنطِقُ بالحق وهُم لا يُظلمونَ، بل قُلُوبهم في غَمرة}. وقد تُزادُ قبلها (لا)، بعد إثباتٍ أَو نفيٍ، فالأولُ كقول الشاعر: وَجْهُكِ الْبَدْرُ، لا، بل الشَّمْسُ، لوْ لَمْ يُقْضَ لِلشَّمْسِ كَسْفَةٌ أو أُفولُ والثاني كقول الآخر: وَما هَجَرْتُكِ، لا، بَلْ زادَني شَغَفاً هَجَرٌ وبُعْدُ تُراخٍ لا إِلى أجلِ ط- لكن: تكونُ للاستدراكِ، بشرطِ أَن يكون معطوفُها مُفرداً، أي غيرَ جُملة، وأن تكونَ مسبوقةً بنفي أو نهي، وأن لا تقترنَ بالواو، نحو: (ما مررتُ برجلٍ طالحٍ، لكنْ صالحٍ)، ونحو: (لا يَقُمْ خليلُ، لكنْ سعيدٌ). فإن وقعت بعدَها جملةٌ، أو وقعت هي بعدَ الواو، فهي حرفُ ابتداءٍ، فالأول كقول الشاعر: إنَّ ابنَ وَرْقاءَ لا تُخْشى بَوادِرُهُ لكِنْ وَقائِعُهُ في الحَرْبِ تُنتَظَرُ والثاني كقولهِ تعالى: {ما كانَ محمد أبا أحدٍ من رجالكم، ولكن رسولَ اللهِ وخاتمَ النّبيينَ}، أي: لكنْ كان رسولَ الله. فرسول: منصوبٌ لأنه خبر (كان) المحذوفة، وليس معطوفاً على (أبا). وكذلك إن وقعت بعد الإيجاب، فهيَ حرفُ ابتداءٍ أيضاً، مثلُ: (قامَ خليلٌ، لكنْ عليٌّ)، فعليٌّ مبتدأ محذوفُ الخبر، والتقديرُ (لكنْ عليٌّ لم يَقُم). وهيَ بعدَ النفي والنهي مثلُ: (بَلْ): معناها إثباتُ النفي أَو النهي لِمَا قبلَها وجَعلُ ضِدّهِ لِما بعدَها. ي- لا: تُفيدُ معَ النفي العطفَ. وهيَ تُفيدُ إثباتَ الحُكمِ لِما قبلَها ونَفيَهُ عمّا بعدَها. وشرطُ معطوفها أن يكون مفرداً، أي غيرَ جملة، وأَن يكون بعدَ الإِيجابِ أو الأمرِ، نحو: (جاءَ سعيدٌ لا خالدٌ)، ونحو: (خذِ الكتاب لا القلمَ). وأثبتَ الكوفيُونَ العطفَ بليس، إن وقعت موقعَ (لا)، نحو: (خُذ الكتابَ ليس القلمَ). وعليه قولُ الشاعر: أينَ المَقَرُّ؟ وَالإِلهُ الطَّالِبُ وَالأَشْرَمُ الْمَغْلُوبُ لَيْسَ الْغالِبُ (فليس هنا: حرف عطف. والغالب معطوف على المغلوب. ولو كانت هنا فعلاً ناقصاً لنصب الغالب على أنه خبرٌ لها). 3- أحكامٌ تَتَعَلَّقُ بِعَطْفِ النَّسَق أ- يُعطَفُ الظاهرُ على الظاهر، نحو: (جاءَ زُهيرٌ وأُسامةُ) والمُضمَرُ على المُضمَر؛ نحو: (أنا وأنتَ صديقان)، ونحو: (أَكرمتُهم وإيّاكم)، والمَضمَرُ على الظاهر، نحو: (جاءَني علىٌّ وأَنتَ)، ونحو: (أكرمتُ سليماً وإيّاك)، والظاهرُ على المُضمر، نحو: (ما جاءَني إلا أنتَ وعلي) ونحو: (ما رأيتُ إلا إياك وعليّاً). غيرَ أنَّ الضميرَ المتّصِل المرفوعَ، والضميرَ المستترَ، لا يَحسُنُ أن يُعطَف عليهما إلا بعد توكيدهما بالمضير المنفصل، نحو: (جئتُ أنا وعليٌّ)، ومنه قوله تعالى: {إذهب أنتَ ورَبُّكَ}. ويجوزُ العطفُ عليهما أيضاً إذا كان بينَهما فاصلٌ أيُّ فاصلٍ، كقوله تعالى: {يَدخلونها ومَنْ صَلَحَ}، وقولهِ: {ما أشركنا ولا آباؤنا}، فقد عطفَ (مَنْ)، في الآية الأولى، على الواو في (يدخلونها)، لوجود الفاصل، وهو (ها)، التي هيَ ضميرُ المفعول به، وعطفَ (آباء)، في الآية الثانية، على (نا) في (أشركنا)، لوجود الفاصل، وهو (لا)، وذلك جائز. أمّا العطفُ على الضميرِ المجرور، فالحقُّ أنه جائزٌ، ومنه قوله تعالى: {وكفرٌ بهِ والمسجدِ الحرام}. وقُريءَ في بعض القراءَات السّبعِ: {واتَّقُوا الله الذي تساءَلونَ به والأرحامِ}، بالجرِّ عطفاً على الهاء. والكثيرُ إعادةُ الجارِّ كقوله تعالى: {فقال لها وللأرض ائتِيا طَوْعاً وكَرْهاً}، ونحو: (أحسنت إليكَ وإلى عليٍّ)، ونحو: (أكرمتُ غلامَكَ وغلامَ سعيدٍ). ب- يُعطَفُ الفعلُ على الفعل، بشرطِ أن يَتّحدا زماناً، سواءٌ اتحدا نوعاً، كقوله تعالى: {وإن تُؤْمنوا وتتّقوا يُؤتِكُمُ أُجُورَكم}، أم اختلفا، نحو: (إن تَجيء أكرمتُك وأُعطِك ما تريد). ج- يجوزُ حذفُ الواو والفاء مع معطوفهما إذا كان هناك دليلٌ، كقوله تعالى: {أن اضرِبْ بعصاكَ الحجَر، فانبجستْ}، أي: فضرَبَ فانبجست، وقولِ الشاعر: فَما كانَ بَيْنَ الخَيْرِ، لَوْ جاءَ سالِماً أبو حَجَرٍ، إِلاَّ لَيالٍ قَلائِلُ أي: (بين الخير وبيني). د- تختصُّ "(الواوُ) من بينِ سائر أخواتها بأنها تَعطفُ اسماً على اسم لا يكتفي به الكلامُ، نحو: (اختصمَ زيدٌ وعمرٌو. اشتركَ خالدٌ وبكرٌ. جلست بينَ سعيدٍ وسليمٍ)، فإنَّ الاختصامَ والاشتراكَ والبَينيّة من المعاني التي لا تقومُ إلا باثنينِ فصاعداً. ولا يجوزُ أن تقعَ الفاء ولا غيرُها من أحرف العطف في مثل هذا المَوقع، فلا يقال: (اختصمَ زيدٌ فعمرٌو. اشتركَ خالدٌ ثمَّ بكرٌ. جلستُ بينَ سعيدٍ أو سليمٍ). هـ- كثيراً ما تقتضي الفاءُ معَ العطف معنى السّببيّة، إن كان المعطوف بها جملةً، كقوله تعالى: {فوَكزَهُ موسى، فقضَى عليهِ}. |
حروف المعاني
الحرفُ على ضربين: حرف مَبني، وحرفِ معنى. فحرفُ المبنى: ما كان من بِنية الكلمة. ولا شأن لنا فيه. وحرفُ المعنى: ما كان له معنىً لا يظهر إلا إذا انتظم في الجملة: كحروف الجر والاستفهام والعطف، وغيرها. وهو قسمان: عامل وعاطل. فالحرف العامل: ما يُحدث إعراباً (أي تغيراً) في آخر غيره من الكلمات. والحروف العاملة هي: حروف الجر، ونواصب المضارع، والأحرف التي تجزم فعلاً واحداً، وإن وإذ ما (اللتان تجزمان فعلين)، والأحرف المُشبهة بالفعل التي (التي تنصب الإسم وترفع الخبر)، و لا النافية للجنس (التي تعمل عمل (إن)، فتنصب الاسم وترفع الخبر) وما ولا ولاتَ وإن (المُشبهات بليس في العمل، فترفع الاسم وتنصب الخبر). وقد سبق الكلام عنها. والحرف العاطل (ويُسمى غير العامل أيضاً): ما لا يُحدث إعراباً في آخر غيره من الكلمات، كهل وهلاَّ ونَعَمْ ولولا، وغيرها. ( أنواع الحروف ) الحروفُ بحسب معناها، سواءٌ أكانت عاملةً أم عاطلةً، واحد وثلاثون نوعاً. وهي: 1- أحرُفُ النَّفْي وهي: (لم ولمَّا)، اللَّتانِ تجزمانِ فعلاً مضارعاً واحداً، و (لن)، التي تنصب الفعل المضارع، و (ما وإنْ ولا ولاتَ). فما وإنْ: تنفيانِ الماضي، نحو: (ما جئتُ. إن جاءَ إلا أنا) والحالِ نحو: (ما أجلسُ. إن يجلس إلا أنا). وتدخلانِ على الفعل، كما رأيتَ، وعلى الاسمِ، نحو: (ما هذا بشراً. إن أحدٌ خيراً من أحدٍ إلا بالعافية). و (لا): تنفي الماضي، كقوله تعالى: {فلا صدَّقَ ولا صَلّى}، والمُستقبلَ كقوله: {قُلْ لا أسألُكم عليهِ أجراً}. و (لاتَ). خاصّةٌ بالدُّخولِ على (حين) وما أشبهَهُ من ظُروف الزمانِ، نحو: {ولاتَ حينَ مناصٍ}، وكقول الشاعر: (نَدِمَ البُغاةُ ولاتَ ساعةَ مَندَمٍ) وهي بمعنى (ليسَ). 2- أحرُفُ الجَواب وهيَ: (نَعَمْ وبَلى وإي وأَجلْ وجَيرِ وإنَّ ولا وكلاَّ). ويُؤتى بها للدلالةِ على جملة الجواب المحذوفة، قائمةً مَقامها. فإن قيلَ لكَ: (أَتذهبُ؟)، فقلتَ: (نَعَمْ)، فالمعنى: نَعَمْ أذهبُ. فنَعَمْ سادَّةٌ مَسَدَّ الجواب، وهو (أَذهبُ). و (أَجلْ): بمعنى (نعَمْ) وهي مثلُها: تكونُ تصديقاً للمُخبر في أخبارهِ كأن يقولَ قائلٌ: حضرَ الاستاذُ، فتقولُ: نعَمْ، تُصدِّقُ كلامهُ. وتكونُ لإعلامِ المُستخبر، كأن يُقالَ: هلْ حضرَ الأستاذُ؟ فتقولُ: نَعَم. وتكونُ لِوَعدِ الطالبِ بما يَطلُبُ، كأن يقولَ لكَ الأستاذُ: (اجتهِدْ في دروسكَ) فتقول: (نَعَم)، تَعِدُهُ بما طلبَ منك. و (أي): لا تُستعمَلُ إلا قبل القسمِ، كقوله تعالى: {قُلْ إي ورَبي إنَّهُ لَحَقٌّ}. (أي): توكيد للقسم، والمعنى نعم وربي. وبينَ (بَلى ونَعمْ وأَجل) فرقٌ. فَبلى. تختصُّ بوقوعها بعدَ النّفي فتجعلُهُ إثباتاً، كقوله تعالى: {زَعَمَ الذينَ كفروا أَنْ لن يُبعَثوا، قُل بَلى ورَبي لَتُبعَثُنَّ}، وقولهِ: {أَلستُ بِرَبّكُم، قالوا: (بَلى)}، أي: بَلى أنتَ ربُّنا. بخلاف (نَعَمْ وأجلْ) فإنَّ الجوابَ بهما يَتبعُ ما قبلَهما في إثباتهِ ونفيهِ، فإن قلتَ لرجلٍ: (أَليسَ لي عليكَ الفُ دِرهَمٍ؟) فإن قالَ: (بَلَى) لزِمَهُ ذلكَ، لأنَّ المعنى (بَلى لَكَ عليَّ ذلكَ) وإن قال: (نَعَمْ) أَو (أَجلْ) لم يَلزمهُ، لأنَّ المعنى (نَعَم ليس لكَ عليَّ ذلك). و (جَيْرِ): حرفُ جوابٍ، بمعنى: (نَعَمْ). وهو مبنيٌّ على الكسر. وقد يُبنى على الفتح. والأكثرُ أن يقعَ قبلَ القَسم، نحو: (جيرِ لأفعلنَّ)، أي: (نَعَم واللهِ لأفعلنَّ). ومنهم من يجعله اسماً، بمعنى: (حقاً) قال الجوهريُّ في صَحاحه: (قولهم: جيرِ لآتينَّك، بكسر الراءِ: يمينٌ للعرب) بمعنى: (حقاً). و (إنَّ): حرفُ جوابٍ، بمعنى: (نَعَمْ)، يقال لك: (هل جاءَ زُهَيرٌ؟) فتقولُ: (إنَّهُ)، قال الشاعر: بَكَرَ العَواذلُ، في الصَّبُو حِ، يَلُمْنَني وَأَلومُهُنَّهْ وَيَقُلْنَ: شَيْبٌ قَدْ عَلاَ كَ، وَقَدْ كَبِرْتَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ والهاءُ، التي تلحقه، هي هاءُ السَّكت، التي تُزادُ في الوقف، لا هاءُ الضمير ولو كانت هاءَ الضمير لثبتت في الوصل، كما تثبتُ في الوقف. وليس الأمرُ كذلك، لأنك تحذفها إن وصلتَ، يقال لك: (هل رجعَ أُسامةُ؟) فتقولُ: (إنّ) يا هذا، أي: نعم، يا هذا قد رجع. وأيضاً قد يكون الكلام على الخطاب أو التكلم، والهاءُ هذه على حالها، نحو: (هل رجعتم؟)، فتقولُ: (إنَّهُ)، وتقولُ: (هل نمشي؟) فتقول: (إنَّهْ). ولو كانت هذه الهاءُ هاءَ الضمير، وهي للغيبة، لكان الكلامُ فاسداً. و (إنَّ)، الجوابيّةُ هذه، منقولةٌ عن (إنَّ) المؤكدة، التي تنصبُ الاسمَ وترفع الخبر، لأن الجوابَ تصديقٌ وتحقيق، وهما والتأكيد من باب واحد. و (لا وكَلاَّ): تكونانِ لنفي الجواب. وتُفيدُ (كَلاَّ)، مع النفي، رَدعَ المُخاطبِ وزجرَهُ. تقولُ لِمنْ يُزَيَّنُ لك السوء ويُغريكَ بإتيانهِ: (كَلاَّ)، أي: لا أُجيبُكَ إلى ذلك، فارتدعْ عن طلبك. وقد تكونُ (كَلاَّ) بمعنى: (حَقاً)، كقولهِ تعالى: {كلاَّ، إنَّ الإنسانَ لَيَطغى أنْ رآه استغنى}. 3- حرفا التفسير وهُما: (أيْ وأن). وهُما موضوعانِ لتفسيرِ ما قبلهما، غيرَ أنَّ (أيْ) تُفسَّرُ بها المُفرداتُ، نحو: (رأيتُ ليثاً، أي: أسداً)، والجُمَلُ، كقول الشاعر: وَتَرْمينَني بالطَّرْفِ، أَيْ، أَنتَ مُذْنِبٌ وَتَقْلينني، لكِنَّ إِيَّاكِ لا أَقلي وأمّا (أنْ) فتختصُّ بتفسير الجُمَلِ. وهي تقعُ بينَ جملتينِ، تتضمَّنُ الأولى منهما معنى القولِ دونَ أحرفهِ، كقوله تعالى: {فأوحينا إليه، أن اصنَعِ الفُلكَ}، ونحو: (كتبتُ إليه، أنِ تحضرْ). |
4- أحرُفُ الشَّرْطِ
وهي: (إنْ وإذْ ما) الجازمتانِ، و (لَوْ ولولا ولوما وأمّا ولمَّا). و (لَوْ) على نوعين: الأول: أن تكونَ حرفَ شرطٍ لِمَا مضى، فتُفيدُ امتناعَ شيءٍ لامتناعِ غيرهِ: وتُسمّى حرفَ امتناع لامتناع، أو حرفاً لِما كانَ سيقعُ لوقوعِ غيره. فإن قلتَ: (لو جئتَ لأكرمتُكَ)، فالمعنى: قد امتنعَ إكرامي إياكَ لامتناع مجيئك، لأنَّ الإكرامَ مشروطٌ بالمجيءِ ومُعلَّقٌ عليه. ولا يَليها إلا الفعلُ الماضي صيغةً وزماناً، كقوله تعالى: {ولو شاءَ رَبُّكَ لجعلَ الناس أُمةً واحدةً}. الثاني: أن تكونَ حرفَ شرطٍ للمستقبل، بمعنى (إنْ). وهي حينئذٍ لا تُفيدُ الامتناع، وإنما تكون لمجرَّد ربطِ الجوابِ بالشرط، كإنْ، إلاّ أنها غيرُ جازمةٍ مثلَها، فلا عملَ لها، والأكثرُ أن يَليها فعلٌ مُستقبلٌ معنًى لا صيغةً، كقوله تعالى: {وليَخشَ الذينَ لو تركوا من خلفهم ذُرِّيَّةً ضعافاً خافوا عليهم}، أي: (إنْ يَتركوا) وقد يَليها فعلٌ مستقبلٌ معنًى وصيغةً: (لو تزورُنا لسُرِرنا بِلقائكَ)، أي: (إن تَزُرْنا). وتحتاجُ (لو) بنوعيها إلى جواب، كجميع أدواتِ الشرطِ. ويجوزُ في جوابها أن يقترنَ باللام، كقوله تعالى: {لو كانَ فيهما آلهةٌ إلا اللهُ لفَسدَتا}، وأن يتجرَّدَ منها، كقوله تعالى: {ولو نشاءُ جعلناهُ أُجاجاً}، وقولهِ: {ولو شاءَ رَبُّكَ ما فعَلوهُ}. إلا أن يكون مضارعاً منفيّاً، فلا يجوزَ اقترانهُ بها، نحو: (لو اجتهدتَ لم تَندَم). و (لولا ولوما)، حرفا شرطٍ بَدلانِ على امتناعِ شيءٍ لوُجودِ غيرهِ. فإن قلتَ: (لولا رحمةُ اللهِ لَهلَكَ الناسُ) و (لَوما الكتابةُ لَضاعَ أكثرُ العلمِ)، فالمعنى أنهُ امتنعَ هَلاكُ الناسِ لوجودِ رحمةِ اللهِ تعالى، وامتنعَ ضياعُ أكثرِ العلم لوجود الكتابةِ. وهما تَلزَمانِ الدخولَ على المبتدأ والخبر، كما رأيتَ. غيرَ أَنَّ الخبرَ بعدهما يُحذَفُ وجوباً في أكثرِ التراكيبِ. والتقديرُ: (لولا رحمةُ اللهِ حاصلةٌ أو موجودةٌ) و (لولا الكتابة حاصلة أو موجودة). وتحتاجانِ إلى جوابٍ، كما تحتاجُ إليه (لو). وحكمُ جوابهما كحكم جوابها، فيقترنُ باللام، كما رأيتَ، أو يُجرَّدُ منها، نحو: (لولا كرمُ أخلاقِكَ ما عَلَوَتَ)، ويمتنعُ من اللام في نحو: (لولا حُبُّ العلمِ لم أغتربْ) لأنهُ مضارع منفيٌّ. و (أمّا) بالفتح والتشديدَ، حرفُ شرطٍ يكونُ للتّفصيل أو التوكيد. وهي قائمةٌ مَقامَ أَداةِ الشرط وفعلِ الشرط. والمذكورُ بعدَها جوابُ الشرط، فلذلك تَلزَمُه فاءُ الجواب للرَّبط. فإن قلتَ: (أمّا أنا فلا أقولُ غيرَ الحقِّ) فالمعنى: (مهما يكنْ من شيءٍ فلا أقولُ غيرَ الحقِّ). أمّا كونُها للتفصيلِ فهو الأصلُ فيها، كقوله تعالى: {فأمّا اليتيم فلا تقهَرْ، وأمّا السائل فَلا تَنهَرْ، وأمّا بنعمةِ رَبِّكَ فحدِّثْ}. وأمّا كونُها للتأكيد، فنحوُ أن تقولَ: (خالدٌ شجاعٌ)، فإن أردتَ توكيدّ ذلكَ، وأنهُ لا محالةَ واقعٌ، قلتَ: (أمّا خالدٌ فشجاعٌ). والأصلُ: (مهما يكن من شيءٍ فخالدٌ شجاع). و (لمّا): حرفُ شرطٍ، موضوعٌ للدلالةِ على وجودِ شيءٍ لوجودِ غيرهِ. ولذلك تُسمّى: حرفَ وُجودٍ لوجودٍ. وهي تختصُّ بالدخول على الفعل الماضي. وتقتضي جُملتينِ، وُجِدَتْ أُخراهما عند وجود أولاهما. والأولى هي الشرطُ، والأخرى هي الجوابُ، نحو: (لمَّا جاءَ أكرمتُهُ). وتحتاج إلى جوابٍ، لأنها في معنى أدواتِ الشرط. ويكونُ جوابها فعلاً ماضياً، كما رأيتَ، أو جملةً اسميّةً مقرونةً بإذا الفجائيّة، كقوله تعالى: {فلمّا نجّاهم إلى البَرِّ إذا هم يشركونَ}، أو بالفاءِ، كقوله تعالى: {فلمّا نجاهم إلى البرِّ فمنهم مُقتصدٌ}. ومن العلماءِ من يجعلها ظرفاً للزمان بمعنى (حين)، ويضيفها إلى جُملةِ الشرطِ وهو المشهورُ بينَ المُغرِبينَ، والمحقِّقُونَ على أنها حرفٌ للرَّبط. 5- أَحرُفُ التَّحضيضِ وَ التَّنْديمِ وهي: (هَلاّ وأَلاّ ولوما ولولا وألا). والفرقُ بينَ التحضيضِ والتّنديمِ، أنَّ هذه الأحرفَ، إن دخلت على المضارع فهيَ للحضِّ على العملِ وتركِ التهاوُنِ به، نحو: (هَلاّ يرتدعُ فلانٌ عن غيِّه. أَلاَّ تَتُوبُ من ذنبِك. لولا تستغفرونَ اللهَ. لوما تأتينا بالملائكة. {ألا تُحبُّون أن يغفرَ اللهُ لكم}). وإن دخلت على الماضي كانت لجعلِ الفاعلِ يندَمُ على فواتِ الأمر وعلى التّهاون به، نحو: (هلاّ اجتهدتَ)، تُقرِّعهُ على إهمالهِ، وتُوبِّخهُ على عدَم الاجتهاد، فتجعلُهُ يندَمُ على ما فَرَّطَ وضيَّع. ومنهُ قوله تعالى: {فلولا نَصَرَهمُ الذينَ اتخذوا من دُونِ اللهِ قُرَناءَ آلهةً}. 6ـ أحرُفُ العَرْضِ العَرضُ: الطَّلبُ بلينٍ ورفقٍ، فهو عكسُ التّحضيض، لأنَّ هذا هو الطلبُ بشدَّةٍ وَحثٍّ وإزعاجٍ. وأحرفهُ هيَ: (ألا وأمَا ولوْ)، نحو: (ألا تَزُورُنا فنَأنس بكَ. أما تَضِيفُنا فتلقى فينا أهلاً. لو تُقيم بيننا فتُصيبَ خيراً). وقد تكونُ (أمَا) تحقيقاً للكلام الذي يَتلوها، فتكونُ بمعنى (حَقاً)، (أمَا إنَّهُ رجلٌ عاقلٌ) تعني أنهُ عاقلٌ حقاً. |
7- أحرُفُ التَّنبيهِ
وهيَ: (أَلا وأمَا وها ويا). فـ (ألا وأمَا): يُستفتَحُ بهما الكلامُ، وتُفيدانِ تنبيهَ السامع إلى ما يُلقى إليه من الكلامِ. وتُفيدُ (ألا)، معَ التنبيه، تَحقُّقَ ما بعدَها، كقوله تعالى: {أَلا إِنَّ أَولياءَ اللهِ لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون}. واعلم أنَّ (أَلا وأَمَا). معناهما التنبيهُ، ومكانُهما مُفتتَحُ الكلام. و (ها): حرفٌ موضوعٌ لتنبيهِ المُخاطَب. وهو يدخلُ على أربعة أشياء: أ- على أسماءِ الإشارةِ الدَّالةِ على القريب، نحو: (هذا وهذه وهذَين وهاتَينِ وهؤلاء)، أو على المتوسطِ، إن كان مُفرداً، نحو: (هذاكَ). أمّا على البعيدِ فلا. ويجوزُ الفصلُ بينهما بكافِ التشبيهِ، كقوله تعالى: {فلمّا جاءَت قيل أهكذا عَرشُكِ؟}، وبالضميرِ المرفوعِ، كقولهِ: {ها أنتم أُولاءِ}، ونحو: (ها أنا ذا. ها أنتما ذانِ. ها أنتِ ذي). ب- على ضميرِ الرفع، وإن لم يكن بعدَهُ اسمُ إشارةٍ، كقول الشاعر: فَها أَنا تائِبٌ مِن حُبِّ لَيْلى فَما لَكَ كُلَّما ذُكِرَتْ تَذوبُ؟! غيرَ أنها، إن دخلت على ضمير الرفع، فالأكثرُ أن يَليَهُ اسمُ الاشارةِ، نحو: (ها أنا ذا. ها نحنُ أُولاءِ. ها أنتم أُولاءِ. ها هو ذا. ها هما ذانِ. ها هم أُولاءِ. ها أنتما تانِ يا امرأتانِ). ج- على الماضي المقرون بِقد، نحو: (ها قد رجعتُ). د- على ما بعدَ (أيٍّ) في النداءِ، كقوله تعالى: {يا أيُّها الإنسانُ ما غَرَّكَ بربكَ الكريم. يا أيّتُها النفسُ المُطمئنَةُ ارجعي إلى ربكِ راضيةً مرضيّةً} وهي تلزمُ في هذا الموضع وجوباً، للتبيهِ على أنَّ ما بعدَها هو المقصودُ بالنداءِ. و "يا": أصلُها حرفُ نداءٍ. فإن لم يكن بعدَها مُنادىً، كانت حرفاً يُقصَدُ بهِ تنبيهُ السامع إلى ما بعدها. وقيلَ: إن جاءَ بعدها فعلُ أمرٍ فهي حرفُ نداءٍ، والمنادَى محذوفٌ، كقولهِ تعالى: {أَلا يا اسجُدوا}، والتقديرُ: (ألا يا قومُ اسجدوا).وإلا فهيَ حرفُ تنبيه، كقوله: {يا ليتَ قومي يعلمون}، وكحديث: (يا رُبَّ كاسيةٍ في الدنيا عاريةٌ يوم القيامَةِ). ومنه قول الشاعر: يا لَعْنَةُ اللهِ وَالأَقْوامِ كُلِّهِمِ وَالصَّالحِينَ عَلى سَمْعانَ مِنْ جارِ [يا: حرف تنبيه. ولعنة: مبتدأ. خبره الجار والمجرور: (على سمعان).] والحقُّ أنها حرفُ تنبيهٍ في كلِّ ذلك. 8- الأَحْرُفُ الْمَصْدَرِيَّةُ وتسمّى: الموصولاتِ الحرفيّة أَيضاً وهي التي تجعلُ ما بعدَها في تأويل مصدر. وهي: (أَنْ وأَنًَّ وكي وما ولو وهمزةُ التّسوية)، نحو: (سرَّني أَن تُلازمَ الفضيلةَ. أُحِبُّ أنكَ تجتنبُ الرَّذيلةَ. إرحمْ لكي تُرحَمَ. أَوَدُّ لو تجتهدُ). {واللهُ خلقكُم وما تعملون}. {سواءٌ عليهم أَأَنذرتهم أم لم تُنذِرهم}. والمصدر المؤولُ بعدها يكونُ مرفوعاً أَو منصوباً أَو مجروراً، بحسب العاملِ قبلَهُ. [ يسمى الحرف المصدري: موصولاً حرفياً، لأنه يوصَل بما بعده فيجعله في تأويل مصدر] (ففي المثال الأول مرفوع، لأنه فاعل. وفي المثال الثاني منصوب، لأنه مفعول به. وفي المثال الثالث مجرور باللام. وفي المثال الرابع منصوب أيضاً، لأنه مفعول به. وفي المثال الخامس منصوب أيضاً، لأنه معطوف على كاف الضمير في (خلقكم) المنصوبة محلاً، لأنها مفعول به. وفي المثال السادس مرفوع، لأنه مبتدأ خبره مقدَّم عليه، وهو سواء). وتكونُ (ما) مصدريةً مجرَّدةً عن معنى الظرفيّةِ، نحو: (عَدِبتُ مما تقولُ غيرَ الحقِّ)، أَي: (من قولك غيرَ الحقِّ). وتكون مصدريةً ظرفيّةً، كقوله تعالى: {وأَوصاني بالصلاةِ والزَّكاةِ ما دُمتُ حيّا}، أَي: (مُدَّةَ دَوامي حَيّاً). فَحُذِفَ الظَّرفُ وخَلَفتهُ (ما) وصِلَتُها. ويكونُ المصدرُ المؤوَّلُ بعدها منصوباً على الظَّرفيّة، لقيامهِ مقامَ المُدَّةِ المحذوفةِ (وهوَ الأحسنُ)، أَو يكون في موضع جَرٍّ بالإضافة إلى الظّرف المحذوفِ. وأَكثرُ ما تقعُ (لو) بعدَ (وَدَّ وَيوَدُّ)، كقوله تعالى {وَدُّوا لو تُدهِنُ فَيُدهنونَ}. {يَوَدُّ أحدُهم لو يُعمّرُ أَلفَ سنةٍ}. [أدهن يُدهن وداهن يداهن: نافق وراءى وصانَع وخادَع] وقد تقعُ بعد غيرهما كقول قُتَيلةَ: ما كانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنَنتَ، وَرُبَّما مَنَّ الْفَتى وَهُوَ المَغِيظُ المُخْنَقُ أَي: ما كان ضَرَّكَ مَنُّكَ عليه بالعفو. 9- أَحرُفُ الاستِقْبال وهي: (السينُ، وسوفَ، ونواصبُ المضارعِ، ولامُ الأَمرِ، ولا الناهية وإنْ، وإِذْ ما الجازمتان). فالسينُ وسوفَ: تختصّانِ بالمضارعِ وتَمحضانهِ الاستقبالَ، بعدَ أن كان يحتملُ الحالَ والاستقبالَ، كما أَنَّ لامَ التأكيدِ تُخلِصُهُ للحالِ، نحو: (إنَّ سعيداً لَيَكتبُ). [تمحضانه: تجعلانه للاستقبال المحض وتخلصانه له] والسينُ: تُسمّى حرفَ استقبال، وحرفَ تنفيسٍ (أَي: توسيعٍ)، لأنها تَنقُلُ المضارعَ من الزمان الضيّقِ، وهو الحالُ؛ إلى الزمانِ الواسعِ وهو الاستبقال. وكذلك (سوفَ)، إلا أَنها أَطولُ زماناً من السين، ولذلك يُسمُّونها (حرفَ تسويفٍ)، فتقولُ: (سَيَشِبُّ الغلامُ، وسوفَ يَشيخُ الفتى)، لِقُربِ زمان الشبابِ من الغلام وبُعدِ زمان الشيخوخةِ من الفتى. ويجبُ التصاقُهما بالفعلِ، فلا يجوزُ أن يَفصلَ بَينَهما وبينه شيءٌ. وإذا أردتَ نفيَ الاستبقالِ أَتيتَ بِلا، في مُقابلة (السين)، وبِلَنْ، في مقابلة (سوف)، نحو: (لا أفعلُ)، تَنفي المستقبل القريب، ونحو: (لن أَفعلَ)، تنفي المستقبلَ البعيد. ولا يجوزُ أن يُؤتى بسوفَ و (لا) معاً، ولا بسوفَ و (لن) معاً، فلا يُقالُ: (سوفَ لا أفعلُ) ولا (سوف لن أفعلَ) كما يقولُ كثيرٌ من الناسِ، وبينهم جَمهَرةٌ من كتّابِ العصر. |
10- أحْرُفُ التَّوْكيد
وهي: (إنَّ، وأَنَّ، ولامُ الابتداءِ، ونونا التوكيدِ، واللامُ التي تقع في جواب القسَم، وقد). و (نونا التوكيد) : إحداهما ثقيلةٌ والأخرى خفيفةٌ. وقد اجتمعتا في قوله تعالى: {ليُسجَننْ وَليَكُوناً من الصّاغرين}. ولا يُوكّدُ بهما إلا فعلُ الأمر، نحو: (تَعلّمَنَّ)، والمضارعُ المُستقبلُ الواقعُ بعدَ أداةٍ من أَدواتِ الطلبِ، ونحو: (لِنجتهدَنَّ ولا نكسلَنَّ)، والمضارعُ الواقعُ شرطاً بعدَ (إن) المؤكّدةِ بما الزائدة، كقوله تعالى: {فإمَّا يَنزَغَنَّكَ من الشيطانِ نزغٌ فاستعِذْ باللهِ}، والمضارعُ المنفيُّ بلا. كقوله: {واتّقُوا فِتنةً لا تُصيبنَّ الذينَ ظَلموا منكم خاصّةً}، والمُضارعُ المُثبتُ المستقبلُ الواقعُ جواباً لقسمٍ كقوله: {تاللهِ لأكيدَنَّ أصنامكم}. وتأكيدُهُ في هذهِ الحالِ واجبٌ، وفي غيرها، ممّا تقدَّمَ، جائزٌ. و (لامُ القسم): هي التي تقعُ في جواب القسمِ تأكيداً له، كقوله تعالى: {تاللهِ لقد آثرَك اللهُ علينا}. والجملةُ بعدَها جوابُ القسم وقد يكونُ القسمُ مُقدَّراً، كقوله سبحانه: {لقد كان لكم في رسولِ الله أُسوةٌ حَسنةٌ}. وتختصُّ (قد) بالفعل الماضي والمضارع المتصرِّفينِ المُثبَتينِ ويشترَطُ في المضارع أن يَتجرَّدَ من النواصب والجوازم والسينِ وسوف. ويُخطىءُ من يقولُ: (قد لا يذهب، وقد لن يذهب). (وقد شاع على ألسنة كثير من أدباء هذا العصر وعلمائه وأقلامهم دخول (قد) على (لا). ولم يسلم من ذلك بعض قدماء الكتاب وعلمائهم. وإنَّ (ربما) تقوم مقام (لا) في مثل هذا المقام، فبدل أن يقال: (قد لا يكون) مثلاً، يقال: (ربما لا يكون)). ولا يجوزُ أن يُفصَلَ بينَها وبينَ الفعل بفاصلٍ غيرِ القسم، لأنها كالجُزءِ منه، أَمَّا بالقسم فجائزٌ، نحو: (قد واللهِ فعلتُ). وهي، إن دخلت على الماضي أفادت تحقيقَ معناهُ. وإن دخلت على المضارع أَفادت تقليل وقوعه، نحو: (قد يَصدُقُ الكذوبُ. وقد يجودُ البخيل). وقد تُفيدُ التحقيقَ مع المضارع، إن دلَّ عليه دليلٌ، كقوله تعالى: {قد يَعلم اللهُ ما أَنتم عليه}. ومن معانيها التّوقُّعُ، أَي: تَوَقُّعُ حصولِ ما بعدها، أَي: انتظارُ حصولهِ، تقولُ: (قد جاءَ الأستاذُ)، إِذا كان مجيئُهُ مُنتظراً وقريباً، وإن لم يجىء فعلاً، وتقولُ: (قد يقدُمُ الغائبُ). إذا كنتَ تَترَقّبُ قُدومَهُ وتَتوَقعُهُ قريباً. ومن ذلك: (قد قامت الصلاةُ)، لأنَّ الجماعة يَتوَقعونَ قيامَها قريباً. ومنها التقريبُ، أَي: تقريبُ الماضي من الحالِ، تقولُ: (قد قُمتُ بالأمر)، لِتدُل على أنَّ قيامك بهِ ليسَ ببعيدٍ من الزمانِ الذي أنتَ فيه. ومنها الكثيرُ، نحو: {قد نَرى تَقلُّبَ وَجهِك في السماءِ}. وتُسمَّى (قد) حرفَ تحقيقٍ، أو تقليلٍ، أو تَوقعٍ، أو تقريبٍ، أو تكثير، حَسَبَ معناها في الجملة التي هي فيها. 11- حَرْفا الاستِفْهام وهما: (الهمزة وهل). فالهمزةُ: يُستفهَمُ بها عن المُفرَدِ وعن الجملةِ. فالأول نحو: (أخالدٌ شجاعٌ أم سعيدٌ؟). والثاني نحو: (أجتهدَ خليلٌ؟)، تستفهمُ عن نسبة الاجتهاد إِليه. ويُستفهَمُ بها في الإثباتِ، كما ذُكرَ، وفي النَّفي، نحو: (ألم يسافر أخوك؟). و (هل) : لا يُستفهمُ بها إلا عن الجملة في الإثبات، نحو: (هلْ قرأتَ النَّحوَ؟)، ولا يُقال: (هَل لم تقرأهُ؟). وأكثرُ ما يَليها الفعلُ، كما ذُكرَ، وقلَّ أن يَليها الاسمُ، نحو: (هل عليٌّ مجتهدٌ؟). وإذا دخلت على المضارع خَصّصتهُ بالاستقبال؛ لذلكَ لا يُقالُ: (هل تسافرُ الآن؟). ولا تدخل على جملة الشرط، وتدخُل على جملة الجواب، نحو: (إن يَقُم سعيدٌ فهل تقومُ؟). ولا تدخلُ على (إنَّ) ونحوها لأنها للتوكيد وتقرير الواقع، والاستفهامُ ينافي ذلك. 12- أحرُفُ التَّمنِّي وهي: (ليتَ ولو وهل). فليتَ: موضوعةٌ للتّمني. وهو طلبُ ما لا طمعَ فيه (أي المستحيل) أو ما فيه عُسرٌ (أي ما كان عَسِرَ الحصولِ). فالأولُ نحو: (ليت الشبابَ يعودُ) والثاني نحو: (ليتَ الجاهلَ عالم). و (لو وهل): قد تُفيدانِ التمني، لا بأصلِ الوضع، لأنَّ الأولى شرطية والثانيةَ استفهاميةٌ. فمثالُ (لو)، في التمني، قولهُ تعالى: {لو أنَّ لنا كَرَّةً فنكونَ من المؤمنينَ} ومثالُ (هل) فيه قوله سبحانهُ: {هل لنا من شُفعاءَ فيشفعوا لنا}. |
13- حَرْفُ التَّرَجِّي وَ الإِشْفاقِ
وهو: (لعلَّ). وهي موضوعةٌ للترجي والإشفاقِ. فالترجي: طلبُ الممكنِ المرغوب فيه، كقوله تعالى: {لعلَّ اللهَ يُحدِثُ بعد ذلك أمراً}. الإشفاقُ: هو توقُّع الأمر المكروهِ، والتخوُّفُ من حدوثهِ، كقوله تعالى: {لعلَّكَ باخعٌ نفسَكَ على آثارهم}. 14- حَرْفا التَّشْبيهِ وهما: (الكافُ وكأنَّ) فالكافُ نحو: (العلمُ كالنور). وقد تخرُج عن معنى التشبيه، فتكونُ زائدةً للتوكيدِ، نحو: {ليسَ كمثلهِ شيءٌ}، أي ليس مثلَهُ شيءٌ. وتكونُ بمعنى (على)، نحو: (كن كما أنتَ)، أي: على ما أنتَ عليه. وتَكونُ اسماً بمعنى: (مِثلٍ). وقد تقدَّمتْ أمثلتُها في حروف الجر. وكأنَّ، نحو: (كأنَّ العلمَ نورٌ). وإنما تتعيّنُ للتشبيهِ إن كن خبرُها اسماً جامداً، كما مُثِّلَ. فإن كان غيرَ ذلكَ، فهي للشّك، نحو: (كأَنَّ الأمرَ واقعٌ أو وَقعَ)، أو للظّنِّ، نحو: (كأنَّ في نفسكَ كلاماً)، أو التّهكُّمِ، نحو: (كأنكَ فاهمٌ!)، وكأن تَقولَ لقبيحِ المنظر: (كأنك البدرُ!)، أو للتّقريب، نحو: (كأنَّ المسافرَ قادمٌ)، ونحو: (كأنكَ بالشتاءِ مُقبِلٌ). 15- أحرُفُ الصلَة المرادُ بحرف الصلة هي: حرفُ المعنى الذي يُزادُ للتأكيد. وأحرفُ الصلة هي: (إنْ وأنْ وما ومن والباء)، نحو: (ماإنْ فعلتُ ما تكرهُ. لمّا أن أن جاءَ البشير. أكرمتُكَ من غيرِ ما مَعرفة. ما جاءَنا من أحدٍ. ما أنا بمُهملٍ). وتزادُ (من) في النَّفي خاصّةً، لتأكيدهِ وتعميمهِ، كقوله سبحانه: {ما جاءَنا من بشيرٍ ولا نذيرٍ}. والاستفهامُ كالنفي، كقوله سبحانه: {هل من خالقٍ غيرُ اللهِ}، وقولهِ: {هل من مَزيدٍ}. وتُزادُ الباءُ لتأكيد النفي، كقوله تعالى: {أليسَ اللهُ بأحكمِ الحاكمين؟}، ولتأكيد الإيجاب، نحو: (بحَسبكَ الاعتمادُ على النّفس)، ونحو: {كفى بالله شهيداً}، أي: (حَسبُكَ الاعتمادُ على النَّفس، وكفى اللهُ شهيداً). |
16- حَرْفُ التَّعْليلِ
الحرفُ الموضوع للتعليل هو: (كي)، يقولُ القائلُ: (إني أطلُبُ العلمَ) فتقولُ: (كيَمَهْ؟) أي: لِمَ تَطلبُهُ؟ فيقولُ: (كي أخدمَ بهِ الأمةَ)، أي: (لأجلِ أن أخدمها به). وقد تأتي (اللامُ وفي ومن) للتعليل، نحو: (فيمَ الخصامُ؟. سافرتُ للعمل. {مِمّا خطيئاتِهم أُغرِقوا}). 17- حَرْفُ الرَّدْعِ والزَّجْرِ وهوَ: (كَلاَّ). ويُفيدُ، معَ الرَّدعِ والزَّجرِ، النّفيَ والتّنبيهَ على الخطأ، يقولُ القائلُ: (فلانٌ يُبغضُكَ)، فتقولُ: (كلاَّ) تنفي كلامَهُ، وتَردعهُ عن مثل هذا القول؛ وتنبهُهُ على خَطَئِهِ فيه. وقد سبقَ الكلامُ عليه في أحرف الجواب. فراجعه. 18- اللاَّمات هي: لامُ الجرِّ، نحو: (الحمدُ للهِ). ولامُ الأمر، كقوله تعالى: {لِيُنفقْ ذو سَعةٍ من سَعتهِ}. ولامُ الابتداءِ، نحو: (لَدِرهمٌ حَلالٌ خيرٌ من ألفِ دِرهمٍ حرامٍ). ولامُ البُعد، وهي التي تلحقُ أسماءَ الإشارةِ، للدَّلالةِ على البُعد أو توكيدهِ نحو: (ذلكَ وذلِكُما وذلكم وذلكُنَّ). ولامُ الجواب، وهي التي تقعُ في جواب (لو ولولا)، نحو: (لو اجتهدتَ لأكرمتُكَ. لولا الدينُ لهَلكَ النّاسُ)، أو في جواب القَسم، كقوله تعالى: {تاللهِ لأكيدَنَّ أصنامكم}. واللام المُوَطَّئَةُ للقسم، وهي التي تدخلُ على أداةِ شرطٍ للدلالة على أن الجوابَ بعدَها إنما هو جوابٌ لقسمٍ مُقدَّرٍ قبلَها، لا جواب الشرطِ، نحو: (لَئِنْ قُمتَ بواجباتِكَ لأكرمتُكَ). وجوابُ القسم قائمٌ مَقامَ جوابِ الشرط ومُغنٍ عنهُ. 19- تاءُ التَّأنيثِ السَّاكِنَةُ وهي: التاءُ في نحو: (قامت وقعدّت). وتلحَقُ الماضي، للايذان من أوَّلِ الأمرِ بأنَّ الفاعلَ مُؤنث. وهي ساكنةٌ، وتحرّكُ بالكسر إن وَلِيها ساكنٌ، كقوله تعالى: {قالتِ امرأةُ عمرانَ} وقولهِ: {قالتِ الأعرابُ آمنّا}، وبالفتح، إن اتصلَ بها ضمير الاثنينِ، نحو: (قالتا). 20- هاءُ السَّكْتِ وهي: هاءٌ ساكنةٌ تلحقُ طائفةً من الكلمات عندَ الوقفِ، نحو: {ما أغنى عني ماليَهْ، هلَكَ عني سُلطانيهْ}، ونحو: (لِمَهْ؟ كَيمَهْ؟ كيفَهْ؟) ونحوها. فإن وصَلتَ ولم تَقِفْ لم تُثبتِ الهاءَ، نحو: (لِمَ جئتَ، كيمَ عصَيتَ أمري؟ كيف كان ذلك؟). ولا تزادُ (هاءُ السكت)، للوقف عليها، إلا في المضارع المعتلّ الآخر، المجزومِ بحذف آخره، وفي الأمر المبنيِّ على حذف آخره، وفي (ما) الاستفهاميَّةِ، وفي الحرف المبنيِّ على حركةٍ، وفي الاسم المبنيِّ على حركةِ بناءً أصليّاً. ولا يوقفُ بهاء السكت في غير ذلك، إلا شذوذاً. وقد سبق شرحُ ذلكَ في الكلام على (الوقف) في الجزءِ الثاني. 21- أَحرُفُ الطَّلَب وهي: (لامُ الأمرِ، ولا الناهيةُ، وحرفا الاستفهام، وأحرفُ التحضيض والتَّنديم، وأحرفُ العرض، وأحرف التمني، وحرفُ الترجي). وقد سبقَ الكلام عليها. 22- حَرْفُ التَّنْوينِ حرفُ التَّنوينِ: هو نونٌ ساكنةٌ زائدةٌ، تلحقُ أواخرَ الأسماءِ لفظاً، وتفارقها خطّاً ووقفاً. وقد سبق الكلامُ عليه، في أوائل الجزءِ الأول. بَقِيَّةُ الحروفِ (23) أحرفُ النّداءِ (24) أحرفُ العَطفِ (25) أحرف نصبِ المضارع (26) أحرفُ جزمه (27) حرفُ الأمر (28) حرفُ النَّهي (29) الأحرفُ المُشبّهةُ بالفعل، الناصبةُ للاسم الرافعةُ للخبر (30) الأحرف المشبهةُ بليسَ، الرافعةُ للاسم الناصبةُ للخبر (31) حروف الجر. وقد سبقَ الكلامُ عليها في مواضعها من هذا الكتاب. |
الخاتمة
وهي تشتمل على ثلاثة فصول ( العامل والمعمول والعمل ) وهذا الفصل يشتملُ على أربعة مباحث: 1- مَعْنى العامِلِ وَالْمَعْمولِ وَالْعَمَلِ متى انتظمتِ الكلماتُ في الجملة. فمنها ما يُؤثر فيما يَليهِ، فيرفعُ ما بعدَهُ، أو ينصِبُهُ أو يجزمهُ، أو يجُرُّهُ، كالفعل، يرفعُ الفاعلَ وينصِبُ المفعولَ بهِ، وكالمبتدأ، يرفعُ الخبر، وكأدوات الجزم، تجزمُ الفعلَ المضارع، وكحروف الجرِّ، تخفضُ ما يَليها من الأسماء. فهذا هو المُؤَثِّرُ، أو العاملُ ومنها ما يُؤثرُ فيه ما قبلَهُ، فيرفعُهُ، أو ينصبُهُ، أو يَجُرُّهُ، أو يجزمهُ، كالفاعل، والمفعول، والمضاف إليه، والمسبوق بحرف جرّ، والفعلِ المضارعِ وغيرِها. فهذا هو المتأثرُ أو المعمولُ. [المؤثر: الفاعل الذي يحدث أثراً في غيره. والمتأثر: المنفعل الذي يقبل أثر غيره] ومنها ما لا يُؤَثِّرُ ولا يَتأثرُ، كبعض الحروف، نحو: (هل وبل وقد وسوف وهلاَّ)، وغيرِها من حروف المعاني. والنتيجةُ الحاصلةُ من فعل المؤثر وانفعالِ المتأثر، هي الأثرُ، كعلامات الإعراب الدالَّةِ على الرفعِ أو النصب أو الجر أو الجزم، فهي نتيجةٌ لتأثيرِ العوامل الداخلةِ على الكلمات ولتأثُّرِ الكلمات بهذه العوامل. فما يُحدِثُ تَغيُّراً في غيرِه، فهو العاملُ. وما يَتغيَّرُ آخرُهُ بالعاملِ، فهو المعمولُ. وما لا يُؤثر ولا يَتأثرُ، فهو العاطلُ، أي: ما ليسَ بمعمولٍ ولا عامل. والأثرُ الحاصلُ، من رفع، أو نصبٍ، أو جزمٍ، أو خفض، يُسمّى: (العملَ)، أي: الإعرابَ. 2- العامل العاملُ: ما يُحدِثُ الرفعَ، أو النصب، أو الجزمَ، أو الخفضَ، فيما يَليهِ. والعواملُ هي الفعلُ وشِبهُه، والأدواتُ التي تنصبُ المُضارع أو تجزمُهُ، والأحرفُ التي تنصبُ المبتدأ وترفعُ الخبرَ، والأحرفُ التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وحروف الجرِّ، والمُضافُ، والمبتدأ. وقد سبقَ الكلامُ عليها، إلا شِبهَ الفعل، فسيأتي الكلامُ عليه. وهي قسمان: لفظيّةٌ ومعنويَّةٌ. فالعاملُ اللفظيَّ: هوَ المؤثرُ الملفوظُ، كالذي ذكرناه. والعاملُ المعنوي:هو تَجرُّدُ الاسم والمضارع من مُؤثر فيهما ملفوظ. والتجرّدُ هو من عوامل الرفع. فتجرّد المبتدأ من عامل لفظي كان سبب رفعه. وتجرد المضارع من عوامل النصب والجزم كان سبب رفعه أيضاً. فالتجرد: هو عدم ذكر العامل. وهو سبب معنوي في رفعه ما تجرد من عامل لفظي، كالمبتدأ والمضارع الذي لم يسبقه ناصب أو جازم. 3- الْمَعْمول المعمولُ: هو ما يَتغيَّرُ آخرُهُ برفعٍ، أو نصبٍ، أو جزمٍ، أو خفضٍ بتأثير العامل فيه. والمعمولاتُ هي الأسماءُ، والفعلُ المضارعُ. والمعمولُ على ضربين: معمولٍ بالأصالة، ومعمولٍ بالتَّبعيّة. فالمعمولُ بالأصالةِ: هو ما يُؤثَرُ فيه العاملُ مباشرةً، كالفاعل ونائبهِ، والمبتدأ وخبرهِ، واسم الفعل الناقص وخبره، واسمِ إنَّ وأَخواتها وأَخبارها، والمفاعيلِ، والحال، والتمييز، والمستثنى، والمضافِ إليهِ، والفعلِ المضارع. والمبتدأ يكونُ عاملاً، لرفعهِ الخبرَ. ويكونُ معمولاً، لتجرُّدهِ من العوامل اللفظيةِ للابتداء، فهو الذي يرفعُه. والمضافُ يكون عاملاً، لجرِّهِ المضافَ إليه، ويكونُ معمولاً، لأنه يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً، حسبَ العواملِ الداخلةِ عليه. والمضارعُ وشِبهُهُ (ما عدا اسمَ الفعلِ) عاملانِ فيما يَليهما، معمولانِ لما يَسبقُهما من العوامل. والمعمولُ بالتّبعيّة: هو ما يُؤثرُ فيه العاملُ بواسطة متبوعه، كالنَّعت والعَطفِ والتوكيدِ والبدل، فإنها تُرفعُ أَو تُنصَبُ أو تُجرُّ أو تُحزَمُ، لأنها تابعةٌ لمرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم. والعاملُ فيها هو العاملُ في متبوعها الذي يَتقدّمها. وقد سبقَ الكلام على ذلك كلهِ مُفصّلاً. 4- العَمَل العملُ (ويُسمّى: الإعرابَ أيضاً): هو الأثرُ الحاصلُ بتأثير العامل، من رفعٍ أو نصبٍ أو خفض أو جزم. وقد تقدَّمَ الكلامُ عليه مُفصلاً في أَوائل الجزء الأول من هذا الكتاب. |
( عمل المصدر والصفات التي تُشْبِهُ الفِعْل )
وهذا الفصل يشتملُ على خمسة مباحث: 1- عَمَلُ الْمَصْدَرِ وَاسمِ الْمَصْدَرِ يعملُ المصدرُ عَمَلَ فعلهِ تَعدِّياً ولزوماً. فإن كان فعلهُ لازماً، احتاجَ إلى الفاعلِ فقط، نحو: (يُعجبُني اجتهادُ سعيدٍ). [اجتهاد: مصدر مضاف الى فاعله، وهو (سعيد)، فسعيد: مجرور لفظاً بالمضاف، مرفوعاً حكماً لأنه فاعل] وإن كان مُتعدِّياً احتاجَ إلى فاعلٍ ومفعولٍ بهِ. فهو يتعدَّى إلى ما يتعدَّى إليه فعلُه، إمّا بنفسهِ، نحو: (ساءَني عصيانُك أباكَ) [ عصيان: مصدر مضاف الى فاعله، وهو الكاف ضمير المخاطب. فالكاف: لها محلان من الاعراب: قريب، وهو الجر بالمضاف، وبعيد وهو الرفع لأنها فاعل: و (أباك) مفعول به لعصيان] وإمّا بحرف الجرِّ، نحو: (ساءَني مُرورُكَ بمواضعِ الشُّبهةِ). واعلم أن المصدرَ لا يعملُ عملَ الفعلِ لشبههِ به، بل لأنهُ أَصلُهُ. ويجوزُ حذفُ فاعلهِ من غيرِ أن يتحمّلَ ضميرَهُ، نحو: (سرَّني تكريم العاملينَ). [ تكريم: مصدر مضاف الى مفعوله؛ وهو (العاملين) والفاعل محذوف جوازاً، أي تكريمكم أو تكريم الناس أو نحو ذلك] ولا يجوزُ ذلكَ في الفعل، لأنهُ إن لم يَبرُز فاعلُهُ كان ضميراً مستتراً، كما تقدَّم في باب الفاعل. ويجوزُ حذفُ مفعوله، كقوله تعالى: {وما كان استغفارُ إبراهيمَ لأبيه إلا عن موعِدةٍ وَعدَها إياهُ}، أَي: استغفار إبراهيمَ رَبّهُ لأبيه. وهو يعملُ عملَ فعلهِ مضافاً، أو مجرَّداً من (أَلْ) والإضافةِ، أو مُعرَّفاً بأل، فالأولُ كقوله تعالى: {ولولا دفعُ اللهِ الناسَ بعضَهم ببعضِ}. والثاني كقوله عزَّ وجلَّ: {أو إطعامٌ في يومٍ ذي مسبغةٍ يَتيماً ذا مقربةٍ أو مِسكيناً ذا مَترَبَةٍ}. والثالثُ إِعمالُه قليلٌ، كقولِ الشاعر: لَقَدْ عَلِمَتْ أُولَى المُغيرَةِ أَنَّني كَرَرْتُ، فَلَمْ أَنْكُلْ عَنِ الضَّرْبِ مِسْمَعا وَشُرِط لإعمال المصدر أن يكون نائباً عن فعلهِ، نحو: (ضرباً اللصَّ)، أو أن يصحَّ حُلولُ الفعل مصحوباً بأنْ أو (ما) المصدريتين مَحلَّهُ. فإذا قلتَ: (سرَّني فَهمُكَ الدَّرسَ)، صحَّ أن تقول: (سرَّني أن تفهمَ الدرسَ). وإذا قلتَ: (يَسرُّني عملُكَ الخيرَ)، صحَّ أن تقول: (يَسُرُّني أن تعملَ الخيرَ). وإذا قلتَ: (يُعجبُني قولكَ الحقَّ الآن)، صحَّ أن تقولَ: (يعجبني ما تقولُ الحقَّ الآن). غيرَ أنهُ إذا أُريدَ به المُضيُّ أو الاستقبالُ قُدِّرَ بأنْ، وإذا أريدَ به الحالُ قُدِّرَ بِمَا، كما رأيتَ. لذلك لا يعملُ المصدرُ المؤكّدُ، ولا المُبيّنُ للنوع، ولا المُصغّرُ، ولا ما لم يُرَدْ به الحَدَثُ. فلا يُقالُ: (علَّمتُهُ تعليماً المسألةَ)، على أنَّ (المسألة منصوبةٌ بتعليماً) بل بعلَّمتُ، ولا (ضربتُ ضربةً وضربتينِ اللصَّ)، على نصب اللص بضربة أوضربتينِ، بل بضربتُ، ولا (يُعجبني ضُرَيْبكَ اللصَّ)، ولا (لسعيدٍ صَوْتٌ صوْتَ حَمامٍ)، على نصب (صوت) الثاني بصوت الأول بل يفعل محذوف، أو يُصَوتُ صوتَ حمام، أي: يُصَوِّتُ تصويتَهُ. ويجوز أن يكونَ مفعولاً به لفعلٍ محذوف، أي يُشبهُ صوتَ حمامٍ. ولا يجوز تقديمُ معمولِ المصدر عليه، إلا إذا كانَ المصدرُ بدلاً من فعلهِ نائباً عنه، نحو: (عملَكَ إتقاناً)، أو كان معمولهُ ظرفاً أو مجروراً بالحرف، كقوله تعالى: {فلمّا بلغَ معهُ السَّعيَ}، وقولهِ: {ولا تأخذكم به رأفةٌ}. ويُشترطُ في إعمالهِ أن لا يُنعتَ قبلَ تمامِ عملهِ، فلا يُقالُ: (سرَّني إكرامُكَ العظيمُ خالداً)، بل يجبُ تأخيرُ النَّعتِ، فتقولُ (سرَّني إكرامُكَ خالداً العظيمُ)، كما قال الشاعر: إنَّ وَجْدي بِكِ الشَّديدَ أَراني عاذراً مَنْ عَهِدْتُ فيكِ عَذولاً وإذا أُضيفَ المصدرُ إلى فاعله جَرَّهُ لفظاً، وكان مرفوعاً حكماً (أي: في محلِّ رَفعٍ)، ثمَّ يَنصبُ المفعولَ به، نحو: (سرَّني فهمُ زُهيرٍ الدرسَ). وإذا أُضيفَ إلى مفعولهِ جَرَّهُ لفظاً، وكان منصوباً حُكماً (أي: في محلِّ نصبٍ)، ثم يَرفعُ الفاعلَ، نحو: (سرَّني فَهمُ الدرسِ زُهيرٌ). وإذا لحقَ الفاعلَ المضافَ إلى المصدرِ، أو المفعولَ المضافَ إليهِ، أحدُ التوابعِ جازَ في التابعِ الجرُّ مراعاةً للَّفظِ، والرفعُ أو النصبُ مراعاةً للمحلِ، فتقولُ في تابعِ الفاعلِ: (سَرَّني اجتهادُ زُهيرٍ الصغيرِ، أو الصغيرُ) و (ساءَني إهمالُ سعيدٍ وخالدٍ، أو خالدٌ). وتقولُ في تابعِ المفعول: (يُعجبُني إكرامُ الأستاذِ المُخلصِ، أو المُخلصَ، تلاميذُهُ) و (ساءَني ضرب خالد وسعيدٍ، أو وسعيداً، خليلٌ). والمصدرُ الميميُّ كغير الميميّ، في كونهِ يعملُ عملَ فعلهِ، نحو: (مُحتمَلُك المصائبَ خيرٌ من مَركبِكَ الجَزَعَ). ومنه قول الشاعر: أَظَلومُ، إنَّ مَصابَكُمْ رَجُلاً أَهدَى السَّلامَ تَحِيَّةً، ظُلْمُ! واسمُ المصدرِ يعملُ عملَ المصدرِ الذي هو بمعناهُ، وبِشروطهِ، غيرَ أنّ عملَهُ قليلٌ، ومنه قولُ الشاعر: أَكُفْراً بَعْدَ رَدِّ الْمَوْتِ عَنِّي وَبَعْدَ عَطائِكَ الْمِئَةَ الرِّتاعا وقولُ الآخر: إذا صَحَّ عَوْنُ الخَالِقِ الْمَرْءَ، لَمْ يَجِدْ عَسيراً مِنَ الآمالِ إِلاَّ مُيَسَّرا وقولُ غيره: بِعِشْرَتِكَ الْكِرامَ تُعَدُّ مِنْهُمْ فَلاَ تُرَيَنْ لِغَيْرِهِمِ أَلوفا ومنه الحديثُ: (من قُبلَةِ الرجلِ امرأتَهُ الوُضوءُ). |
2- عَمَلُ اسمِ الْفاعِلِ
يعملُ اسمُ الفاعلِ عملَ الفعلِ المُشتق منه، إنْ متعدياً، وإنْ لازماً. فالمتعدّي نحو: (هل مُكرِمٌ سعيدٌ ضُيوفَه؟). واللازمُ، نحو: (خالدٌ مجتهدٌ أولادُهُ). ولا تجوزُ إضافتُهُ إلى فاعلهِ، كما يجوز ذلك في المصدر، فلا يقالُ: (هلْ مُكرِمُ سعيدٍ ضُيوفَهُ). وشرطُ عمله أن يقترنَ بألْ. فإن اقترنَ بها، لم يحتج إلى شرطٍ غيره. فهو يعملُ ماضياً أو حالاً أو مستقبلاً، مُعتمداً على شيءٍ أو غيرَ معتمدٍ، نحو: (جاء المعطي المساكينَ أمسِ أو الآن أو غداً). فإن لم يقترن بها، فشرطُ عملهِ أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، وأن يكون مسبوقاً بنفيٍ، أو استفهام، أو اسمٍ مُخبَرٍ عنه بهِ، أو موصوفٍ، أو باسمٍ يكون هوَ حالاً منه، فالأولُ، نحو: (ما طالبٌ صديقُكَ رفعَ الخلافِ). والثاني نحو: (هلْ عارفٌ أخوك قدرَ الإنصافِ؟). والثالث نحو: (خالدٌ مسافرٌ أبواهُ). والرابعُ نحو: (هذا رجلٌ مجتهدٌ أبناؤُهُ). والخامسُ نحو: (يَخطُبُ عليٌّ رافعاً صوتَهُ). وقد يكونُ الاستفهامُ والموصوفُ مُقدَّرَينِ. فالأولُ نحو: (مُقيمٌ سعيدٌ أم مُنصرفٌ؟) والتقديرُ: أمقيمٌ أم منصرفٌ؟ والثاني كقول الشاعر: كناطِحٍ صَخْرَةً يَوْماً لِيوهِنَها فَلَمْ يَضِرْها، وَأَوَهى قَرْنَهُ الْوَعِلُ أي: كوعلٍ ناطحٍ صخرةً. ونحو: (يا فاعلاً الخيرَ لا تنقطع عنه)، أي: يا رجلاً فاعلاً. واعلم أنَّ مبالغةَ اسم الفاعل تعملُ عملَ الفعلِ، كاسم الفاعل، بالشروطِ السابقةِ، نحو: (أنتَ حَمُولٌ النائبةَ، وحَلاَّلٌ عُقَدَ المشكلاتِ). والمثنّى والجمعُ، من اسمِ الفاعل وصيَغ المُبالغة، يعملان كالمُفرد منهما، كقوله تعالى: {والذاكرينَ اللهَ كثيراً}، وقولهِ: {خُشَّعاً أبصارُهم يخرجون من الأجداث}. وإذا جُرَّ مفعولُ اسم الفاعل بالإضافةِ إليه، جازَ في تابعهِ الجرُّ مراعاةً للِفظه، والنصبُ مراعاةً لمحلهِ، نحو: (هذا مُدرَّسُ النحوِ والبيانِ، أوِ البيانَ) ونحو: (أنت مُعينُ العاجزِ المسكينِ، أو المسكينَ). ويجوزُ تقديمُ معمولهِ عليه، نحو: (أنتَ الخيرَ فاعلٌ)، إلاّ أن يكونَ مقترناً بأل: (هذا المُكرمُ سعيداً)، أو مجروراً بالإضافةِ، نحو: (هذا وَلد مُكرمٍ خالداً)، أو مجروراً بحرفِ جرٍّ أصليٍّ، نحو: (أحسنتُ إلى مُكرمٍ عليّاً)، فلا يجوزُ تقديمهُ في هذه الصُّوَر. أمّ إن كان مجروراً بحرفِ جرٍّ زائد فيجوزُ تقيمُ معمولهِ عليه، نحو: (ليسَ سعيدٌ بسابقٍ خالداً)، فتقولُ: (ليس سعيدٌ خالداً بسابقٍ)، لأنَّ حرفَ الجرّ الزائدِ في حكم الساقط. 3- عَمَلُ اسْمِ الْمَفْعولِ يعملُ اسمُ المفعول عمَلَ الفعلِ المجهول، فيرفعُ نائبَ الفاعلِ، نحو: (عزَّ من كان مُكرَماً جارُهُ، محموداً جِوراُهُ). وتجوزُ إضافتُهُ إلى معمولهِ، نحو: (عَزَّ من كان محمودَ الجوارِ، مُكرَمَ الجارِ). وشروطُ إعمالهِ كما مرَّ في اسمِ الفاعل تماماً. 4- عَمَلُ الصِّفَةِ المُشَبَّهَةِ تعملُ الصفةُ المشبهةُ عملَ اسم الفاعلِ المتَعدِّي إلى واحدٍ، لأنها مُشبَّهةٌ به ويُستحسَنُ فيها أن تُضافَ إلى ما هوَ فاعلٌ لها في المعنى، نحو: (أنتَ حَسَنُ الخُلُقِ، نَقِيُّ النفسِ، طاهرُ الذَّيلِ). ولكَ في معمولها أربعةُ أوجُهٍ: أ- أن ترفعهُ على الفاعليّة، نحو (عليٌّ حسَنٌ خُلقُهُ، أو حسَنٌ الخُلُقُ أو الحسنُ خُلقُهٌ، أو الحسنُ خُلُقُ الأبِ). ب- أن تنصبهُ على التّشبيهِ بالمفعولِ به، إن كان معرفةً، نحو: (عليٌّ حسنٌ خُلقَهُ، أو حَسَنٌ الخُلُقَ، أو الحسنُ الخُلُقَ، أو الحسَنُ خُلُقَ الأبِ). ج- أن تنصبهُ على التمييز، إن كانَ نكرةً، نحو: (عليٌّ حسنٌ خُلقاً، أو الحسَنُ خُلقاً). د- أن تَجرَّهُ بالإضافة، نحو: (عليٌّ حسَنُ الخُلُقِ، أو الحسنُ الخُلُقِ، أو حسنُ خُلُقهِ، أو حسَنُ خُلقِ الأبِ، أو الحسن خُلُقِ الأبِ). واعلم أنهُ تمتنعُ إضافةُ الصفة إذا اقترنتْ بألْ، ومعمولها مُجرَّدٌ منها ومنَ الإضافة إلى ما فيه (أَلْ)، فلا يُقالُ: (عليٌّ الحسنُ خُلقهِ، ولا العظيمُ شدَّة بأسٍ). ويقال: (الحسنُ الخُلُقِ، والعظيمُ شدَّةِ البأسِ). 5- عَمَلُ اسْمِ التَّفْضِيلِ يرفعُ اسمُ التفضيلِ الفاعلَ. وأكثرُ ما يرفعُ الضميرَ المستترَ، نحو: (خالد أشجعُ من سعيدٍ). [فاعل أشجع ضمير مستتر (تقديره، (هو) يعود على خالد] ولا يرفعُ الاسمَ الظاهرَ إلا إذا صَلَحَ وقوعُ فعلٍ بمعناهُ مَوقعَهُ، نحو: (ما رأيتُ رجلاً أوقع في نفسه النصيحةُ منها في نفس زهير)، ونحو: (ما رأيتُ رجلاً أوقع في نفسه النصيحةُ منها في نفس زهير)، ونحو: (ما رأيتُ رجلاً أوقعَ في نفسهِ النصيحةُ كزهير). ونحو: (ما رأيتُ كنفس زهيرٍ أوقعَ فيها النصيحةُ). وتقولُ: (ما رجلٌ أحسنَ به الجميلُ كعليٍّ) ومن ذلك قولُ الشاعر: ما رَأَيْتُ امرَأً أَحَبَّ إِلَيْهِ البَذْلُ مِنْهُ إِلَيْكَ يا ابْنَ سِنانٍ فإن قلت فيما تقدَم: (ما رأيتُ رجلاً تقعُ النصيحةُ في نفسه كزهير، ما رجلٌ يحسنُ به الجميلُ كعليٍّ. ما رأيتُ أمرأ يحبُّ البذلَ كابنِ سنان) صحَّ. وقد يرفعُ الاسمَ الظاهرَ، وإن لم يَصلُح وقوعُ فعلٍ مَوقعَهُ، وذلك في لغةٍ قليلةٍ، نحو: (مررتُ برجلٍ أكرمَ منهُ أبوهُ).والأفضلُ أن يُرفعَ (أكرم) على أنهُ خبرٌ مُقدَّمٌ، و (أبوهُ). مبتدأ مؤخرٌ. وتكون جملة المبتدأ والخبر صفةً لرجلٍ. |
الخاتمة : الجمل وأنواعها
الجملةُ: قولٌ مُؤلفٌ من مُسنَدٍ ومُسندٍ إليه. فهي والمركَّبُ الاسناديُّ شيءٌ واحدٌ. مثلُ: (جاءَ الحقُّ، وزهقَ الباطلُ، إنَّ الباطلَ كانَ زَهوقاً). ولا يُشترط فيما نُسميه جملةً، أو مركَّباً إسنادياً، أن يُفيدَ معنًى تاماً مكتفياً بنفسهِ، كما يُشترطُ ذلك فيما نُسميهِ كلاماً. فهو قد يكون تامَّ الفائدةٍ نحو: {قد أفلحَ المؤمنون}، فيُسمّى كلاماً أَيضاً. وقد يكون ناقصَها، نحو: (مهما تفعلْ من خير أَو شرٍّ)، فلا يُسمّى كلاماً. ويجوزُ أن يُسمّى جملةً أَو مُركباً إسنادياً. فإن ذُكر جوابُ الشرط، فقيلَ: (مهما تفعلْ من خير أَو شرٍّ تُلاقهِ)، سُميَ كلاماً أيضاً، لحصول الفائدة التامّة. والجملةُ أَربعةُ أَقسامٍ: فعليّةٌ، واسميَّةٌ، وجملةٌ لها محلٌّ من الإعراب، وجُملةٌ لا محلَّ لها من الإعراب. أ- الجُملَةُ الفِعْلِيَّة الجملة الفعليّة: ما تألفت من الفعل والفاعل، نحو: (سبقَ السيفُ العذَلَ)، أو الفعل ونائبِ الفاعل، نحو: (يُنصَر المظلومُ)، أَو الفعلِ الناقصِ واسمه وخبره نحو: (يكون المجتهدُ سعيداً). ب- الْجُمْلَةُ الاسمِيَّةُ الجملةُ الاسميّةُ: ما كانت مؤلفةً من المبتدأ والخبر، نحو: (الحقُّ منصورٌ) أَو مِمّا أَصلُه مبتدأ وخبرٌ، نحو: (إن الباطل مخذولٌ. لا ريبَ فيه. ما أَحدٌ مسافراً. لا رجلٌ قائماً. أن أَحدٌ خيراً من أَحد إلا بالعافيةِ. لاتَ حينَ مناصٍ). ج- الجُمَلُ الَّتي لَها مَحَلٌّ مِنَ الإِعْراب الجملةُ، إن صحَّ تأويلُها بمُفرَدٍ، كان لها محلٌّ من الإعراب، الرفعُ أَو النصبُ أَو الجرُّ، كالمفرد الذي تُؤَوَّلُ بهِ، ويكونُ إعرابُها كإعرابه. فإن أُوِّلت بمفردٍ مرفوعٍ، كان محلُّها الرفعَ، نحو: (خالدٌ يعملُ الخيرَ)، فِإن التأويل: (خالدٌ عاملٌ للخير). وإن أُوِّلت بمفردٍ منصوبٍ، كان محلُّها النصبَ، نحو: (كان خالدٌ يعملُ الخيرَ)، فإنَّ التأويلَ: (كان خالدٌ عاملاً للخير). وإن أُوِّلت بمفردٍ مجرورٍ، كانت في محلِّ جرٍّ، نحو: (مررتُ برجلٍ يعملُ الخيرَ)، فإن التأويلَ: (مررتُ برجلٍ عاملٍ للخيرِ). وإن لم يصحَّ تأويلُ الجملةِ بمفردٍ، لأنها غيرُ واقعةٍ مَوْقِعَهُ، لم يكن لها محلٌّ من الإعراب، نحو: (جاءَ الذي كتبَ)، إذ لا يَصح أَن تقول: (جاءَ الذي كاتبٌ). والجُمَلُ التي لها محلٌّ من الإعرابِ سبعٌ: 1- الواقعةُ خبراً. ومحلُّها من الإعراب الرفعُ، إن كانت خبراً للمبتدأ، أَو الأحرفِ المشبهةِ بالفعلِ، أو (لا) النافية للجنس، نحو: (العلمُ يرفعُ قدرَ صاحبه. إن الفضيلةَ تُحَبُّ. لا كسولَ سِيرتُهُ ممدوحةٌ). والنصبُ إن كانت خبراً عن الفعلِ الناقصِ، كقولهِ تعالى: {أَنفسَهم كانوا يظلمون}، وقولهِ: {فذبحوها وما كادوا يفعلون}. 2- الواقعة حالاً. ومحلُّها النصب، نحو: {جاءُوا أَباهم عشاءً يَبكون}. 3- الواقعةُ مفعولاً به. ومحلها النصبُ أيضاً، كقولهِ تعالى: {قالَ إنيعبدُ الله}، [جملة (إني عبد الله): في محل نصب مفعول به لقال] ونحو: (أَظنُّ الأمةَ تجتمعُ بعدَ التفرُّق). [جملة (تجتمع) في محل نصب مفعول به ثان لأظن، و(الأمة): مفعوله الأول] 4- الواقعةُ مضافاً إليها. ومحلُّها الجرُّ، كقوله تعالى: {هذا يومُ ينفعُ الصادقينَ صدقُهم}. [يوم: مضاف، وجملة (ينفع الصادقين صدقهم): مضاف إليه في محل جر. والتقدير: هذا يوم نفع الصادقين صدقهم] 5- الواقعةُ جواباً لشرطٍ جازمٍ، إن اقترنت بالفاءِ أَو بإذا الفجائية. ومحلها الجزمُ، كقوله تعالى: {ومن يُضللِ اللهُ فما لهُ من هادٍ}، وقولهِ: {وإن تصِبهم سيِّئةٌ بما قدَّمت أَيديهم إذا همْ يَقنَطون}. 6- الواقعةُ صفةً، ومحلُّها بحسَبِ الموصوفِ، إمّا الرفعُ، كقولهِ تعالى: {وجاءَ من أَقصى المدينةِ رجلٌيسعى}. وإمّا النصبُ، نحو: (لا تحترمْ رجلاً يَخونُ بلادَهُ). وإمّا الجرُّ، نحو: (سَقياً لرجلٍ يَخدمُ أُمتَهُ). 7- التابعةُ لجملةٍ لها محلٌّ من الإعراب. ومحلُّها بحسب المتبوع. إمّا الرَّفعُ، نحو: (عليٌّ يقرأ ويكتبُ)، وإمّا النصبُ، نحو: (كانت الشمسُ تبدو وتخفى)، وإمّا الجرُّ، نحو: (لا تعبأ برجلٍ لا خيرَ فيهِ لنفسهِ وأمتهِ، لا خيرَ فيه لنفسهِ وأمتهِ). [علي: مبتدأ. وجملة (يقرأ): خبره. وجملة (ويكتب): في محل رفع معطوفة على جملة (يقرأ).] |
د- الجُملُ الَّتي لا مَحَلَّ لَها مِنَ الإعراب
الجملُ التي لا محلَّ لها من الإعراب تسعٌ: 1- الابتدائيةُ، وهي التي تكونُ في مُفتَتحِ الكلامِ، كقوله تعالى {إنا أعطيناك الكوثرَ}، وقولهِ: {اللهُ نور السَّمواتِ والأرض}. 2ـ الاستئنافيّةُ، وهي التي تقعُ في أثناءِ الكلامِ، منقطعةً عمّا قبلَها، لاستئنافِ كلامٍ جديدٍ، كقوله تعالى: {خلق السَّمواتِ والأرضَ بالحقِّ، تعالى عمَّا يُشركونَ}. وقد تقترنَ بالفاءِ أو الواو الاستئنافيَّتين. فالأولُ كقوله تعالى: {فلمَّا آتاهما صالحاً جعلا لهُ شركاءَ فيما آتاهما، فتعالى اللهُ عمّا يُشركون}. والثاني كقولهِ: {قالت ربِّ إني وضعتُها أُنثى، والله أعلمُ بما وضعتْ، وليس الذكر كالأنثى}. 3- التَّعليليَّة، وهي التي تقعُ في اثناء الكلامِ تعليلاً لِما قبلَها، كقوله تعالى: {وصلِّ عليهم، إنَّ صلاتَكَ سَكنٌ لهم}. وقد تقترنُ بفاءِ التَّعليل، نحو: (تمسَّك بالفضيلةِ، فإنها زينةُ العُقلاءِ). 4- الاعتراضيّةُ، وهي التي تَعترضُ بين شيئينِ مُتلازمين، لإفادة الكلام تَقويةً وتسديداً وتحسيناً، كالمبتدأ والخبر، والفعلِ ومرفوعهِ، والفعلِ ومنصوبهِ، والشرطٍ والجوابِ، والحالِ وصاحبها، والصفةِ والموصوفِ، وحرفِ الجر ومُتعلِّقه والقسمِ وجوابهِ. فالأول كقول الشاعر: وَفِيَهِنَّ، وَ الأَيامُ يَعْثُرْنَ بِالْفَتَى نَوادِبُ لا يَمْلَلْنَهُ، ونَوائحُ والثاني كقول الآخر: وَقَدْ أَدْرَكَتْني، وَالحَوادِثُ جَمَّةٌ أَسِنَّةُ قَوْمٍ لا ضِعافٍ، وَلا عُزْل والثالثُ كقولِ غيره: وَبُدِّلَتْ، وَالدَّهْرُ ذُو تَبَدُّلِ هَيْفاً دَبُوراً بِالصَّبا، وَالشَّمْأَلِ والرابعُ، كقولهِ تعالى: {فإن لم تفعلوا، ولن تفعلوا، فاتَّقُوا النارَ التي وَقُودُها الناسُ والحجارةُ}. والخامس، نحو: (سعيتُ، وربَّ الكعبةِ، مجتهداً). والسادسُ، كقوله تعالى: {وانَّهُ لَقَسمٌ، لو تعلمونَ عظيم}. والسابعُ، نحو: (اعتصِمْ، أصلحكَ اللهُ، بالفضيلة). والثامن كقول الشاعر: لَعَمْري، ومَا عَمْري عَلَيَّ بِهَيِّنٍ لَقَدْ نَطَقَتْ بُطْلاً عَلَيَّ الأَقارِعُ 5- الواقعة صِلةً للموصولِ الاسميّ، كقوله تعالى: {قد أفلحَ من تَزَكَّى}، أو الحرفيِّ، كقولهِ: {نخشى أن تُصيبنا دائرةٌ}. والمراد بالموصولِ الحرفيِّ: الحرفُ المصدريُّ، وهو يُؤوَّلُ وما بعدَه بمصدرٍ وهو ستةُ أحرفٍ: (أنْ وأنَّ وكيْ وما ولوْ وهمزة التسوية). وقد سبقَ الكلامُ عليه في أقسام الفاعل، وفي (حروف المعاني). 6- التّفسيريةُ، كقوله تعالى: {وأَسرُّوا النّجوَى}، {الذين ظلموا}، {هل هذا إلا بشرٌ مثلُكمْ} وقولهِ: {هل ادُلُّكم على تجارةٍ تُنجيكم من عذابٍ أليمٍ، تُؤمِنونَ بالله ورسوله}. والتّفسيريّةُ ثلاثةُ أقسامٍ: مجرَّدةٌ من حرف التفسيرِ، كما رأيتَ، ومقورنةٌ بأي، نحو: (أشرتُ إليه، أي أذهبْ)، ومقورنةٌ بأنْ، نحو: (كتبتُ إليهِ: أن وافِنا)، ومنه قولهُ تعالى: {فأوحينا إليه: أن اصنَعِ الفُلكَ}. 7- الواقعةُ جواباً للقسمِ، كقوله تعالى: {والقرآنِ الحكيمِ انّكَ لَمِنَ المُرْسَلين}، وقولهِ: {تاللهِ لأكيدَنَّ أصنامَكم}. 8- الواقعةُ جواباً لشرطٍ غيرِ جازمٍ: (كإذا ولو ولوا)، كقوله تعالى: {إذا جاءَ نصرُ اللهِ والفتحُ، ورأيتَ الناسَ يَدخلون في دينِ اللهِ أفواجاً، فسَبِّحْ بِحَمْدِ ربك}، وقوله: {لو أنزلنا هذا القرآن على جبلٍ، لَرأَيتهُ خاشعاً مُتصدِّعاً من خشيةِ اللهِ} وقولهِ: {ولولا دَفعُ اللهِ الناسَ بعضَهم ببعضٍ، لَفَسدتِ الأرضُ}. 9- التابعةُ لجملةٍ لا محلَّ لها من الإعراب، نحو: (إذا نَهضَتِ الأمةُ، بَلغت من المجد الغايةَ، وادركت من السُّؤْدَدِ النهايةَ). [جملة (بلغت): لا محل لها من الإعراب، لأنها جواب شرط غير جازم، وهو (إذا). وجملة (وأدركت): لا محل لها من الاعراب أيضاً، لأنها معطوفة على جملة (بلغت)] انتهى في هذا اليوم الجمعة 7 رمضان 1433هـ/ 27/7/2012م. تقديم كتاب الشيخ مصطفى غلاييني رحمه الله، (جامع الدروس العربية ـ موسوعة في ثلاثة أجزاء) والصادر عن المكتبة العصرية (صيدا/ لبنان) الطبعة الخامسة والعشرون سنة 1991. وقد تكون نُسخ إلكترونية موجودة في شبكة (النت)، لكن التقديم الذي اجتهدت فيه مدعم ببعض التلوينات المساعدة، وبعض التفسيرات ـ وإن قَلَّت ـ . |
Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.