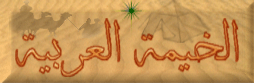
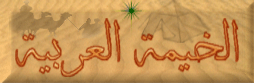 |
الوصل والفصل
من الكلمات ما لا يصح الابتداء به، كالضمائر المتصلة ومنها ما لا يصح الوقف عليه، كالحروف الموضوعة على حرفٍ واحدٍ ومنها ما يصح الابتداء به والوقف عليه، وهو كل الكلمات، إلا قليلاً منها. فما صح الابتداء به والوقف عليه، وجب فصله عن غيره في الكتابة، لأنه يستقل بنفسه في النطق، كالأسماء الظاهرة، والضمائر المنفصلة، والحروف الموضوعة على حرفين فأكثر. وما لا يصح الابتداء به، وجب وصله بما قبله، كالضمائر المتصلة، ونوني التوكيد، وعلامة التأنيث، وعلامة التثنية، وعلامة الجمع السالم. وما لا يصح الوقف عليه، وجب وصله بما قبله، كالضمائر، ونوني التوكيد، وعلامة التأنيث، وعلامة التثنية، وعلامة الجمع السالم. وما لا يصح الوقف عليه، وجب وصله بما بعده، كحروف المعاني الموضوعة على حرف واحد، والمركب المزجي، وما رُكب مع المائة من الآحاد، مثل: أربعمائة، والظروف المضافة الى (إذ) المنونة، مثل: يومئذٍ وحينئذٍ. فإن لم تنون، بأن تُذكر الجملة المحذوفة المعوض عنها بالتنوين، وجب الفصل مثل: (رأيتك حين إذ كُنتَ تخطبُ). وكلا النوعين (أي ما يصح الابتداءُ به، وما لا يصح الوقف عليه) يجب وصله، كما رأيت، لأنه لا يستقل بنفسه في النطق. والكتابة تكون بتقدير الابتداء بالكلمة والوقف عليها، كما علمت في أول فصل الخط. وقد وصلوا، في بعض المواضع، ما حق أن يكتب منفصلاً، كأنهم اعتبروا الكلمتين كلمة واحدة. وإليك تلك المواضع: 1ـ وصلوا (ما) الاسمية بكلمة (سيِّ)، مثل: (أحبُّ أصدقائي، ولا سيما زهير)، وبكلمة (نِعْمَ) إذا كُسِرَت عَينها، مثل: (نِعِما يَعِظكم به)، فإن سكنت عينها، وجب الفصل، مثل: (نِعْمَ ماَ تفعل). 2ـ ووصلوا (ما) الحرفية الزائدة أيَّا كان نوعها، بما قبلها، مثل: (طالما نصحتُ لك، إنما إلهكم إله واحدٌ، أتيتُ لكنما أسامةُ لم يأتِ، عما قليل ليصبحن نادمين، مما خطيئاتهم أُغرقوا، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أينما تجلس أجلس، إما تجتهد تنجح (إما: أصلها إن ما)، إنه لحقٌ مثلما أنكم تنطقون، اجتهد كيما تنجح. 3ـ وصلوا (ما) المصدرية بكلمة (مثل)، مثل: (اعتصم بالحق مثلما اعتصم به سلفك الصالح)، وبكلمة (ريث)، مثل: (انتظرني ريثما آتيك)، وبكلمة (حين) مثل: (جئت حينما طلعت الشمس)، وبكلمة (كل) مثل: (كلما أضاء لهم مشوا فيه. كلما زرتني أكرمتك). و (ما) بعد (كل) مصدرية ظرفية. 4ـ وصلوا (مَنْ) استفهاميةً كانت، أو موصوفية، أو شرطية، ب (مِنْ) و (عَنْ) الجارتين، فالاستفهامية مثل: (مِمَن أنت تشكو؟ وأصلها من من أنت تشكو؟). والموصولية مثل: (خُذِ العلم عمَّن تثق به). والموصوفية مثل: (عجبت ممن محب لك يؤذيك)، أي من رجل محب لك. والشرطية مثل: (ممن تبتعد أبتعد، وعمن ترضَ أرضَ). 5ـ وصلوا (لا) بكلمة (أن) الناصبة للمضارع، مثل: (لئلا يعلم أهل الكتاب: أصلها لأن لا)، و (يجب ألاَّ تدع لليأس سبيلاً الى نفسك). فإن لم تكن (أن) ناصبة للمضارع، وجب الفصل، كأن تكون مخففة من (أن) المشددة، مثل (أشهد أن لا إله إلا الله) أي أنه، أن تكون تفسيرية مثل: (قل له: أن لا تخف). 6ـ وصلوا (لا) بكلمة (إن) الشرطية الجازمة، مثل: (إلا تفعلوه تكن فتنة)، (إلا تنصروه فقد نصره الله). 7ـ منهم من يصل (لا) بكلمة (كي)، مثل: لكيلا يكون عليك حرجٌ. ومنهم من يوجب الفصل. والأمران جائزان. وقد جاء الوصل والفصل في القرآن الكريم، وقد وصلت في المصحف في أربعة مواضع منها: (لكيلا يكون عليك حرج)، ومن الفصل قوله تعالى: { لكي لا يكون على المؤمنين حرجٌ} وقوله: { كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}. |
الباب السادس
مباحث الفعل الإعرابية المبني والمعرب من الأفعال الفعل كله مبني. ولا يُعرب منه إلا ما أشبه الاسم، وهو الفعل المضارع الذي لم تتصل به نونا التوكيد ولا نون النسوة. وهذا الشبه إنما يقع بينه وبين اسم الفاعل. وهو يكون بينهما من جهتي اللفظ والمعنى. أما من جهة اللفظ، فلأنهما متفقان على عدد الأحرف والحركات والسكنات فيكتبُ على وزن (كاتب) ومُكرم على وزن (يُكرَم). وأما من جهة المعنى فلأن كلا منهما يكون للحال والاستقبال وباعتبار هذه المشابهة يسمى هذا الفعل (مضارعا)، أي مشابهاً، فإن المضارعة معناها المشابهة، يقال: (هذا يضارع هذا) أي يشابهه. فإن اتصلت به نون التوكيد، أو نون النسوة، بُني، لأن هذه النونات من خصائص الأفعال، فاتصاله بهن يبعد شبهه باسم الفاعل فيرجع الى البناء الذي هو أصل في الأفعال. بناء الفعل الماضي يُبنى الماضي على الفتح، وهو الأصل في بنائه، مثل: (كَتَبَ). فإن كان معتل الآخر بالألف، مثل (رمى) و (دعا) بُني على فتح مقدر على آخره. فإن اتصلت به تاء التأنيث، حُذف آخره، لاجتماع الساكنين: الألف والتاء، مثل: (رمتْ ودعتْ) والأصل (رمات ودعات). ويكون بناؤه على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. وإن كان معتل الآخر بالواو أو الياء، فهو كالصحيح الآخر ـ مبني على فتح ظاهر، مثل عفوَت ورضيَت. ويُبنى على الضم إن اتصلت به واو الجماعة، لأنها حرف مد وهو يقتضي أن يكون قبله حركة تجانسه، فيبنى على الضم لمناسبة الواو، مثل: (كتبوا). فإن كان معتل الآخر، بالألف، حذفت لالتقاء الساكنين، وبقي ما قبل الواو مفتوحاً، مثل: (رموا ودعوا) والأصل (رماوا ودعاوا) ويكون حينئذٍ مبنيا على ضم مقدر على الألف المحذوفة. وإن كان معتل الآخر بالواو، أو الياء، حذف آخره وضم ما قبله بعد حذفه، ليناسب واو الجماعة، مثل: (دُعُوا وسُرُوا ورَضُوا) والأصل (دعيوا وسرووا ورضيوا) استثقلت الضمة على الواو والياء فحذفت، دفعا للثقل، فاجتمع ساكنان: حرف العلة وواو الجماعة، فحذف حرف العلة، منعا لالتقاء الساكنين، ثم حرك ما قبل واو الجماعة بالضم ليناسبها. فبناء مثل ما ذكر، إنما هو ضم مقدر على حرف العلة المحذوف لاجتماع الساكنين، فليست حركة ما قبل الواو هنا حركة بناء الماضي على الضم وإنما هي حركة اقتضتها المناسبة للواو، بعد حذف الحرف الأخير. الذي يحمل ضمة البناء. ويبنى على السكون إن اتصل به ضمير رفع متحرك، كراهية اجتماع أربع حركات متواليات فيما هو كالكلمة الواحدة، مثل: كَتَبْتُ وكتبتَ وكتبتِ وكتبنَ وكتبنا. (وذلك لأن الفعل والفاعل المضمر المتصل كالشيء الواحد، وإن كانا كلمتين، لأن الضمير المتصل بفعله يحسب كالجزء منه. وأما نحو: (أكرمت واستخرجت) مما لا تتوالى فيه أربع حركات، إن بُني على الفتح مع الرفع المتحرك ((فقد حمل في بنائه على السكون على ما تتوالى فيه الحركات الأربع، لتكون قاعدة بناء الماضي مطردة)) وإذا اتصل الفعل المعتل الآخر بالألف، بضمير رفع متحرك، قلبت ألفه ياء، إن كانت رابعة فصاعداً، أو كانت أصلها الياء. مثل: (أعطيت واستحييتُ وأتيتُ). فإن كانت ثالثة أصلها الواو رُدَّت إليها، مثل: علوت وسموتُ. فإن كان معتل الآخر بالواو أو الياء، بقي على حاله، مثل: سروت ورضيتُ. |
بناء الأمر
يُبنى الأمر على السكون وهو الأصل في بنائه، وذلك إن اتصل بنون النسوة، مثل: اكتبن، أو كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، مثل: اكتبْ. وعلى حذف آخره، إن كان معتل الآخر، ولم يتصل به شيء، مثل: انج واسع وارمِ. وعلى حذف النون، إن كان متصلاً بألف الاثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة، مثل: اكتبا و اكتبوا واكتبي. وعلى الفتح، إن اتصلت به إحدى نوني التوكيد: اكتُبَنْ واكتُبَنَّ. وإذا اتصلت نون التوكيد المشددة بضمير التثنية، أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة في الأمر ثبتت الألف معها، وكسرت النون مثل: (اكتبانِّ) [ اكتبان: فعل أمر مبني على حذف النون. والألف ضمير الفاعل والنون المشددة حرف توكيد]. وحذفت الواو والياء، حذراً من التقاء الساكنين، مثل: اكتبُنَّ واكتِبِنَّ. [اكتبن الأولى فعل مبني على حذف النون. والواو المحذوفة، لالتقاء الساكنين ضمير الفاعل. والنون المشددة حرف توكيد]. و[اكتبن الثانية فعل مبني على حذف النون. والياء المحذوفة، لالتقاء الساكنين ضمير الفاعل. والنون المشددة حرف توكيد]. ويبقى الأمر مبنياً على حذف النون. والضمير المحذوف لالتقاء الساكنين هو الفاعل. وكذا إن اتصلت النون المخففة بالواو أو الياء، مثل: اكتُبنْ واكتبِن. أما بالألف فلا تتصل، فلا يقال (اكتبان). |
إعراب المضارع وبناؤه
إذا انتظم الفعل المضارع في الجملة، فهو إما مرفوع أو منصوب أو مجزوم. وإعرابه إما لفظي، وإما تقديري، وإما محلي. وعلامة رفعه الضمةُ ظاهرةً، مثل: (يفوزُ المتقون)، أو مقدرة، مثل: (يعلو قدرُ من يقضي بالحق)، ومثل: (يخشى العاقل ربه). وعلامة نصبه الفتحة، ظاهرةً، مثل: (لن أقولَ إلا الحق)، أو مقدرة، مثل: (لن أخشى إلا الله). وعلامة جزمه السكون، مثل: { لم يلدْ ولم يولدْ } وإنما يُعرب المضارع بالضمة رفعاً، وبالفتحة نصباً، وبالسكون جزماً إن كان صحيح الآخر، ولم يتصل بآخره شيء. فإن كان معتل الآخر غير متصل به شيء جزم بحذف آخره، مثل: (لم يسعَ، ولم يرمِ، ولم يدعُ). وتكون علامة جزمه حذف الآخر. وإن اتصل بآخره ضمير التثنية أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة، فهو معرب بالحرف، بالنون رفعاً، مثل: (يكتبان ويكتبون وتكتبين) وبحذفها جزماً ونصباً، مثل: ( إن يلزموا معصية الله، فلن يفوزوا برضاه). وإن اتصلت به إحدى نوني التوكيد، أو نون النسوة، فهو مبني، مع الأوليين على الفتح، مثل: (يَكتُبَنْ و يكتَبنَّ)، ومع الثالثة على السكون، مثل: (الفتيات يكتبْنَ: ويكون رفعه ونصبه وجزمه حينئذٍ محلياً). فإن لم يتصل آخره بنون التوكيد مباشرة بل فصِل بينهما بضمير التثنية، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة، لم يكن مبنياً، بل يكون معرباً بالنون رفعاً وبحذفها نصباً وجزماً. ولا فرق بين أن يكون الفاصل لفظياً، مثل: (يكتبان: هنا فعل مضارع، مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال [أي النونات الثلاث] والألف ضمير الفاعل). أو تقديرياً، مثل: (يكتبُنَّ وتكتُبِنَّ: وهنا كل منهما فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال [أي النونات الثلاث] والواو المحذوفة من (يكتبن)، لالتقاء الساكنين، هما ضمير الفاعل). لأن الأصل (تكتبونَنَّ وتكتُبينَنَّ). واعلم أن نون التوكيد المشددة، إن وقعت بعد ألف الضمير، ثبتتِ الألف وحُذفت نون الرفع، دفعاً لتوالي النوناتِ، غير أن نون التوكيد تُكسر بعدها تشبيهاً لها بنون الرفع، دفعاً لتوالي النونات، غير أن نون التوكيد تُكسر بعدها تشبيهاً لها بنون الرفع بعد ضمير المثنى، مثل: (يَكتُبانِّ). وإن وقعت بعد واو الجماعة، أو ياء المخاطبة، حذفت نون الرفع دفعاً لتوالي الأمثال. أما الواو والياء، فإن كانت حركة ما قبلهما الفتح ثبتتا، وضُمت واو الجماعة، وكُسرت ياء المخاطبة، وبقي ما قبلهما مفتوحاً على حاله، فنقول في يخشَوْن وتَرَضين: ( تَخشَوُنَّ وتَرضِينَ). وإن كان ما قبل الواو مضموماً، وما قبل الياء مكسوراً حُذِفتا. حذراً من التقاء الساكنين، وبقيت حركةُ ما قبلهما، فتقول في تكتُبونَ وتكتُبينَ وتغزونَ وتغزين: ( تكتُبنَّ وتكتِبنَّ وتغزُنَّ وتغزِنَّ). وإذا وَلي نون النسوة نون التوكيد المشددة وجب الفصل بينهما بألفٍ، كراهية توالي النونات، مثل: (يكتبْنانِّ) أما النون المخففة فلا تلحق نون النسوة. وحكم نوني التوكيد، مع فعل الأمر، كحكمهما مع المضارع في كل ما تقدم. المضارع المرفوع يُرفع المضارع، إذا تجرد من النواصب والجوازم. ورافعه إنما هو تجرده من ناصب أو جازم. فالتجرد هو عامل الرفع فيه، فهو الذي أوجب رفعه. وهو عامل معنوي، كما أن العامل في نصبه وجزمه هو عامل لفظي لأنه ملفوظ. وهو يُرفع إما لفظاً، وإما تقديراً، كما سلف، وإما محلاً، إن كان مبنياً، مثل: (لأجتهدنَّ) ومثل: (الفتياتُ يجتهدْن) [ لأجتهدن: اللام لام جواب القسم: وأجتهدن: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. وهو مرفوع محلاً لتجرده من النواصب والجوازم] فاعله ضمير مستتر تقديره أنا. ونون التوكيد الثقيلة. والفتيات يجتهدن: الفتيات مبتدأ، ويجتهدن فعل مضارع مبني على السكون، لاتصاله بنون النسوة، وهو مرفوع محلاً، لتجرده من النواصب والجوازم، ونون النسوة. ضمير الفاعل وهو مبني على الفتح. وهو محل رفع لأنه فاعل. والجملة خبر المبتدأ. |
المضارع المنصوب ونواصبه
يُنصب المضارع إذا سبقته إحدى النواصب. وهو يُنصب إما لفظاً، وإما تقديراً، كما سلف، وإما محلاً، إن كان مبنياً، مثل: (على الأمهاتِ أن يعتنينَ بأولادهنَّ). [ يعتنين: فعل مضارع مبني على السكون، لاتصاله بنون الإناث، وهذه النون، هي: ضمير الفاعل]. ونواصب المضارع أربعة أحرف هي: أن؛ و لن؛ و إذن؛ و كي. 1ـ أن: حرف مصدرية ونصب واستقبال، مثل: { يريدُ الله أن يُخففَ عنكم}. وسميت مصدرية، لأنها تجعل ما بعدها في تأويل مصدر، ففي الآية السابقة: تأويلها: يريد الله التخفيف عنكم. وسميت نصب، لنصبها المضارع. وسميت حرف استقبال، أي تجعله للاستقبال المحض وتخلصه له. ولا تقع بعد فعلٍ بمعنى اليقين والعلم الجازم. فإن وقعت بعد ما يدل على اليقين، فهي مُخففةٌ من (أنَّ)، والفعل بعدها مرفوع، مثل: { أفلا يَرَوْنَ أن لا يرجعُ إليهم قولاً}. أي أنه لا يرجع. وإن وقعت بعد ما يدل على ظن أو شبهه، جاز أن تكون ناصبة أو رافعة. وقد قُرئت الآية { وحسبوا ألا تكونَ فتنةٌ} بالنصب والرفع تكونَ وتكونُ. 2ـ لن: وهي حرف نفي ونصب واستقبال، وهي في نفي المستقبل كالسين وسوف في إثباته. وهي تفيد تأكيد النفي لا تأييده وأما قوله تعالى: { لن يخلُقوا ذباباً} فمفهوم التأييد ليس من (لن)، وإنما هو من دلالة خارجية، لأن الخلق خاص بالله وحده. 3ـ إذن: وهي حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال، تقول: (إذن تُفلحَ)، جواباً لمن قال (سأجتهد). وقد سميت حرف جواب لأنها تقع في كلام يكون جواباً لكلام سابق. وسميت حرف جزاء، لأن الكلام الداخلة عليه يكون جزاء لمضمون الكلام السابق. وقد تكون للجواب المحض الذي لا جزاء فيه، كأن تقول لشخص (إني أحبك) فيقول: (إذن أظنك صادقاً)، فظنه الصدق فيك ليس فيه معنى الجزاء لقولك (إني أحبك). شروط نصب إذن للمضارع الأول: أن تكون في صدر الكلام، أي صدر جملتها. بحيث لا يسبقها شيءٌ له تعلق بما بعدها. وذلك كأن يكون ما بعدها خبراً لما قبلها مثل: (أنا إذن أكافئُكَ) أو جواب شرط، مثل: (إن تزرني إذن أزرك)، أو جواب قَسَم مثل: (والله إذن لا أفعلُ) فإن قلت (إذن واللهِ لا أفعلَ)، فقدمت (إذن) على القسم، نصبت الفعل لتصدرها في صدر الجملة. وإذا سبقتها الواو أو الفاء، جاز الرفع وجاز النصب. والرفع هو الغالب. ومن النصب قوله تعالى { وإن كادوا ليستفزونَك من الأرضِ ليخرجوك منها، وإذاً لا يلبثوا خلافك إلا قليلا} وقوله {أم لهم نصيب من الملك، فإذاً لا يؤتوا الناس نقيرا} [ في قراءة غير السبعة] ومن قراءات السبعة { وإذاً لا يلبثون... وإذاً لا يؤتون}. الثاني: أن يكون الفعل بعدها خالصاً للاستقبال. فإن قلت: إذن أظنُكَ صادقاً، جوابا لمن قال لك إني أحبك، رفعت الفعل لأنه للحال. الثالث: ألا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل غير القسم و (لا) النافية، فإن قلت: (إذن هم يقومون بالواجب) جواباً لمن قال: (يجود الأغنياء بالمال في سبيل العلم، كان الفعل مرفوعاً، للفصل بينهما بغير الفواصل الجائزة. ومثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك: (إذن أنتظرَك)، في جواب من قال لك (سأزورك) فإذن هنا مصدرة والفعل خالص للاستقبال وليس بينها وبينه فاصل. 4 ـ كي: وهي حرف مصدرية ونصب واستقبال. فهي مثل (أنْ)، تجعل ما بعدها في تأويل مصدر. فإذا قلت: (جئتُ لكي أتعلمَ) فالتأويل ـ جئت للتعلم وما بعدها مؤول بمصدرٍ مجرورٍ باللام. والغالب أن تسبقها لام الجر المفيدة للتعليل، مثل: { لكيلا تأسوا على ما فاتكم}. فإن لم تسبقها، فهي مُقدرة، مثل: (استقم كي تُفلحَ) ويكون المصدر المؤول حينئذ في موضع الجر باللام المقدرة، أو يكون منصوباً على نزع الخافض. |
النصب بأن مُضمرة
قد اختصت (أن) من بين أخواتها بأنها تنصبُ ظاهرةً، مثل: {يُريد الله أن يُخففَ عنكم}، ومقدرةً، مثل: {يُريدُ اللهُ ليُبينَ لكم} أي لأن يبين لكم. وإضمارها على ضربين: جائزٍ وواجب. أـ إضمار (أن) جوازاً: تقدَّر (أن) جوازاً بعد ستةِ أحرفٍ: 1ـ لام كي ( وتسمى لام التعليل أيضاً، وهي اللام الجارَّة، أي التي يكون ما بعدها علةً لما قبلها وسبباً له، فيكون ما قبلها مقصوداً لحصول ما بعدها، مثل: {وأنزلنا إليك الذكر لتبينَ للناس} أي لأجل أن تبين. فإنزال الذكر مقصود للتبيين. وإنما يجوز إضمار (أن) بعدها إذا لم تقترن بلا النافية أو الزائدة. فإن اقترنت بإحداهما، وجب إظهارها. فالنافية مثل: { لئلا يكونَ للناس على الله حجة} والزائدة مثل: { لئلا يعلم أهل الكتاب}. 2ـ لام العاقبة، وهي اللام الجارَّة التي يكون ما بعدها عاقبة لما قبلها ونتيجة له، لا علة في حصوله، وسبباً في الإقدام عليه، كما في لام كي. وتُسمى لام الصيرورة، ولام المآل، ولام النتيجة أيضاً، مثل: { فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً} 3و4و5و6 ـ الواو والفاء وثم و أو العاطفات: إنما يُنصب الفعل بعدهن بأن مضمرة، إذا لزم عطفه على اسمٍ محض، أي جامد غير مشتق، وليس في تأويل الفعل، كالمصدر وغيره من الأسماء الجامدة، لأن الفعل لا يُعطف إلا على الفعل، أو على اسمٍ هو في معنى الفعل وتأويله، كأسماء الأفعال والصفات التي في الفعل فإن وقع الفعل في موضع اقتضى فيه عطفه على اسم محض قُدرت (أن) بينه وبين حرف العطف، وكان المصدر المؤول بها هو المعطوف على اسمٍ قبلها. مثال الواو: (يأبى الشجاعُ الفرار ويسلمَ) أي وأن يسلم. والتأويل: يأبى الفرار والسلامة. ومثل: (لولا الله ويلطفَ بي لهلكت) أي وأن يلطُف بي. والتأويل: لولا الله ولطفه بي. وقول ميسون البدوية التي تزوجها معاوية ولُبس عباءةٍ وتقرَّ عيني أحبُّ إليَّ من لُبس الشفوف ومثال الفاء: (تَعبُك، فتنالَ المجد، خير من راحتك فتحرمَ القصدَ) ومثال ثم: (يرضى الجبانُ بالهوان ثم يسلمَ) ومثال أو: (الموتُ أو يبلغَ الإنسان مأمله أفضلُ)، وقوله تعالى { ما كان لبشرٍ أن يكلمه الله إلا وحياً، أو من وراء حجاب، أو يُرسلَ رسولا}. ب ـ إضمار (أن) وجوباً: تُقدر (أن) وجوباً بعد خمسة أحرف 1ـ لام الجحود، وسماها بعضهم لام النفي، وهي لام الجر التي تقع بعد ( ما كان) أو (لم يكن) الناقصتين، مثل قوله تعالى { ما كان الله ليظلمَهم} و قوله {لم يكن الله ليغفرَ لهم}. 2ـ فاء السببية، مثل قوله تعالى { كُلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحلَّ عليكم غضبي} أي أنه بسبب طغيانكم حل غضبه تعالى. 3ـ واو المعية، كقول الشاعر: لا تنهَ عن خُلقٍ وتأتيَ مثلَهُ عارٌ عليك، إذا فعلتَ عظيمُ 4ـ حتى: وهي حتى الجارَّة التي بمعنى (إلى) أو لام التعليل. فالأول مثل: (قالوا: لن نبرحَ عليه عاكفين حتى يَرجعَ إلينا موسى) أي الى أن يرجع. والثاني: (أطع الله حتى تفوزَ برضاه)، أي لتفوز برضاه. 5ـ أو. ولا تضمر بعدها (أن) إلا أن يصلح في موضعها (الى) أو (إلا) الاستثنائية، فالأول مثل قول الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدركَ المُنى فما انقادت الآمال إلا لصابرِ أي الى أن أدرك المنى، والثاني كقول الآخر: وكنت إذا غمزت قناة قومٍ كسرت كعوبها أو تستقيما أي الى أن تستقيم شذوذ حذف أن قد يرفع الفعل بعد حذف (أن) المضمرة، كقوله تعالى { ومن آياتهِ يُريكُم البرقَ خوفاً وطمعاً} وقوله { قل أفغير الله تأمروني أعبُدُ} والأصل: أن يريَكم وأن أعبدَ. |
المُضارع المجزوم وجوازمه
يُجزم المضارع إذا سبقته إحدى الجوازم. وهي قسمان: قسم يجزم فعلاً واحداً، مثل: ( لا تيأسْ من رحمة الله) وقسم يجزم فعلين، مثل: (مهما تفعلْ تُسألْ عنه). وجزمه إما لفظي، إن كان معرباً، كما مُثّل، وإما محلي، إن كان مبنياً، مثل: (لا تشتغلنَّ بغير النافع). وتشتغلن: فعل مضارع مبني على الفتحة، وهو في محل جزم بلا الناهية. الجازم فعلاً واحداً الجازم فعلاً واحداً أربعةُ أحرفٍ وهي (لم ولما ولام الأمر ولا الناهية) وشرحها: لم ولما: تسميان حرفي نفي وجزم وقلب، لأنهما تنفيان المضارع، وتجزمانه، وتقلبانِ زمانه من الحال أو الاستقبال الى المضي، فإن قلتَ: (لم أكتبْ) أو ( لما أكتبْ)، كان المعنى أنك ما كتبتَ فيما مضى. والفرق بين (لم ولما) من أربعة أوجهٍ: 1ـ أنَّ (لم) للنفي المُطلق، فلا يجب استمرارُ نفي مصحوبها الى الحال، بل يجوز الاستمرار، كقوله تعالى: { لم يلدْ ولم يولدْ}، ويجوز عدمه، ولذلك يصح أن تقول: ( لم أفعلْ ثُمَّ فعلت). وأما (لما) فهي للنفي المستغرق جميع أجزاء الزمن الماضي، حتى يتصل بالحال، ولذلك لا يصح أن تقول: (لمّا أفعل ثم فعلت)، لأن معنى قولك (لما أفعل) أنك لم تفعل حتى الآن، وقولك (ثم فعلت) يُناقض ذلك. لهذا تُسمى (حرف استغراق) أيضاً لأن النفي بها يستغرق الزمان الماضي كله. 2ـ أن المنفي بلم لا يتوقع حصوله، والمنفيّ للمّا مُتوقع الحصول، فإذا قلتَ: (لما أسافرْ) فسفركَ مُنتظرٌ. 3ـ يجوز وقوع (لم) بعد أداةِ شرط، مثل: (إن لم تجتهد تندم)، ولا يجوز وقوع (لما) بعدها. 4ـ يجوز حذف مجزوم (لما)، مثل: (قاربت المدينة ولما) أي (ولما أدخلها). ولا يجوز ذلك في مجزوم (لم)، إلا في الضرورة، كقول الشاعر: احفظ وديعتك التي استودعتها يوم الأعازبِ، إن وصلت وإن لم أي: وإن لم تصل. فوائد 1ـ لما، الداخلة على الفعل الماضي، ليست نافية جازمة، وإنما هي بمعنى (حين) فإذا قلت (لما اجتهد أكرمته). فالمعنى: حين اجتهد أكرمته. ومن الخطأ إدخالها على المضارع إذا أريد بها معنى (حين)، فلا يقال (لما يجتهد أكرمه) بل الصواب أن يقال: (حين يجتهد)، لأنها لا تسبق المضارع إلا إذا كانت نافية جازمة. 2ـ لام الأمر مكسورة، إلا إذا وقعت بعد الواو والفاء فالأكثر تسكينها، مثل: فلْيستجيبوا لي ولْيؤمنوا بي. وقد تسكن بعد (ثم). 3ـ تدخل لام الأمر على فعل الغائب معلوما ومجهولاً، وعلى المخاطب والمتكلم المجهولين: وتدخل (لا) الناهية على الغائب والمخاطب معلومين ومجهولين. وعلى المتكلم المجهول. ويقِل دخولهما على المتكلم المفرد المعلوم. فإن كان مع المتكلم غيره، فدخولهما عليه أهون وأيسر، مثل: (ولْنحمل خطاياكم). 4ـ اعلم أن طلب الفعل أو تركه، إن كان من الأدنى الى الأعلى، سُمي (دعاء) تأدباً. وسميت اللام و (لا) حرفي دعاء، مثل: (ليقضِ علينا ربك) ومثل: { لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا} وكذلك الأمر بالصيغة يسمى فعل دعاء، { ربِّ اغفر لي}. |
الجازم فعلين
الذي يجزم فعلين ثلاث عشرة أداة. هي: 1ـ إنْ، مثل: { إنْ تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبْكم به الله} وهي أُمُّ الباب. وغيرها مما يجزم فعلين إنما جزمها لتضمنه معناها. فإن قلت: (من يزرني أكرمْه)، فالمعنى: (إن يزرْني أحدٌ أُكرمْه)، ولذلك بُنيت أدوات الشرط لتضمنها معناها. 2ـ إذ، ما: كقول الشاعر: وإنَّك إذْ، ما تأتِ ما أنت آمرٌ به تُلفِ مَنْ إياه تأمرُ آتيا 3ـ مَنْ: وهي اسم مبهم للعاقل، مثل: (مَنْ يفعلْ سوءاً يُجزَ به) 4ـ ما: وهي اسم مبهم لغير العاقل، مثل: { وما تفعلوا من خيرٍ يعلمْه الله} 5ـ مهما: وهي اسم مبهم لغير العاقل أيضاً، مثل: { وقالوا: مهما تأتنا به من آيةٍ لتسحرنا بها، فما نحن لك بمؤمنين} ومهما مركبة من (مه: ومعناها: أكفف) فعل للزجر والنهي، وما متضمنة معنى الشرط. 6ـ متى: وهي اسم زمان تضمن معنى الشرط، كقول الشاعر: متى تأته تعشو الى ضوء ناره تجد خير نارٍ، عندها خير موقد لا يحسبن أحدٌ أن (يعشو) جواباً للشرط، بل هي فعل مضارع مرفوع، وجملته حال من فاعل تأت، أي: متى تأته عاشياً. أما جواب الشرط فهو (تجد) تحتها خط. وقد تلحق (ما) الزائدة ب (متى) للتوكيد، كقول الشاعر: متى ما تلقني، فَرْدَينِ، ترْجفْ روانفُ أليتيْكَ وتُستطارا الروانف: جمع رانفة، وهي أسفل الألية الذي يلي الأرض عند القعود. والألية بفتح الهمزة لا بكسرها كما هو الشائع على الألسنة. وتُستطار: تذعر وتخاف. 7ـ أيَّان: وهي اسم زمان تضمن معنى الشرط كقول الشاعر: أيانَ نُؤمنْكَ، تأمنْ غيرنا، وإذا لم تدركِ الأمنَ منا لم تزل حَذِرا وكثيراً ما تلحقها (ما) الزائدة للتوكيد، كقول الشاعر: إذا النعجةُ الأدماءُ باتت بقفرةٍ فأيان ما تعدلْ به الريحُ ينزلِ المقصود بالنعجة الأدماء: هي نعجة الرمل أو البقرة الوحشية والأدماء هي السمراء. 8ـ أين: وهي اسم مكان تضمن معنى الشرط، مثل: (أينَ تنزلْ أنزلْ)، وكثيراً ما تلحقها (ما) الزائدة للتوكيد، مثل: (أينما تكونوا يدرككم الموت). 9ـ أنَّى: ولا تلحقها (ما)، وهي اسم مكان تضمن معنى الشرط، كقول الشاعر: خليليَّ، أنى تأتيانيَ تأتيا أخاً غير ما يُرضيكما لا يحاولُ 10ـ حيثما: وهي اسم مكانٍ تضمن معنى الشرط، ولا تجزم إلا مقترنة بما، على الصحيح، كقول الشاعر: حَيْثُما تستقِمْ يُقَدِّرْ لكَ اللهُ نجاحاً في غابرِ الأزمانِ 11ـ كيفما: وهي اسمٌ مُبهمٌ تضمن معنى الشرط، فتقتضي شرطاً وجواباً مجزومين عند الكوفيين، سواءٌ ألحقتها (ما) مثل: كيفما تكنْ يكنْ قرينُكَ، أم لا، مثل: (كيف تجلسْ أجلسْ). أما البصريون فهي عندهم بمنزلة (إذ)، تقتضي شرطاً وجزاءً، ولا تجزمُ، فهما بعدها مرفوعان غير أنها بالاتفاق تقتضي فعلين متفقي اللفظ والمعنى. 12ـ أي: وهي اسمٌ مبهمٌ تضمن معنى الشرط. وهي، من بين أدوات الشرط، مُعربة بالحركات الثلاث، لملازمتها الإضافة الى المفرد، التي تبعدها من شبه الحرف، الذي يقتضي بناء الأسماء، فمثالها مرفوعة: (أيُّ امرئٍ يخدمْ أمتهُ تخدمْهُ)،[أيُّ: مرفوعة، لأنها مبتدأ والجملة بعدها خبر]. ومثالها منصوبة: قوله تعالى: {أيَّا ما تدعو فَلَهُ الأسماءُ الحسنى}، [أياً: منصوبة لأنها مفعول به مقدم لتدعو]. ومثالها: مجرورة: بأي قلم تكتبْ أكتبْ، [بأي: ب حرف جر وأي مجرورة بها]. و (كتابَ أيٍ تقرأْ أقرأْ)، [كتاب: مضاف، وأي مضاف إليه مجرور بالإضافة]. ويجوز أن تلحقها (ما) الزائدة للتوكيد، كقوله تعالى: { أيما الأجلين قضيتُ فلا عدوان علي}. 13ـ إذا: وقد تلحقها (ما) الزائدة للتوكيد، فيقال ( إذا ما)، وهي اسم زمان تضمن معنى الشرط. ولا تجزم إلا في الشعر، كقول الشاعر: إستغنِ، ما أغناكَ ربُّكَ، بالغِنى وإذا تُصبْكَ خصاصةٌ فتجملِ |
الشَّرطُ والجواب يجب في الشرط أن يكون فعلاً خبرياً، مُتصرفاً، غيرَ مُقترنٍ بقد، أو لن، أو ما النافية، أو السين أو سوف. فإن وقع اسمٌ بعد أداةٍ من أدوات الشرط، فهناك فعلٌ مُقدر، كقوله تعالى { وإن أحدٌ من المشركين استجاركَ فأجِرْهُ} فأحدٌ: فاعل لفعلٍ محذوف، هو فعل الشرط. وجملة (استجارك) المذكورة مُفَّسرةٌ للفعل المحذوف. المُراد بالفعل الخبري ما ليس أمراً، ولا نهياً ولا مسبوقاً بأداة من أدوات الطلب ـ الاستفهام والعرضِ والتحضيض ـ فلذلك كلُّه لا يقع فعلاً للشرط. والأصل في جواب الشرط أن يكون كفعل الشرط. أي الأصل فيه أن يكون صالحاً لأن يكون شرطاً. غير أنه قد يقع جواباً ما هو غير صالحٍ لأن يكون شرطاً. فيجب حينئذٍ اقترانه بالفاء لتربطه بالشرط، بسبب فقد المناسبة اللفظية حينئذٍ بينهما. وتكون الجملة برمتها في محل جزمٍ على أنها جواب الشرط. وتُسمى هذه الفاء (فاء الجواب)، لوقوعها في جواب الشرط، و (فاء الربط)، لربطها الجواب بالشرط. مواضع ربط الجواب بالفاء يجب ربط جواب الشرط بالفاء في اثني عشرَ موضعاً. 1ـ أن يكون الجواب جملة اسمية، مثل { وإن يمسسكَ بخيرٍ فهو على كل شيء قدير} 2ـ أن يكون فعلاً جامداً، مثل { إن ترَني أنا أقلَّ منك مالاً وولداً، فعسى ربِّي أن يؤتيني خيراً من جَنَتكَ}. 3ـ أن يكون فعلاً طلبياً، مثل { قُلْ إن كنتم تُحبون اللهَ، فاتَّبعوني يُحببكم الله} 4ـ أن يكون ماضياً لفظاً ومعنىً، وحينئذٍ يجب أن يكون مقترناً بقد ظاهرةً، مثل: {إن يسرق، فقد سرقَ أخٌ له من قبل} أو مُقدرة، مثل: {إن كان قميصه قُدَّ من قُبُلٍ فصدقت} أي: فقد صدقت. 5ـ أن يقترن بقد، مثل (إن تذهب فقد أذهب). 6ـ أن يقترن بما النافية، مثل {فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر} 7ـ أن يقترن بِلَنْ، مثل { وما تفعلوا من خيرٍ فَلَنْ تُكفَروه} 8ـ أن يقترن بالسين، مثل { ومن يستنكف عن عبادته ويستكبرْ، فسيحشرهم إليه جميعاً} 9ـ أن يقترن بسوفَ، مثل { وإن خِفْتُم عَيْلةً، فسوف يُغنيكم الله من فضله} [العيلة: الفقر]. 10ـ أن يُصدَّر بِرُبَّ، مثل ( إن تجيء فربما أجيءُ). 11ـ أن يُصدَّر بكأنما، مثل { إنه من قَتَلَ نفساً بغير نفسٍ، أو فسادٍ في الأرضِ، فكأنما قتل الناس جميعاً} 12ـ أن يُصدَّر بأداة شرط، مثل { وإن كان كبُر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نَفَقاً في الأرض أو سُلَّماً في السماء فتأتيهم بآيةٍ} [ جملة (فإن استطعت) في محل جزم على أنها جواب الشرط الأول. وجواب الشرط الثاني محذوف والتقدير: إن استطعت فافعل]. |
حذف فعل الشرط
قد يُحذف فعل الشرطِ بعد (إن) المُردفة بلا، مثل: (تكلم بخير، وإلا فاسكت) وقد يكون ذلك بعد مَن مردفة بلا، كقولهم (مَنْ يُسلم عليك فسلم عليه، ومن لا، فلا تعبأ به) ومما يُحذف فيه فعل الشرط أن يقع الجوابُ بعد الطلب، مثل: (جُدْ تسُدْ) والتقدير (جُدْ، فإن تجد تسُد). حذف جواب الشرط يُحذف جواب الشرط إن دل عليه دليل، بشرط أن يكون الشرطُ ماضياً لفظاً، مثل: (أنت فائزٌ إن اجتهدتَ)، أو مضارعاً مقترناً بلم، مثل: (أنت خاسرٌ إن لم تجتهد). ولا يجوز أن يُقال: (أنت فائزٌ إن تجتهد)، لأن الشرط غير ماضٍ، ولا مقترن بلم. ويُحذف إما جوازاً، وإما وجوباً. فيحذف جوازاً، إن لم يكن في الكلام ما يصلح لأن يكون جواباً، وذلك بأن يُشعر الشرط نفسُهُ بالجواب، مثل { فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلما في السماء}. أي إن استطعت فافعل، أو بأن يقع الشرط جواباً لكلام، كأن يقول قائل: (أتُكرمُ سعيداً؟) فتقول: (إن اجتهد) أي إن اجتهد أكرمه. ويُحذف وجوباً، إن كان ما يدل عليه جواباً في المعنى. ولا فرق بين أن يتقدم الدال على جواب الشرط، مثل: (أنت فائزٌ إن اجتهدتَ) أو يتأخر عنه، كأن يتوسط الشرط بين القسم وجوابه، مثل: (والله، إن قمتَ لا أقوم) أو يكتنفه، كأن يتوسط الشرط بين جزئي ما يدل على جوابه مثل: (أنتَ، إن اجتهدتَ، فائزٌ). حذف الشرط والجواب معاً قد يُحذف الشرط والجواب معاً، وتبقى الأداة وحدها، إن دل عليهما دليل، وذلك خاصٌ بالشعر للضرورة، كقول الشاعر: قالت بناتُ العم: يا سلمى، وإن كان فقيراً معدماً؟ قالت: وإن وقول الشاعر: فإن المَنيَّة، من يخشها فسوف تصادفه أينما الجزم بالطلب إذا وقع المضارع جواباً بعد الطلب يُجزم، كأن يقع بعد أمرٍ أو نهيٍ، أو استفهام أو عرض، أو تحضيض، أو تمنٍ أو ترجٍ، مثل: (تعلم تفزْ، لا تكسل تَسُدْ. هل تفعلْ خيراً، تؤجرْ. ألا تزورنا تكن مسروراً. هلا تجتهد تنلْ خيراً، ليتني اجتهدتُ أكنْ مسرورا، لعلك تطيع الله تفزْ بالسعادة). وجزم الفعل بعد الطلب، إنما هو بإن المحذوفة مع فعل الشرط. فتقدير قولك: جُدْ تسُدْ: وتعني جُدْ فإن تَجُدْ تسُدْ. وتقدير قولك: هل تفعل خيراً؟ تؤجرْ. وتقديرها: هل تفعل خيراً؟ فإن تفعل خيراً تؤجر. والطلب لا يُشترط فيه أن يكون بصيغة الأمر، أو النهي، أو الاستفهام، أو غيرها من الصيغ الطلب. بل يُجزم الفعل بعد الكلام الخَبَريّ. إن كان طلباً في المعنى، كقولك: (تُطيع أبويكَ، تلقَ خيراً). أي أطعهما تلقَ خيراً. ومنه قولهم: اتقى اللهَ امرؤٌ فعل خيراً، يُثَبْ عليه). ومن ذلك قوله تعالى: { هل أدلكم على تجارة تُنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم}، أي: آمنوا وجاهدوا يغفر لكم ذنوبكم. ـ لا يُجزم الفعل بعد الطلب إلا إذا قُصِد الجزاءُ. بأن يُقصد بيان أن الفعل مسببٌ عما قبله، كما أن جزاء الشرط مُسببٌ عن الشرط. فإن لم يُقصد ذلك، وجبَ الرفع إذ ليس هناك شرطٌ مُقدر، ومنه قوله تعالى: { ولا تمنن تستكثر} وقوله: {فاضرب لهم طريقاً في البحر يَبَسَاً، لا تخافُ دَرَكَاً ولا تَخشى} وقوله: {خُذْ من أموالهم صَدَقَةً تُطهرهم}. |
إعراب الشرط والجواب
الشرطُ والجوابُ يكونان مُضارعينِ، وماضيين، ويكون الأول ماضياً والثاني مضارعاً. والأول مضارعاً والثاني ماضياً، وهو قليل، ويكون الأول مُضارعاً أو ماضياً، والثاني جُملة مُقترنة بالفاء أو بإذا. فإن كانا مُضارعين، وجب جزمهما، مثل: {إن ينتهوا يُغفرْ لهم ما قد سلفْ}. ورفع الجواب ضعيفٌ كقول الشاعر: فقلتُ تحملْ فوقَ طَوقِك، إنها مُطَبَّعةٌ، من يأتِها لا يضيرُها وعليه قراءة بعضهم: { أينما تكونوا يُدركُكُمُ الموتُ} بالرفع. وإن كان الأول ماضياً، أو مضارعاً مسبوقاً بِلمْ، والثاني مضارعاً، جاز في الجواب الجزم والرفع. فإن رفعتَ كانت جملته في محل جزم، على أنها جواب الشرط. والجزمُ أحسنُ، والرفع حسنٌ. ومن الجزم قوله تعالى { من كان يُريد زينة الحياة الدنيا نُوفِّ إليهم أعمالهم}. ومن الرفع قول الشاعر: وإن أتاه خليلٌ يومَ مَسْغَبةٍ يقولُ لا غائبٌ مالي ولا حرم [ المسغبة: الجوع] ونقول في المضارع المسبوق بِلَمْ (إن لم تَقُم أقُمْ) بالجزم. أو (إن لم تَقُم أقومُ) بالرفع. إعراب أدوات الشرط أدوات الشرط: منها ما هو حرف، وهما (إنْ؛ إذْ ما). ومنها ما هو اسمٌ مبهمٌ تضمن معنى الشرط، وهي (مَنْ؛ ما؛ مهما؛ أيُّ؛ كيفما) ومنهما ما هو ظرف زمان تضمن معنى الشرط، وهي ( أينَ؛ أنى؛ أيَّانَ؛ متى؛ إذْ). ومنها ما هو ظرف مكان تضمن معنى الشرط وهي (حيثما). فما دلَّ على زمانٍ أو مكانٍ، فهو منصوب محلاً على أنه مفعولٌ فيه لفعل الشرط. و (مَنْ وما و مهما) إن كان فعلُ الشرط يطلبُ مفعولاً به، فهي منصوبةٌ محلاً على أنها مفعولٌ به له، مثل (ما تُحَصِّلْ في الصِّغرِ ينفعكَ في الكِبَر. مَنْ تُجاوِرْ فأحسِنْ إليه. مهما تفعلْ تُسأل عنهُ). وإن كان لازماً أو مُتعدياً استوفى مفعولَهُ، فهي مرفوعةٌ محلاً على أنها مُبتدأٌ، وجملةُ الشرط خبره، مثل: (ما يجيء به القدر، فلا مَفَّر منه. من يَجُدْ يَجِدْ، مهما ينزل بك من خطبٍ فاحتملْهُ. ما تَفْعلْهُ تلقهُ). و(كيفما): تكون في موضع نصبٍ على الحال من فاعل الشرط، مثل: (كيفما تكنْ يكن أبناؤكَ). و(أي) تكون بحسَبِ ما تُضاف إليه، فإن أضيفت الى زمان أو مكان، كانت مفعولاً فيه، مثل: (أيَّ يوم تذهبْ أذهبْ) و(أيَّ بلدٍ تسكنْ أسكنْ). وإن أضيفت الى مصدر كانت مفعولاً مُطلقاً، مثل (أيَّ إكرامٍ تُكرِمْ أُكرِمْ). وإن أُضيفت الى غير الظرف والمصدر، فحكمها حُكْم (من وما ومهما)، فتكون مفعولاً به في (أيَّ كتابٍ تقرأْ تستفدْ). ومبتدأ في (أيُّ رجلٍ يجُدْ يَسُدْ) و (أيُّ رجلٍ يخدمْ أُمته تخدمْهُ). وكل أدوات الشرط مبنيةٌ، إلا (أَيَّا) فهي معربة بالحركات الثلاث، مُلازِمةٌ للإضافة الى المفرد، كما رأيت. انتهى الباب السادس |
الباب السابع
إعراب الأسماء وبناؤها المعرب والمبني من الأسماء الأسماءُ كلُّها مُعربةٌ إلا قليلاً منها. ويُعرب الاسم إذا سلمَ من شَبَهِ الحرف. ويُبنى إذا أشبهَه في الوضع أو المعنى، أو الافتقار، أو الاستعمال. فالشبهُ على أربعةِ أضرُبٍ: الأول: الشبَهُ الوضعيُّ. بأن يكون الاسم موضوعاً على حرفٍ واحدٍ، كالتاء من (كتبتُ)، أو حرفين (نا) من (كتبنا). فالضمائر بُنيت لأنها أشبهت الحرف في الوضع، لأن أكثرها موضوع على حرفٍ أو حرفين. وما كان منها موضوعاً على أكثر، فإنما بُني حملاً على أخواته، وذلك لأن أقل ما يُبنى منه الاسم ثلاثة أحرف، فما ورد من الأسماء على أقل من ذلك، كان مبنياً لشبهه الحرف في الوضع. وأما نحو: (يد و دم)، فهو معرب. لأنه في الأصل ثلاثة أحرف. (دمَو ويدي). الثاني: الشبه المعنوي. بأن يُشبه الاسم الحرف في معناه. وهو قسمان: أحدهما ما أشبهَ حرفاً موجوداً، كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. والآخر ما أشبه حرفاً غير موجودٍ، حقُهُ أن يوضعَ فلم يوضع، كأسماء الإشارة. (فهذه الأسماء بُنيت لتضمنها معاني الحروف، لأن ما تحمله من المعنى حقه أن يؤدي بالحرف. فأسماء الشرط أشبهت حرف الشرط، وهو (إن) وأسماء الاستفهام، وهو الهمزة، وأسماء الإشارة أشبهت حرفاً غير موجود. فبنيت لتضمنها معنى حرف كان ينبغي أن يوضع فلم يضعوه. وذلك لأن الإشارة، من المعاني التي حقها أن تؤدي بالحرف، غير أنهم لم يضعوا حرفاً للإشارة، كما وضعوا للتمني (ليت)، وللترجي (لعل)، وللاستفهام (الهمزة و هل) وللشرط (إن)). الثالث: الشبه الافتقاري الملازم: بأن يحتاجَ الى ما بعده احتياجاً دائماً، ليُتمم معناه. وذلك كالأسماء الموصولة وبعض الظروف الملازمة للإضافة الى الجملة. (فالأسماء الموصولة بُنيت لافتقارها في جميع أحوالها الى الصلة التي تتمم معناها، كما يفتقر الحرف الى ما بعده ليظهر معناه، والظروف الملازمة للإضافة الى الجملة، مثل: (حيث و إذا ومنذ الظرفيتين)، إنما بُنيت لافتقارها الى جملة تضاف إليها افتقار الحرف الى ما بعده). الرابع: الشبه الاستعمالي. وهو نوعان: نوعٌ يشبه الحرف العامل في الاستعمال، كأسماء الأفعال، فهي تُستعمل مؤثرةً غيرَ متأثرة، لأنها تعمل عمل الفعل (ولا يعمل فيها غيرها، فهي كحروف الجر وغيرها من الحروف العوامِل تؤثر في غيرها ولا يؤثر غيرها فيها. ونوعٌ يُشبهُ الحرف العاطل (أي: غير العامل) في الاستعمال، من حيث إنه مِثْلُه لا يؤثر ولا يتأثر، كأسماء الأصوات، فهي كحرفي الاستفهام وحروف التنبيه والتحضيض وغيرها من الحروف العواطل، لا تعمل في غيرها، ولا يعمل غيرها فيها. |
الأسماء المبنية
الأصل في الأسماء الإعراب، وإنما يُبنى منها ما أشبه الحرف كما قدمنا، وهو ألفاظٌ محصورة. والأسماء المبنية على نوعين: نوعٍ يُلازمُ البناء، ونوع يُبنى في بعض الأحوال. المُلازم للبناء من الأسماء مما يلازمُ البناءَ من الأسماء الضمائرُ وأسماءُ الإشارة، والأسماءُ الموصولة، وأسماءُ الشرطِ، وأسماء الاستفهام، وأسماءُ الكناية، وأسماءُ الأفعالِ، وأسماءُ الأصوات. ومنه (لدَى ولَدُنْ والآن وأمسِ وقَطُّ وعوْضُ)، من الظروف. و(قطَُ) ظرفٌ للزمان الماضي على سبيل الاستغراق. و (عَوْضُ) ظرف للزمان المستقبل كذلك، فهو بمعنى (أَبداً)، تقول (ما فعلته قطُّ، ولا أفعلهُ عوْضُ) أي لا أفعله أبداً. ومنه الظروفُ الملازمة للإضافة الى الجملة، مثل (حيثُ وإذ وإذا ومُذْ ومُنذُ، إن جُعلا ظرفين). فحيث، مُلازمة للإضافة الى الجملة، فإن أتى بعدها مفردٌ رفعَ على أنه مُبتدأ، ونُوِيَ خبره، مثل ( لا تجلس إلا حيث العلمُ) أي: حيث العلم موجودٌ. و (مُذ ومُنذُ): معناهما إما ابتداءُ المُدَّة، نحو: ( ما رأيتك مُذْ يومُ الجمعة)، وإما جميعها، نحو ( ما رأيتك منذُ يومان). والاسم بعدهما مرفوعٌ على أنه فاعلٌ لفعلٍ محذوف، والتقديرُ (مُذ كان يومُ الجمعة، ومنذ كان يومانِ) و(كان هنا تامة لا ناقصة). فإن جررت بهما كانا حرفي جر، وليسا بظرفين. و (إذْ) ظرفٌ لما مضى من الزمان. و (إذا) ظرفٌ للمستقبل منه. وهما مضافان أبداً الى الجُمَل، إلا أن (إذْ) تُضاف الى كلتا الجملتين، وإذا لا تضاف الى الجملة الفعلية. ومنه المركب المزجي، الذي تضمن ثانيهِ معنى حرف العطف، أو كان مختوماً بكلمة (وَيّهِ). فالأول: كأحد عشر الى تسعة عشرَ، إلا اثني عشرَ، ونحو: (وقعوا في حيصَ بيصَ) و (هو جاري بيتَ بَيتَ) و( الأمرُ بَيْنَ بينَ) و (آتيك صباحَ مساءَ) و (تفرق العدو شذَرَ مذَرَ) [ في كل تلك الجمل ليس هناك حرف عطف] وهو مبني على فتح الجزءين. والثاني نحو (جاء سيبويهِ، ومررتُ بسيبويهِ). وحرف التعريف والإضافة لا يُخلاَّن ببناءِ العددِ المركب. كالأحد عشر وخمسةَ عَشرَ. ( وما لم يكن منه متضمناً معنى حرف العطف، ولا مختوماً بويه، كان جزؤه الثاني معرباً إعراب ما لا ينصرف، للعلمية والتركيب المزجي. أما جزؤه الأول فيبنى على الفتح، مثل بعلبك وحضرموت وبختنصر. ما لم يكن آخره ياء فيبنى على السكون. كمعد يكرب. فإن ختم بويه كسيبويه، بني جزؤه الأول على الفتح والثاني على الكسر، كما تقدم). ما لا يلزم البناء من الأسماء من الظروف ما لا يلازم البناءَ. فهو يُبنى في بعض الأحوال، ويُعرب في بعض. وذلك مثل: قبل وبعد وأول والجهات الستِّ. فما قُطع منها عن الإضافة لفظاً، لا تقديراً (بحيث لا يُنسى المضاف إليه) بُني على الضمِّ، مثل: لله الأمرُ من قبلُ ومن بعدُ ومثل: رجعتُ الى وراءُ. وما أُضيف منها لفظاً، أُعرب، مثل: جئتُ قبلَ ذلك؛ وجلستُ أمامَ المنبرِ. وما عَرِيَ منها عن الإضافة لفظاً وتقديراً (بحيثُ يُنسى المضاف إليه لأنه لا يتعلق به غَرضٌ مخصوصٌ) أُعرب، مثل: (جئتُ قبلاً؛ وفعلتُ ذلك من بعدٍ) يَلحَق بهذه الظروف (حَسْب) عند قطعهِ عن الإضافة مثل: هذا حسبُ أي: حسبي، بمعنى يكفيني. وقد تُزادُ الفاءُ عليه تزييناً للفظِ، مثل: الكتابُ سميري فحسبُ، أي هو يكفيني عن غيره. وهو مبني على الضمِّ. ويلحق بها أيضاً (غَير) بعد النفي، مثل: فعلت هذا لا غيرُ أو ليس غيرُ. وهي مبنيٌّ على الضم أيضاً. |
أنواع إعراب الاسم
أنواع إعراب الاسم ثلاثة: رفعٌ ونصبٌ وجَرٌ: وعلامة الإعراب فيه إما حركةٌ أو حرفٌ. والأصل فيه أن يُعرب بالحركات. المُعرب بالحركة من الأسماء المُعرب بالحركة من الأسماء ثلاثةُ أنواع: الاسمُ المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم. وهي تُرفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتُجر بالكسرة، إلا جمع المؤنث السالم، فيُنصب بالكسرة بدل الفتحةِ مثل: (أكرمتُ الفتياتِ المجتهداتِ). والاسم الذي لا ينصرف، فيُجرُ بالفتحةِ بدل الكسرة، مثل: (ما الفقير القانعُ بأفضلَ من الغني الشاكرِ). والحركات تكون ظاهرةً على آخر الاسم، إن كان صحيح الآخر، غير مُضاف الى ياء المُتكلم، مثل: الحقُّ منصورٌ. فإن كان معتل الآخر بالألف، تقدر على آخره الحركات الثلاثُ للتعذر، مثل: إن الهدى مُنى الفتى. وإن كان معتل الآخر بالياء تُقدر على آخره الضمة والكسرة، مثل: حكمَ القاضي على الجاني. أما الفتحة فتظهر على الياء لخفتها، مثل: أجيبوا الداعيَ الى الخير. الاسم الذي لا ينصرف الاسم الذي لا ينصرف (ويُسمى الممنوع من الصرف أيضاً): هو ما لا يجوز أن يلحقه تنوينٌ ولا كسرةٌ. مثل: أحمدَ ويعقوبَ وعطشانَ. وهو على نوعين: نوعٌ يُمنع لسبب واحد، ونوع يُمنع لسببين. فالممنوع من الصرف لسبب واحد: كل اسم كان في آخره ألف التأنيث الممدودة: كصحراءَ وعذراءَ وزكرياءَ وأنصباءَ. أو ألفه المقصورةُ. كحُبلى وذكرى وجرحى. أو كان على وزن منتهى الجموع كمساجدَ ودراهمَ ومصابيحَ وعصافيرَ. والممنوع من الصرف لسببين إما عَلَمٌ وإما صفةٌ. ويُمنع العَلَمُ من الصرف في سبعة مواضع: 1ـ أن يكون علما مؤنثاً. سواء أكان مؤنثاً بالتاء، مثل: فاطمة وعزة وطلحة وحمزة، أم مؤنثاً معنوياً مثل: زينب و سعاد، إلا ما كان عربياً ثُلاثياً ساكن الوسط. مثل: دعْد و هنْد، فيجوز منعه ويجوز صرفه وصرفه أولَى. 2ـ أن يكون علماً أعجمياً زائداً على ثلاثة أحرف، مثل: إبراهيم وأنطون. أما ما كان على ثلاثة أحرفٍ صُرف مثل (نوح وجاك وجول). 3ـ أن يكون علما موازنا للفعل. ولا فرق بين أن يكون منقولاً عن فعل، مثل (يشكر ويزيد وشمر) 4ـ أن يكون علما مركبا تركيبَ مزجٍ، غير مختومٍ بويه، مثل بعلبك وحضرموت ومعدي كرب. 5ـ أن يكون علماً مزيداً فيه الألف والنون: كعثمانَ وعِمرانَ وغطفانَ. 6ـ أن يكون علماً معدولاً، والعدل هنا تقديري لا حقيقي، وعلى وزن (فُعَل) مثل عُمر وزُحل ومُضر وقُزح ودُلف وعُصم وهُبَل. باعتبار أن أصل عمر عامر وزحل زاحل. وعدها السيوطي أربعة عشر. 7ـ أن يكون علماً مزيداً في آخره ألف للإلحاق مثل: أرطى وذِفرى إذا سميت بها. وألفها زائدة لإلحاق وزنهما بجعفر. |
الصفة الممنوعة من الصرف
تمنع الصفة من الصرف في ثلاثة مواضع: 1ـ أن تكون صفة أصلية على وزن أَفعَلَ مثل: أحمر وأفضل. ويشترطُ فيها ألا تؤنثَ بالتاءِ، فإن أُنثت بها لم تُمنع، كأرملٍ، فإن مؤنثه أرملةٌ. والأرملُ الفقير. (فإن كانت الوصفية عارضة لاسم على وزن (أفعَلَ) لم تمنع من الصرف. وذلك كأربعٍ وأرنبٍ في قولك: (مررتُ بنساءٍ أربعٍ ورجلٍ أرنبٍ). فأربع في الأصل اسم لعدد، ثم وصفَ به، فكأنك قلت: بنساءٍ معدوادتٍ بأربع. وأرنب للحيوان المعروف. ثم أُريد به معنى الجبان والذليل، فالوصف بهما عارض، ومن ثم لم يؤثر في منعهما من الصرف). وإن كانت الاسمية عارضة للصفة لم يضر عروضها، فتبقى ممنوعة من الصرف ـ كما لم يضر عروض الوصفية للاسم، فيبقى منصرفاً. وذلك مثل أدهم للقيد، وأسود للحية، وأرقم للحية المنقطة، وأبطح للمسيل فيه دقيق الحصى، وأجرع للرملة المستوية لا تنبت شيئاً. فهي ممنوعة من الصرف، وإن استعملت استعمال الأسماء، لأنها صفات، فلم يلتفتوا الى ما طرأ عليها على ما سبق من الوصفية وبعضهم يعتد باسميتها الحاضرة فيصرفها، وبعضهم يمنعها من الصرف لا محاً فيها معنى الصفة. 2ـ أن تكون صفة على وزن (فَعلانَ) كعطشانَ وسكرانَ. ويُشترط في منعها أن لا تؤنث بالتاء. فإن أُنثت بها لم تمتنع، مثل: سيفانٌ وهو الطويل ومؤنثه سيفانة، ومَصَّان وهو اللئيم ومؤنثه مَصّانة، وندمان وهو النديم ومؤنثه ندمانة. وقد أحصوا ما جاء على وزن (فَعلان)، مما يؤنث على (فعلانة)، فكان ثلاث عشرة صفة، وهي بالإضافة للثلاث صفات السابق ذكرها، (حبلان) للعظيم البطن، و(دخنان) لليوم المظلم، و (صوجان) لليابس الظهر من الدواب والناس، و(صيحان) لليوم الذي لا غيم فيه، و(سخنان) لليوم الحار، و (موتان) للضعيف الفؤاد والبليد، و (علان) للكثير النسيان، و (فشوان) للدقيق الضعيف، و (نصران) لواحد النصارى، و (أليان) لكبير الإلية. فهذه كلها منصرفة لأنها تؤنث بالتاء. وما عداها فممنوع، لأن مؤنثه على وزن (فَعلى) مثل: غضبان ـ غضبى، عطشان ـ عطشى، سكران ـ سكرى الخ. 3ـ أن تكون صفة معدولة، وذلك بأن تكون الصفة معدولة عن وزن آخر. ويكون العدل مع الوصف في موضعين: الأول: الأعداد على وزن (فُعال أو مَفْعَل) كأحاد ومَوْحد وثُناء ومَثْنى، وثُلاث ومَثلث، ورُباع ومَربَع. (وهي معدولة عن واحدٍ واحد واثنينٍ اثنين. وقد قالوا: أن العدل في الأعداد مسموع عن العرب الى الأربعة. غير أن النحويين قاسوا ذلك الى العشرة، والحق أنه مسموع في الواحد والعشرة وما بينهما). الثاني: أُخَرُ، كقوله تعالى { فعدة من أيامٍ أُخَر}. و (مررت بنساءٍ أُخر). وهي جمع أُخرى، مؤنث آخر. وآخر (بفتح الخاءِ) اسم تفضيل على وزن (أفعَل) بمعنى مغاير. وكان القياس أن يُقال: (مررتُ بنساءٍ آخر)، كما يُقال (مررتُ بنساءٍ أفضل) ـ بإفراد الصفة وتذكيرها ـ لا بنساءٍ أُخَر، كما لا يقال (بنساءٍ فُضَل)، لأن أفعلَ التفضيل، إن كان مجرداً من (ألْ) والإضافة لا يؤنث ولا يُثنى ولا يُجمع. فيُقال أخلاقك أطيب وآدابك أرفع وشمائلك أحلى. أما آخر فعدلوا به عن هذا الاستعمال، فقالوا: آخر وآخران وآخرون وأخريان وأُخَر. على خلاف القياس، وكان القياس أن يُقال آخر للجميع. فالعدل به عن القياس إحدى العلتين في منعه من الصرف. وإنما اختصت (أُخر) في جعل عدلها مانعاً من الصرف. لأن آخر ممنوع منه لوزن الفعل. وأخرى لألف التأنيث. وآخران وأُخريان وآخرون معربة بالحرف. واعلم أنه لم يُسمع شيء من الصفات التي جاءت على وزن (فُعَل) ممنوعاً من الصرف إلا (أُخر) فقدروا فيها العدل. ليكون علة أخرى مع الوصفية. |
حُكْم الاسم الممنوع من الصرف حُكْم الاسم الممنوع من الصرف أن يُمنع من التنوين والكسرة، وأن يُجر بالفتحة نحو: (مررتُ بأفضلَ منه)، إلا إذا سبقته (أل) أو أُضيف، فيُجر بالكسرة، على الأصل، نحو (أحسنتُ الى الأفضلِ أو الى أفضلِ الناس). وقد يُصرف (أي: يُنوَّن ويُجر بالكسرة) غير مسبوقٍ بأل ولا مُضافاً، وذلك في ضرورة الشعر. كقول السيدة فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليه ترثي أباها: ماذا على من شَّمَّ تُربةَ أحمدٍ أن لا يَشَمَّ مدى الزمانِ غواليا [ الغوالي: أخلاط الطيب]. والمنقوص المُستحق المنع من الصرف، كجوار [ جمع جارية، وهي الفتاة سميت بذلك لخفتها وكثرة جريها] وغواش [ وهي الظلمات، من غشي الليل والمفرد غاشية]، تُحذف ياؤه رفعاً وجراً، ويُنوَّن نحو: (جاءت جوارٍ، ومررت بجوارٍ). ويكون الجر بفتحةٍ مقدرة على الياء المحذوفة، كما يكون الرفع بضمة مقدرة عليها كذلك. أما في حالة النصب، فتثبت الياء مفتوحة نحو: رأيتُ جواريَ. وقد جاء في الشعر إثبات يائه، في حالة الجر، ظاهرةً عليها الفتحةُ كقول الفرزدق: فلو كان عبدَ الله مولى، هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا وكان حقه أن يقول: ولكن عبد الله مولى موال. بحذف يائها وتنوينها تنوين العوض. ومن النحاة من يُثبت ياء المنقوصِ الممنوع من الصرف، إذا كان علماً، في أحواله الثلاثة. فيقول: جاء ناجي ورأيت ناجي ومررت بناجي. على أساس أن ناجي اسم علم. واعلم أن تنوين المنقوص، المستحق المنع من الصرف، إنما هو تنوين عوض من الياء المحذوفة، لا تنوين صرف كتنوين الأسماء المنصرفة لأنه ممنوع منه. |
المعرب بالحروف من الأسماء
المعرب بالحروف من الأسماء ثلاثة أنواع: المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. فالمثنى يُرفع بالألف، مثل: أفلح المجتهدان. ويُنصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها مثل: أكرمتُ المجتهدَيْنِ، وأحسنت الى المُجتهدَيْنِ. ومن العرب من يُلزم المثنى الألف، رفعاً ونصباً وجراً، وهم بنو الحارث ابن كعب، وخثعم، وزبيد وكنانة وآخرون، فيقولون: جاء الرجلان ومررت بالرجلان ورأيت الرجلان. وعليه قول الشاعر: تزوَّدَ منا بين أُذناهُ طعنةً دعته الى هابي التراب، عقيمُ [هابي التراب: تراب القبر.. طعنة عقيم: أي تلك الطعنة النافذة التي لا تحتاج غيرها]. وجمع المذكر السالم يرفع بالواو، مثل: أفلح المجتهدون، ويُنصب ويُجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، مثل: أكرمتُ المجتهدِينَ، وأحسنتُ الى المجتهدِينَ. والأسماء الخمسة هي (أبٌ وأخٌ وحمٌ وفو وذو) وهي ترفع بالواو مثل (جاء أبو الفضل)، وتُنصب بالألف، مثل: أكرِم أباك. وتُجر بالياء، مثل عامل الصديق معاملة أخيك. وهي لا تُعرب كذلك إلا إذا كانت مفردة مضافة الى غير ياء المتكلم. فإن كانت مثناة، أو مجموعة، فتعرب إعراب المثنى أو الجمع، مثل: أكرِم أبويك، واقتدِ بصالح آبائك واعتصم بذوي الأخلاق الحسنة. وإن قُطعت عن الإضافة كانت معربة بحركات ظاهرة، مثل: هذا أبٌ صالحٌ، وأكرِم الفمَ عن بذيء الكلام، وتمسك بالأخِ الصادق. وإذا أُضيفت الى ياء المتكلم كانت معربة بحركات مقدرةٍ على آخرها، يمنع من ظهورها كسرة المناسبة [سُميت مناسبة لتناسب الياء، وهي تمنع من ظهورها]، مثل: أبي رجلٌ صالح، وأكرمتُ أبي، ولزمت طاعة أبي. ومن العرب من يُلزم الألف في حالات الإعراب الثلاث، ويعربه إعراب الاسم المقصور، بحركات مقدرة على الألف، سواء أضيف أم لم يُضف، فيقول: هذا أباً ورأيتُ أباً ومررتُ بأباً. ومنه القول (مُكرهٌ أخاك لا بطل). إعراب الملحق بالمثنى ويُعرب (اثنتان واثنان) إعراب المثنى. ويُعرب (كِلا وكِلتا) إعراب المثنى، إذا أُضيفا الى ضميرٍ، مثل: جاء الرجلان كلاهما والمرأتان كلتاهما، ورأيت الرجلين كليهما والمرأتين كلتيهما، ومررت بالرجلين كليهما والمرأتين كلتيهما. فإن أضيفتا الى غير الضمير أعربا إعراب الاسم المقصور، بحركاتٍ مقدرة على الألف رفعاً ونصباً وجراً، مثل: جاء كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. وكلا وكلتا: اسمان ملازمان للإضافة. ولفظهما مُفردٌ ومعناهما مُثنى: ولذلك يجوز الإخبار عنهما بما يحمل ضمير المفرد، باعتبار لفظهما، وضمير المثنى باعتبار معناهما، فنقول: كلا الرجلين عالم، وكلاهما عالمان. و قد اجتمعا في قول الشاعر: كلاهما حين جَدَّ الجريُ بينهما قد أقلعا، وكِلا أنفيْهما رابي إلا أن اعتبار اللفظ أكثر، وبه جاء القرآن الكريم، { كِلتا الجنتين أتت أُكلها}، ولم يقل: أتتا. إعراب الملحق بجمع المذكر السالم يعرب الملحق بجمع المذكر السالم وهو (ما جمع هذا الجمع على غير قياس) إعراب جمع المذكر السالم. ويجوز في نحو: بنين وسنين وعِضين وما أشبهها أن يعرب إعراب هذا الجمع، وهو الأفصح فيقال: (مرت عليَّ سنون واغتربت سنين، وأنجزت هذا العمل في سنين). قال تعالى { ألكم البنات وله البنون؟}. ويجوز أن تلزمه الياء مع التنوين، فنقول: مرت علي سنينٌ كثيرةٌ، ومكثت مغترباً سنيناً كثيرة. إعراب الملحق بجمع المؤنث السالم تُعرب (أولاتُ) كجمع المؤنث السالم، بالضمة رفعاً، وبالكسرة نصباً وجراً، قال تعالى { وإن كُنَّ أولاتِ حملٍ}. ونقول: أولاتُ الأخلاق الطيبة محبوباتٌ. وارجُ الخير من أولاتِ الحياء والإصلاح والعلم. ويُعرب ما سُمي به من هذا الجمع إعرابه، فنقول: هذه عَرَفَاتٌ وقال تعالى: {فإذا أفضتم من عرفاتٍ}. ويجوز فيه مذهبان آخران: أحدهما أن يُعرب إعراب ما لا ينصرف، للعَلَمية والتأنيث: فيُرفَع بالضمة، وينصب ويجر بالفتحة. ويمتنع حينئذٍ من التنوين. فنقول: هذه عرفاتُ ومررتُ بعرفاتَ. والثاني أن يُرفع بالضمة، ويُنصب ويُجر بالكسرة، فنقول: هذه عرفاتُ وصعدتُ الى عرفاتِ. |
الباب الثامن
مرفوعات الأسماء مرفوعات الأسماء تسعةٌ: الفاعلُ، ونائبهُ، والمبتدأ، وخبرهُ، واسم الفعل الناقص، واسم أحرفِ (ليس)، وخبر الأحرف المشبهة بالفعل، وخبر (لا) النافية للجنس، والتابع للمرفوع. ويشتمل هذا الباب على سبعة فصول: 1ـ الفاعل الفاعل: هو المُسنَدُ إليه بعد فعلٍ تام معلوم أو شبهِِهِ، نحو (فاز المجتهدُ) و (السابقُ فرُسُهُ فائزٌ). فالمجتهد: أسند الى الفعل التام المعلوم، وهو (فاز)؛ والفرس: أسند الى شبه الفعل التام المعلوم، وهو (السابق) فكلاهما فاعل لما أسند إليه. والمُرادُ بشبه الفعلِ المعلوم اسمُ الفاعل، والمصدرُ. واسمُ التفضيل، والصفةُ المُشبهة، ومبالغة اسم الفاعل، واسم الفعل. فهي كلُّها ترفع الفاعلَ كالفعل المعلوم. ومنه الاسم المستعار، نحو: أكرِمْ رجلاً مِسكاً خُلُقُه. (فخُلُقُه فاعل لمسك مرفوع به، لأن الاسم المستعار في تأويل شبه الفعل المعلوم والتقدير: أكرم رجلاً كالمسك. وتأويل قولك: رأيت رجلاً أسداً غلامُه: رأيتُ رجلاً جريئاً غلامه كالأسد. أحكام الفاعل للفاعل سبعةُ أحكامٍ: 1ـ وجوبُ رفعه. وقد يُجرُّ لفظاً بإضافته الى المصدر، نحو: (إكرام المرءِ أباهُ فرضٌ عليه) [ إكرام: مضاف. والمرء مضاف إليه، من إضافة المصدر الى فاعله: مجرور لفظاً بالإضافة، مرفوع حكماً، لأنه فاعل المصدر]. أو الى اسم المصدر، نحو: (سَلمْ على الفقيرِ سلامَكَ على الغني)، [ سلام: مضاف، والكاف: مضاف إليه، من إضافة اسم المصدر الى فاعله. ولها محلان من الإعراب: قريب، وهو الجر بالإضافة، وبعيد، وهو الرفع على أنها فاعل]. أو (من)، أو (الباء) أو (اللام) الزائداتِ. نحو: ( ما جاءَنا من أحدٍ، وكفى باللهِ شهيداً، وهيهات هيهات لما توعدونَ). [ والأصل: ما جاءنا أحدٌ، فأحد فاعل جاء، فهو مجرور لفظاً بمن؛ وكفى الله شهيداً، فلفظ الجلالة كُسر لفظاً بالباء الزائدة؛ وهيهات هيهات: أصلها هيهات ما توعدون، و (ما) اسم موصول فاعل لاسم الفعل وهو هيهات، ومحله القريب الجر باللام الزائدة ومحله البعيد الرفع على أنه فاعل هيهات، وهيهات الأخرى توكيد الأولى]. 2ـ وجوب وقوعه بعد المسند، فإن تقدم ما هو فاعلٌ في المعنى كان الفاعل ضميراً مستتراً يعود إليه، نحو (زهير قام) وزهير: مبتدأ، وقام (جملة: خبر). وإما مفعول لما قبله نحو: (رأيتُ علياً يفعل الخير)، وإما فاعل لفعل محذوف، نحو: {وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره}، فأحد: فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. 3ـ أنه لا بد منه في الكلام. فإن ظهر في اللفظ فذاك. وإلا فهو ضمير راجعٌ إما لمذكور، نحو (المجتهدُ ينجحُ) أو لما دل عليه الفعلُ، كحديث (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ. ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن). [ أي: لا يشرب هو، أي الشارب. ففاعل يشرب ضمير مستتر تقديره: هو يعود على اسم الفاعل المفهوم من يشرب]. أو لما دلَّ عليه الكلام، كقولك في جواب هل جاء سليمٌ؟ (نعم جاء) [أي: نعم جاء هو، أي سليم، فالفاعل ضمير مستتر يعود على سليم الذي دل عليه الكلام. أو لما دلَّ عليه المقام، نحو { كلاَّ إذا بلغت التراقي} [ الضمير يعود على الروح المعلومة في المقام] أو لما دلت عليه حال المشاهدة، نحو (إن كان غداً فائتني) [ أي: إن كان ما نحن عليه الآن من سلامة وإمكان اللقاء غداً فائتني، فاسم كان ضمير مستتر يعود الى ما دلت عليه الحال المشاهدة. وحكم اسم كان كحكم الفاعل كما ستعلم]. 4ـ أنه يكون في الكلام وفعله محذوف لقرينةٍ دالةٍ عليه: كأن يُجاب به نفيٌ، نحو (بلى سعيدٌ) في جواب من قال: (ما جاء أحدٌ؟) [أي: بلى جاء سعيد]. أو استفهام، نقول: (من سافر؟) فيُقال (سعيدٌ). قال تعالى { لئن سألتهم من خلقهم؟ ليقولن الله} 5ـ أن الفعل يجب أن يبقى معه بصيغة الواحد، وإن كان مثنى أو مجموعاً، فكما تقول: اجتهد التلميذُ، تقول: اجتهد التلميذان، واجتهد التلاميذ. 6ـ أن الأصل اتصال الفاعل بفعله، ثم يأتي بعده المفعول، وقد يُعكس الأمر، فيتقدم المفعول، ويتأخر الفاعل، نحو (أكرمَ المجتهدَ أستاذُهُ) 7ـ أنه إذا كان مؤنثاً أُنث فعله بتاءٍ ساكنة في آخر الماضي، وبتاء المضارعة في أول المضارع، نحو (جاءت فاطمةُ، وتذهبُ خديجةُ). |
متى يجب تذكيرُ الفعلِ مَعَ الفاعل؟
يجب تذكير الفعلِ مَعَ الفاعل في موضعين: 1ـ أن يكون الفاعل مُذكراً، مُفرداً أو مُثنى أو جمع مُذكرٍ سالماً. سواءً أكان تذكيره معنىً ولفظاً، نحو: (ينجحُ التلميذُ، أو المجتهدان، أو المجتهدون)، أو معنى لا لفظاً، نحو: (جاء حمزة). وسواءً أكان ظاهراً، كما مُثلَ أم ضميراً، نحو: (المجتهدُ ينجحُ، والمجتهدان ينجحان، والمجتهدون ينجحون، وإنما نجح هو، أو أنتَ، أو هما، أو أنتم). (فإن كان جمع تكسير: كرجال أو مذكراً مجموعاً بالألف والتاء، مثل: طلحات وحمزات، أو ملحقاً بجمع المذكر السالم كبنين، جاز في فعله الوجهان: تذكيره وتأنيثه كما سيأتي. 2ـ أن يُفصل بينه وبين فاعله المؤنث الظاهر ب (إلا)، نحو: (ما قام إلا فاطمة). (وذلك لأن الفاعل في الحقيقة إنما هو المستثنى منه المحذوف إذ التقدير: ( ما قام أحدٌ إلا فاطمة). فلما حُذف الفاعل تفرغ الفعل لما بعد (إلاّ): فرفع ما بعدها على أنه فاعلٌ في اللفظ لا في المعنى. فإن كان الفاعل ضميراً منفصلاً مفصولاً بينه وبين فعله بألا، جاز في الفعل الوجهان كما سيأتي. متى يجب تأنيث الفعل مع الفاعل؟ يجب تأنيث الفعل مع الفاعل في ثلاثة مواضع: 1ـ أن يكون الفاعل مؤنثاً حقيقياً ظاهراً متصلاً بفعله، مفرداً أو مثنى أو جمع مؤنث سالماً نحو: (جاءت فاطمةُ، أو الفاطمتان، أو الفاطماتُ). 2ـ أن يكون الفاعل ضميراً مستتراً يعود الى مؤنثٍ حقيقي أو مجازي، نحو: (خديجة ذهبت، والشمس تطلع). 3ـ أن يكون الفاعل ضميراً يعود الى جمع مؤنث سالم، أو جمع تكسير لمؤنث أو لمذكر غير عاقل، غير أنه يؤنث بالتاء أو بنون جمع المؤنث، نحو: (الزينبات جاءت، أو جئن، وتجيء أو يجئن) والفواطم أقبلت أو أقبلن) و( الجِمَالُ تسيرُ أو يسرْنَ). متى يجوز الأمران: تذكير الفعل وتأنيثه؟ يجوز تذكير الفعل وتأنيثه في تسعة أمور: 1ـ أن يكون الفاعل مؤنثاً مجازياً ظاهراً (أي: ليس بضمير)، نحو: (طلعت الشمس، وطلع الشمسُ). والتأنيث أفصح. 2ـ أن يكون الفاعل مؤنثاً حقيقياً مفصولاً بينه وبين فعله بفاصل غير (إلا) نحو: (حضرت، أو حضر المجلسَ امرأةٌ) والتأنيث أفصح. 3ـ أن يكون ضميراً منفصلاً لمؤنث، نحو: (إنما قامَ، أو إنما قامت هي)، ونحو: (ما قام، أو ما قامت إلا هي). والأحسن ترك التأنيث. 4ـ أن يكون الفاعل مؤنثاً ظاهراً، والفعلُ (نِعم) أو (بِئس) أو (ساء) التي للذم، نحو (نِعمت أو نِعم، وبئست، أو بِئسَ، وساءت، أو ساء المرأة دَعدُ). والتأنيث أجود. 5ـ أن يكون الفاعل مذكرا مجموعا بالألف والتاء، نحو: (جاء، أو جاءت الطلحات). والتذكير أحسن. 6ـ أن يكون الفاعل جمع تكسير لمؤنث أو لمذكر، نحو: (جاء، أو جاءت الفواطم، أو الرجال). والأفضلُ التذكير مع المذكر، والتأنيث مع المؤنث. 7ـ أن يكون الفاعل ضمير يعودُ الى جمع تكسير لمذكر عاقل، نحو: (الرجالُ جاءوا، أو جاءت). والتذكير بضمير الجمع العاقل أفصحُ. 8ـ أن يكون الفاعلُ ملحقاً بجمع المذكر السالم، أو بجمع المؤنث السالم. فالأول، نحو: (جاء أو جاءت البنونَ). ومن التأنيث قوله تعالى { آمنتُ بالذي آمنتْ به بنو إسرائيل} والثاني نحو: (قامت، أو قام البنات). ويرجح التذكير والتأنيث مع المؤنث. 9ـ أن يكون الفاعل اسم جمع، أو اسمَ جنسٍ جميعاً. فالأول نحو: (جاء، أو جاءت النساء، أو القومُ، أو الرهط، أو الإبل). والثاني نحو: (قال، أو قالت العرب، أو الرومُ، أو الفُرس، أو التُرْك)، ونحو: (أورق، أو أورقت الشجر). |
أقسام الفاعل
الفاعل ثلاثة أنواع: صريح وضمير ومؤول. فالصريح مثل: (فاز الحقُّ) والضمير، إما متصل كالتاء من (قمت) والواو من (قاموا) والألف من (قاما) والياء من (تقومين)، وإما منفصل: أنا ونحن من قولك (ما قام إلا أنا، وإنما قام نحن) وإما مستتر نحو: (أقوم، وتقومُ، ونقومُ). والمستتر على ضربين: مستتر جوازاً. ويكون في الماضي والمضارع المُسنَدَينِ الى الواحد الغائب والواحدة الغائبة. ومستتر وجوبا، ويكون في المضارع والأمر المسندين الى الواحد المخاطب، وفي المضارع المسند الى المتكلم، مفرداً أو جمعاً. وفي اسم الفعل المسند الى متكلم: كأفٍ، أو مخاطب: ك (صه) وفي فعل التعجب، الذي على وزن ( ما أفعَلَ) نحو: ما أحسنَ العلمَ [ ما: اسم نكرة معناه التعجب. وهو في محل رفع لأنه مبتدأ. وأحسنَ فعل ماضٍ فعل تعجب أول. وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره (هو) يعود الى (ما) التعجبية والعلم مفعول به لأحسن، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع لأنها خبر المبتدأ]. ونحو: (جاء القوم ما خلا سعيداً)، والتقدير: (جاؤا خالين من سعيد). والفاعل المؤول: هو أن يأتي الفعل ويكون فاعله مصدراً مفهوما من الفعل بعده، نحو: (ويَحسُنُ أن تجتهد). فالفاعل هنا هو المصدر المفهوم من تجتهد. ولما كان الفعل الذي بعد (أن) في تأويل المصدر الذي هو الفاعل، سمي الفعل مؤولاً. ويتأول الفعل بالمصدر بعد خمسة أحرف، وهي: (أن،إن، كي، وما ولو المصدريتين). فالأول مثل: (يُعجبني أن تجتهد)، والتقدير: (يعجبني اجتهادك). والثاني مثل: (بلغني أنك فاضلٌ) والتقدير: (بلغني فضلُك). والثالث مثل: (أعجبني ما تعمل) والتقدير: (أعجبني عملُك). والرابع مثل: (جئت لكي أتعلمَ) والتقدير: (جئت للتعلم). و (كي) لا يتأول الفعل بعدها إلا بمصدرٍ مجرورٍ باللام. والخامس مثل: (وَدِدتُ لو تنتبه) والتقدير: (وَدِدتُ انتباهَك). و(لو) لا يتأول الفعل بعدها إلا بالمفعول. والثلاثة الأُوَلُ يتأول الفعل بعدها بالمرفوع والمنصوب والمجرور. والجملة المؤلفة من الفاعل ومرفوعه تُدعى جملة فعلية. فائدتان 1ـ إن وقع بعد (لو) كلمة (أن) فهناك فعل محذوف بينهما تقديره: (ثَبَت). فإن قلت: (لو أنك اجتهدت لكان خيراً لك) فالتقدير: (لو ثَبَت اجتهادك). فيكون المصدر المؤول فاعلاً لفعل محذوف، تقديره (ثبت). 2ـ الهمزة الواقعة بعد كلمة (سواء) تُسمى همزة التسوية، وما بعدها مؤول بمصدر مرفوع على أنه مبتدأ مؤخر، و (سواء) قبله خبره مقدماً عليه. فتقدير قوله تعالى { سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم}: (إنذارك وعدم إنذارك سواء عليهم) أي الأمران سيان عندهم. فهمزة التسوية معدودة في الأحرف المصدرية، التي يتأول الفعل بعدها بمصدر. فتكون الأحرف المصدرية، على هذا ستة أحرف. |
نائب الفاعل
نائب الفاعل: هو المسند إليه بعد الفعل المجهول أو شِبْهه، نحو: (يُكرَمُ المجتهدُ، والمحمودُ خُلُقُهُ ممدوحٌ). فالمجتهد أسند إليه الفعل المجهول، وهو (يكرم). وخلقه أسند الى شبه الفعل المجهول وهو (المحمود) فكلاهما نائب فاعل لما أسند إليه. والمراد بشبه الفعل المجهول اسم المفعول، والاسم المنسوب إليه، فاسم المفعول (المحمود)، والاسم المنسوب إليه، نحو: (صاحب رجلاً نبوياً خلقه). فخلقه نائب فاعل لنبوي مرفوع به، لأن الاسم المنسوب في تأويل اسم المفعول. والتقدير: صاحب رجلاً منسوباً خلقه الى الأنبياء. ونائب الفاعل قائمٌ مقام الفاعل بعد حذفه ونائبٌ منابَهُ. وذلك أن الفاعل قد يُحذف من الكلام، لغرضٍ من الأغراض، فينوب عنه بعد حذفه غيره. وفي هذا الفصل ثلاثة مباحث: 1ـ أسباب حذف الفاعل يحذف الفاعل إما للعلم به، فلا حاجة لذكره، لأنه معروف، نحو (وخُلِق الإنسانُ ضعيفا). وإما للجهل به، فلا يمكنك تعيينه، نحو: (سُرِق البيتُ)، إذا لم تعرف السارق. وإما للرغبة في إخفائه للإبهام، نحو (رُكِبَ الحصانُ)، إذا عرفت الراكب غير أنك لم تُرِد إظهاره. وإما للخوف عليه نحو: (ضُرب فلانٌ) إذا عرفت الضارب غير أنك خفت عليه، فلم تذكره. وإما للخوف منه، نحو: (سُرِق الحصانُ) إذا عرفت السارق فلم تذكره، خوفاً منه، لأنه شرير مثلاً. وإما لشرفه، نحو: (عُمِلَ عَملٌ مُنكرٌ)، إذا عرفت العامل فلم تذكره، حفظاً لشرفه. وإما لأنه لا يتعلق بذكره فائدةً، نحو: (وإذا حُييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رُدّوُها). فذكر الذي يُحيي لا فائدة منه، وإنما الغرض وجوب رد التحية لكل من يُحيي. 2ـ الأشياء التي تنوب عن الفاعل ينوب عن الفاعل بعد حذفه أحد أربعة أشياء: أ ـ المفعول به، نحو: (يُكرم المجتهدُ) والأصل: يكرم الأستاذُ المجتهدَ. ب ـ المجرور بحرف الجر، نحو: (نُظر في الأمر)، والأصل: نَظَر الناس في الأمر. وقوله تعالى: { ولما سُقِط في أيديهم) [سقط في يده: زَلّ وتحير وندم]. ج ـ الظرف المتصرف المختص، نحو: (مُشيَ يومٌ كاملٌ، وصيم رمضانٌ) د ـ المصدر المتصرف المختص، نحو: (اُحتُفِل احتفالٌ عظيمٌ). والمتصرف من المصادر: ما يقع مسنداً إليه كإكرام واحتفال وإعطاء وفتح ونصر ونحوها. وغير المتصرف منها ما لا يصح أن يقع مسنداً إليه. لأنه لا يكون إلا منصوباً على المصدرية، أي: على المفعولية المطلقة، نحو: (معاذَ الله وسبحانَ الله). فلا ينوب مثل هذا عن الفاعل، لأنه لا يجوز الرفع فيسند إليه، كما يصح الإسناد الى إكرام وفتح ونصر، نحو (إكرام الضيف سنة العرب)، ونحو {إذا جاء نصر الله والفتح). والمصدر المتصرف لا ينوب عن الفاعل إلا إذا كان مع تصرفه مختصاً. والمراد باختصاصه أن يكون مقيداً غير مبهم، ويختص بالوصف، نحو: (وُقِف وقوفٌ طويلٌ) أو بيان العدد، نحو: (نُظِر في الأمر نظرتان، أو نظرات). أو بيان النوع، نحو (سِير سَيْر الصالحين) فائدة متى حُذف الفاعل، وناب عنه نائبه، فلا يجوز أن يذكر في الكلام ما يدل عليه، فلا يقال: (عوقب الكسول من المعلم) أو (الكسول مُعاقب من المعلم) بل يقال (عوقب الكسول) أو (الكسول معاقب) وذلك لأن الفاعل يحذف لغرض، فذكر ما يدل عليه مناف لذلك. 3ـ أحكام نائب الفاعل وأقسامه كُل ما تقدم من أحكام الفاعل يجب أن يُراعى مع نائبه، لأنه قائم مقامه، فله حكمه. فيجب رفعه، وأن يكون بعد المسند، وأن يذكر في الكلام. فإن لم يذكر فهو ضمير مستتر، وأن يؤنث فعله إن كان هو مؤنثاً، وأن يكون فعله موحداً، وإن كان مثنى أو مجموعا، ويجوز حذف فعله لقرينة دالة عليه. ونائب الفاعل، كالفاعل، ثلاثة أقسام: صريح وضمير ومؤول. فالصريح نحو: (يُحب المجتهد). والضمير إما متصل كالتاء من (أُكرِمتَ) وإما منفصل نحو: (ما يُكرَمُ إلا أنا). وإما مستتر نحو (أُكرَمُ، ونُكرَمُ) والمؤول نحو: (يُحمَدُ أن تجتهدوا)، والتأويل: يُحمدُ اجتهادكم. |
المبتدأ والخبر
المبتدأ والخبر: اسمان تتألف منهما جملةٌ مفيدةٌ، نحو: (الحقُ منصورٌ) و (الاستقلالُ ضامنٌ سعادةَ الأمة). يتميز المبتدأ عن الخبر بأن المبتدأ مُخْبَرٌ عَنه، والخبرَ مُخَبَرٌ به. والمبتدأ: هو المُسند إليه، الذي لم يسبقهُ عاملٌ. والخبرُ: ما أُسندَ الى المبتدأ، وهو الذي تتمُّ به مع المبتدأ فائدة. والجملةُ المؤلفةُ من المبتدأ والخبر تُدعى جملةٌ اسميّة. ويتعلق بالمبتدأ والخبر ثمانية مباحث: 1ـ أحكام المبتدأ للمبتدأ خمسةُ أحكامٍ: الأول: وجوب رفعهِ. وقد يُجرُّ بالباء أو من (الزائدتين)، أو ب (رُبَّ)، التي هي حرف جر شبيه بالزائد. فالأول نحو (بِحَسبِك الله) [ ب: حرف جر زائد وحسب مجرور لفظاً بالباء الزائدة، مرفوع محلاً على أنه مبتدأ، والله خبره]. والثاني: {هل من خالقٍ غيرُ الله يرزقكم؟!} [ من: حرف جر زائد، وخالق مجرور لفظاً بمن الزائدة، مرفوع محلاً على أنه مبتدأ]. والثالث نحو: (يا رُبّ كاسيةٍ في الدنيا عاريةٌ يوم القيامة). [ رب: حرف جر شبيه بالزائد وكاسية مجرور لفظاً برب، مرفوع محلاً على أنه مبتدأ. وعارية خبره]. الثاني: وجوب كونه معرفةً نحو: (محمدٌ رسول الله)، أو نكرةً مفيدةً، نحو: (مجلسُ علمٍ يُنتفعُ به خيرٌ من عبادة سبعين سنةًً). وتكون النكرة مفيدة بأحدِ أربعةَ عشر شرطاً: 1ـ بالإضافة لفظاً نحو: (خمسُ صلواتٍ كتبهنّ الله)، أو معنىً، نحو: (كلُّ يموتُ)، ونحو: (قُلْ كلٌّ يعمل على شاكلته)، أي: كل أحدٍ. 2ـ بالوصف لفظاً، نحو: (لعبدٌ مؤمنٌ خيرٌ من مُشْرِك)، أو تقديراً نحو: (شرٌ أهرَّ ذا ناب)، ونحو: (أمرٌ أتى بك)، أي: شرٌ عظيم وأمرٌ عظيم. أو معنىً: بأن تكون مصغرة، نحو: (رُجَيْلٌ عندنا) أي: رجل حقير. 3ـ بأن يكون خبرها ظرفا أو جاراً ومجروراً مقدماً عليها، نحو: {وفوق كل ذي علم عليم، ولكل أجلٍ كتاب}. 4ـ بأن تقع بعد نفيٍ. أو استفهام. أو (لولا)، أو (إذا) الفجائية. فالأول نحو: (ما أحدٌ عندنا)، والثاني نحو: (أإلهٌ مع الله؟)، والثالث كقول الشاعر: لولا الحياءُ لهاجني استعبارُ ولزرت قبركِ والحبيب يُزارُ والرابع نحو: (خرجتُ فإذا أسدٌ رابضٌ) 5ـ بأن تكون عاملةً، نحو: (إعطاءٌ قرشاً في سبيل العلم ينهض بالأمة)، ونحو: (أمرٌ بمعروفٍ صدقةٌ، ونهيٌ عن منكر صدقةٌ). 6ـ بأن تكون مبهمة، كأسماء الشرط والاستفهام و (ما) التعجبية و(كم) الخبرية. فالأول نحو: (مَنْ يجتهدُ يُفلحْ) [ مَن: اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ. وجملة الشرط مع الجواب خبره]، والثاني نحو: (مَنْ مجتهد؟) [مَن: اسم استفهام في محل رفع مبتدأ. ومجتهد: خبره]. و (كم عِلماً في صدرك)، [كم: اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، وعلماً: تمييز منصوب، وفي صدرك: متعلق بالخبر المحذوف]، والثالث نحو: (ما أحسن العلمَ!) [ما: تعجبية في محل رفع مبتدأ، والجملة بعده خبر]. والرابع نحو: (كم مأثرةٍ لك!) [كم: خبرية في محل رفع مبتدأ، وهي مضافة الى مأثرة. ولك متعلقة بخبرها] 7ـ بأن تكون مفيدة للدعاء بخير أو شر، فالأول نحو: (سلامٌ عليكم). والثاني نحو: { ويلٌ للمطففين}. 8ـ بأن تكون خَلفاً عن موصوف، نحو: (عالمٌ خيرٌ من جاهل)، أي: رجلٌ عالم. 9ـ بأن تقع صدر جملة حالية مرتبطة بالواو أو بدونها: فالأول كقول الشاعر: سرينا ونجمٌ قد أضاء، فمذ بدا محياك أخفى ضوؤه كل شارق والثاني كقول شاعر: الذئب يطرقها في الدهر واحدةً وكلَّ يومٍ تراني مُديةٌ بيدي [مدية: مبتدأ. وبيدي: خبره، وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب على الحال من ضمير المفعول في تراني]. 10ـ بأن يراد بها التنويع، أي التفصيل والتقسيم كقول امرئ القيس: فأقبلتُ زحفاً على الركبتينِ فثوبٌ لبِستُ، وثوبٌ أجُرّ [ ثوبٌ: مبتدأ. وجملة لبست خبرها. وثوب الثاني: مبتدأ وجملة أجر خبره. والمفعول محذوف والتقدير: فثوب لبسته وثوب أجره. ويقرأها البعض فثوباً أجر، وعندها يكون مفعولاً مقدماً للفعل بعده]. 11ـ بأن تُعطف على معرفة، أو يُعطف عليها معرفة. فالأول نحو: (خالدٌ ورجلٌ يتعلمان النحو)، والثاني نحو: (رجلٌ وخالدٌ يتعلمان البيان). 12ـ بأن تُعطف على نكرة موصوفة، أو يعطف عليها نكرة موصوفة. فالأول نحو: (قولٌ معروفٌ ومغفرة خيرٌ من صدقة يتبعها أذىً) والثاني نحو: (طاعةٌ وقولٌ معروف) [ طاعة: مبتدأ. وقول: معطوف عليه فهو مبتدأ مثله. والخبر محذوف والتقدير: طاعةٌ وقولٌ معروف أمثل من غيرهما]. 13ـ بأن يُراد بها حقيقة الجنس لا فرد واحدٌ منه، نحو: (ثمرةٌ خيرٌ من جرادة) و (رجلٌ أقوى من امرأة). 14ـ بأن تقع جواباً، نحو: (رجُلٌ) في جواب من قال: (مَن عندك؟). الثالث: جواز حذفه إن دل عليه دليل، تقول: (كيف سعيدٌ؟)، فيقال في الجواب: (مجتهدٌ) أي: هو مجتهد، ومنه قوله تعالى: { من عمل صالحاً فلنفسه، ومن أساء فعليها} و قوله {سورةٌ أنزلناها}. والتقدير في الآية الأولى (فعمله لنفسه، وإساءته عليها)، فيكون المبتدأ، وهو العمل والإساءة، محذوفاً، والجار متعلق بخبره المذوف. والتقدير في الآية الثانية: (هذه سورةٌ). الرابع: وجوب حذفه وذلك في أربعة مواضع: 1ـ إن دل عليه جواب القسم، نحو: (في ذمتي لأفعلن كذا) أي: في ذمتي عهدٌ أو ميثاقٌ. 2ـ إن كان خبره مصدراً نائباً عن فعله نحو: (صبرٌ جميلٌ) و (سمعٌ وطاعةٌ)، أي: صبري صبر جميل، وأمري سمع وطاعة. 3ـ إن كان الخبر مخصوصاً بالمدح أو الذم بعد (نِعم وبِئس)، مؤخراً عنهما، نحو: نِعم الرجل أبو طالب، وبئس الرجل أبو جهل، فأبو، في المثالين، خبرٌ لمبتدأ محذوف تقديره: (هو). 4ـ إن كان في الأصل نعتا قُطع عن النعتية في معرض مدح أو ذم أو ترحم، نحو: (خذ بيد زهيرٍ الكريم) و(دع مجالسة فلان اللئيم) و (أحسن الى فلان المسكين). فالمبتدأ محذوف في هذه الأمثلة وجوباً. والتقدير: هو الكريم وهو اللئيم، وهو المسكين. الخامس: إن الأصل فيه أن يتقدم على الخبر وقد يجب تقديم الخبر عليه. وقد يجوز الأمران (وسيأتي الكلام على ذلك). |
أقسام المبتدأ
المبتدأ ثلاثة أقسام: صريح، نحو: (الكريمُ محبوبٌ)، وضمير منفصل، نحو: (أنت مجتهد)، ومؤول، نحو: (وأن تصوموا خيرٌ لكم)، [والتأويل: (وصومكم خير لكم)، فيكون الفعل في تقدير مصدر مرفوع على أنه مبتدأ]. ونحو: (سواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم)، [والتأويل: (إنذارك وعدم إنذارك سواء)، فما بعد همزة التسوية مؤول بمصدر مرفوع مبتدأ. وسواء قبله خبره. أحكام خبر المبتدأ لخبر المبتدأ سبعة أحكام: الأول: وجوب رفعه. الثاني: أن الأصل فيه أن يكون نكرة مشتقة. وقد يكون جامداً. نحو: (هذا حجرٌ). الثالث: وجوب مطابقته للمبتدأ إفراداً وتثنيةً وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً. الرابع: جواز حذفه إن دل عليه دليل، نحو: (خرجتُ فإذا الأسدُ)، أي: فإذا الأسدُ حاضرٌ، وتقول: (من مجتهدٌ؟) فيقالُ في الجواب: (زهيرٌ) أي: (زهيرٌ مجتهدٌ)، ومنه قوله تعالى: {أُكلها دائمٌ وظِلُها} أي: وظلها كذلك. الخامس: وجوب حذفه في أربعة مواضع: 1ـ أن يدل على صفة مطلقة، أي: دالة على وجود عام. [وذلك بأن تكون بمعنى كائن أو موجود أو مستقر أو حاصل]. وذلك في مسألتين، الأولى: أن يتعلق بها ظرفٌ أو جار ومجرور، نحو: (الجنة تحت أقدام الأمهات) و (والعلم في الصدور). [أي: الجنة كائنة أو موجودة، والعلم كائن أو موجود]. والثانية: أن تقع بعد لولا أو لوما، نحو: (لولا الدِّين لهلك الناسُ) و (لوما الكتابةُ لضاع أكثرُ العلم). [ أي: لولا الدين موجود، ولولا الكتابة موجودة]. 2ـ أن يكون خبراً لمبتدأ صريح في القسم، نحو: (لعَمُرك لأفعلنَّ)، [والتقدير: لعمرك قسمي، أي: حياتك هي قسمي]. فإن كان المبتدأ غير صريح في القسم (بمعنى أنه يستعمل للقسم وغيره) جاز حذف خبره وإثباته. 3ـ أن يكون المبتدأ مصدراً، أو اسم تفضيل مضافاً الى مصدر، وبعدهما حلٌ لا تصلح أن تكون خبراً، وإنما تصلح أن تسدُ مسدّ الخبر في الدلالة عليه. فالأول نحو: (تأديبي الغلامَ مسيئاً)، [والتقدير: تأديبي الغلام حاصل عند إساءته]. والثاني نحو: (أفضل صلاتِكَ خالياً مما يشغلك). 4ـ أن يكون بعد واوٍ متعين أن تكون بمعنى (مع)، نحو: (كلُّ امريءٍ وما فعل)، أي: مع فعله. السادس: جواز تعدده، والمبتدأ واحد نحو: (خليلٌ كاتبٌ، شاعرٌ، خطيبٌ). السابع: أن الأصل فيه أن يتأخر عن المبتدأ. وقد يتقدم عليه جوازاً أو وجوباً وسيأتي الكلام على ذلك. |
الخبر المُفرَد
خبر المبتدأ قسمان: مُفردٌ وجملةٌ. فالخبر المفرد: ما كان غير جملةٍ، وإن كان مثنى أو مجموعاً، نحو: (المجتهدُ محمودٌ، والمجتهدان محمودان، والمجتهدون محمودون). وهو إما جامدٌ، وإما مُشتقٌ. والمُرادُ بالجامدِ ما ليس فيه معنى الوصفِ، نحو: (هذا حجرٌ). وهو لا يتضمنُ ضميراً يعودُ الى المبتدأ، إلا إذا كان في معنى المشتق، فيتضمنه، نحو: (عليٌّ أسدٌ). (فأسد هنا بمعنى شجاع، فهو مثله يحمل ضميراً مستتراً تقديره (هو) يعود الى علي، وهو ضمير الفاعل. وقد سبق في باب الفاعل أن الاسم المستعار، يرفع الفاعل كالفعل، لأنه من الأسماء التي تشبه الفعل في المعنى. وذهب الكوفيون الى أن خبر الجامد يحتمل ضميراً يعود الى المبتدأ، وإن لم يكن في معنى المشتق. فإن قلت: (هذا حجرٌ)، فحجر يحمل ضميراً يعود الى اسم الإشارة (تقديره هو)، وما قولهم ببعيد من الصواب. لأنه لا بُد من رابطٍ يربط المبتدأ بالخبر، وهذا الرابط معتبر في غير العربية من اللغات أيضاً). والمُراد بالمشتق ما فيه معنى الوصف، نحو: (زهيرٌ مجتهد). وهو يتحمل ضميراً يعود الى المبتدأ، إلا إذا رفعَ الظاهرَ، فلا يتحمله، نحو: (زهيرٌ مجتهدٌ أخواه). (فمجتهد في المثال الأول، فيه ضمير مستتر تقديره هو يعود الى زهير، وهو ضمير الفاعل. أما في المثال الثاني فقد رفع (أخواه) على الفاعلية فلم يتحمل ضمير المبتدأ). ومتى تحمَّل الخبرُ ضميرَ المبتدأ لزمتْ مطابقته له إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً، نحو: (عليٌ مجتهد، وفاطمةُ مجتهدةٌ، والتلميذان مجتهدان، والتلميذتان مجتهدتان، والتلاميذ مجتهدون، والتلميذات مجتهدات). فإن لم يتضمن ضميراً يعود الى المبتدأ، فيجوز أن يطابقه، نحو: (الشمسُ والقمرُ آيتان من آيات الله)، ويجوز أن لا يطابقه، نحو: (الناسُ قسمانِ: عالمٌ ومتعلمٌ ولا خيرٌ فيما بينهما). الخبر الجملة الخبر الجملة: ما كان جملةً فعلية، أو جملةً اسميةً، فالأول نحو: (الخُلقُ الحسنُ يُعلي قدرَ صاحبه) [ الخُلقُ: مبتدأ، والحسن: صفة. وجملة يعلي: جملة فعلية خبر]. والثاني نحو: (العاقلُ خُلُقُهُ حسنٌ)، [العاقل: مبتدأ أول، وخُلقهُ مبتدأ ثان، وحسن: خبر المبتدأ الثاني، وجملة المبتدأ الثاني وخبره: جملة اسمية، خبر المبتدأ الأول]. ويُشترطُ في الجملة الواقعة خبراً أن تكون مُشتملةً على رابطٍ يربطها بالمبتدأ. والرابط إما الضمير بارزاً، نحو: (الظلمُ مرتعُهُ وخيمٌ)، أو مستتراً يعودُ الى المبتدأ، نحو: (الحقُ يعلو). أو مُقدراً، نحو: (الفضةُ، الدرهمُ بقرشٍ) [الفضة مبتدأ أول. والدرهم بقرش: مبتدأ ثان، وحسن: خبر المبتدأ الثاني، وجملة المبتدأ الثاني وخبره: جملة اسمية، خبر المبتدأ الأول]. وإما إشارةٌ الى المبتدأ، نحو: (ولباس التقوى ذلك خيرٌ) [لباس: مبتدأ أول، وذلك مبتدأ ثان وخبره، والجملة خبر المبتدأ الأول: والرابط اسم الإشارة]. وإما إعادة المبتدأ بلفظه، نحو: (الحاقةُ ما الحاقة؟) [الحاقة: مبتدأ أول. و (ما): اسم استفهام مبتدأ ثان، والحاقة خبره والجملة خبر المبتدأ الأول]. أو بلفظٍ أعم منه، نحو: (سعيد نعم الرجلُ). (فالرجلُ يعم سعيداً وغيره، فسعيد داخل في عموم الرجل، والعموم مستفاد من (أل) الدالة على الجنس). وقد تكون الجملة الواقعة خبراً نفسَ المبتدأ في المعنى، فلا نحتاج الى رابطٍ، لأنها ليست أجنبيةً عنه فتحتاجَ الى ما يربطها به، نحو: {ُلْ هُوَ اللهُ أحدٌ}، ونحو: (نُطقي اللهُ حسبي}. (فهو: ضمير الشأن. والجملة بعده هي عينه، كما تقول: (هو علي مجتهد) وكذلك قولك: (نطقي الله حسبي) فالمنطوق به، (وهو الله حسبي) هو عين المبتدأ. وهو (نطقي) وأما فيما سبق فإنما احتيج الى الربط لأن الخبر أجنبي عن المبتدأ، فلا بد له من رابط يربطه به). قد يقعُ ظرفاً أو جارّاً ومجروراً. فالأولُ نحو: "المجدُ تحتَ عَلمِ العلمِ"، والثاني نحو: (العلم في الصدور لا في السطور). (والخبر في الحقيقة إنما هو متعلق الظرف وحرف الجر. ولك أن تقدر هذا المتعلق فعلاً كاستقر وكان، فيكون من قبيل الخبر الجملة، واسم فاعل، فيكون من باب الخبر المفرد، وهو الأولى، لأن الأصل في الخبر أن يكون مفرداً). ويُخبرُ بظروف المكان عن أسماء المعاني وعن أسماء الأعيان. فالأول نحو: (لخيرُ أمامك). والثاني نحو: (الجنةُ تحتَ أقدامِ الأمهاتِ). وأما ظروف الزمانِ فلا يُخبَّرُ بها إِلا عن أسماء المعاني، نحو: (السفرُ غداً، والوصولُ بعد غدٍ). إلا إذا حصلتِ الفائدةُ بالإخبار بها عن أسماء الأعيان فيجوزُ، نحو: (الليلةَ الهلاُل)، و (نحن في شهر كذا) و (الوردُ في أيار). ومنه: (ليومَ خمرٌ، وغداً أمرٌ). |
وجوب تقديم المبتدأ
الأصل في المبتدأ أن يَتقدَّمَ. والأصل في الخبر أن يتأخّرَ. وقد يتقدَّمُ أحدهما وجوباً، فيتأخرُ الآخرُ وجوباً. ويجبُ تقديم المبتدأ في ستة مواضعَ: الأول: أن يكون من الأسماء التي لها صدرُ الكلامِ، كأسماء الشرطِ، نحو: (من يَتّقِ اللهَ يُفلحْ)، وأسماء الاستفهام، نحو: (من جاءَ؟)، (وما) التعجُّبيّةِ، نحو: (ما أحسنَ الفضيلةَ!) وكم الخبريةِ نحو: (كم كتاب عندي!). الثاني: أن يكون مُشبّهاً باسم الشرط، نحو: (الذي يجتهد فله جائزةٌ) و (كلُّ تلميذٍ يجتهدُ فهو على هدىً). (فالمبتدأ هنا أشبه اسم الشرط في عمومه، واستقبال الفعل بعده وكونه سبباً لما بعده، فهو في قوة أن تقول: (من يجتهد فله جائزة) و (أي تلميذ يجتهد فهو على هدى). ولهذا دخلت الفاء في الخبر كما تدخل في جواب الشرط). الثالثُ: أن يضافَ الى اسمٍ له صدرُ الكلام، نحو: (غلامُ مَن مجتهدٌ؟) و (زمامُ كم أمر في يدك). [كم: هنا خبرية بمعنى كثير. وأمر مضاف إليها. فإن جعلتها استفهامية نصبت ما بعدها تمييزاً]. الرابعُ: أن يكون مقترناً بلام التأكيد (وهي التي يسمونها لامَ الابتداء)، نحو: (لعبدٌ مؤْمنٌ خيرٌ من مشركٍ). الخامسُ: أن يكون كُل من المبتدأ والخبر معرفةً أو نكرةً، وليس هناك قرينةٌ تعين أحدهما، فيتقدَّم المبتدأ خشيةَ التباس المسنَدِ بالمسنَدِ إليه، نحو: (أخوك علي)، إن أردتَ الإخبارَ عن الأخ، و (عليٌّ أخوكَ)، إن أردتَ الإخبارَ عن علي، ونحو: (أسَنُّ منك أسَنُّ مني) إن قصدتَ الإخبار عمَّن هو أسنُّ من مخاطبك (وأسَنُّ مني أسن منكَ)، إن أردتَ الإخبارَ عمّن هو أسنُّ منكَ نفسِكَ. (فان كان هناك قرينة تميز المبتدأ والخبر، جاز التقديم والتأخير نحو: (رجل صالح حاضر، وحاضر رجل صالح) ونحو (بنو أبنائنا بنونا)، بتقديم المبتدأ، و (بنونا بنو أبنائنا)، بتقديم الخبر. لأنه سواء أتقدم أحدهما أم تأخر، فالمعنى على كل حال أن بنى أبنائنا هم بنونا). السادس: أن يكون المبتدأ محصوراً في الخبر، وذلك بأن يقترنَ الخبرُ بإلا لفظاً نحو: {وما محمدٌ إلا رسولٌ} أو معنًى، نحو: {إنما أنت نذيرٌ}. (إذ المعنى ما أنت إلا نذير. ومعنى الحصر هنا أن المبتدأ (وهو محمد، في المثال الأول) منحصر في صفة الرسالة، فلو قيل: (ما رسول إلا محمد). بتقديم الخبر، فسد المعنى، لأن المعنى يكون حينئذ: أن صفة الرسالة منحصرة في محمد مع أنها ليست منحصرة فيه. بل هي شاملة له ولغيره من الرسل، صلوات الله عليهم. وهكذا الشأن في المثال الثاني). وجوب تقديم الخبر يجبُ تقديم الخبرِ على المبتدأ في أربعة مواضعَ: الأول: إذا كان المبتدأ نكرة غير مفيدةٍ، مخَبراً عنها بظرفٍ أو جار ومجرور، نحو: "في الدارِ رجلٌ" و (عندكَ ضيفٌ) ومنه قوله تعالى: {ولدينا مزيدٌ} و {على أبصارهم غشاوةٌ}. (وإنما وجب تقديم الخبر هنا لأن تأخيره يوهم أنه صفة وأن الخبر منتظر. فإن كانت النكرة مفيدة لم يجب تقديم خبرها، كقوله تعالى: {وأجل مسمى عنده} لأن النكرة وصفت بمسمى، فكان الظاهر في الظرف أنه خبر لا صفة). الثاني: إذا كان الخبر اسمَ استفهامٍ، أو مضافاً الى اسم استفهامٍ، فالأول، نحو: (كيف حالُكَ؟)، [ كيف: اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم، وحالك مبتدأ مؤخر]. والثاني نحو: (ابنُ مَن أنت؟)،[ ابن: خبر مقدم، وهو مضاف الى (من) الاستفهامية. وأنت: مبتدأ مؤخر في محل رفع.] و (صبيحة أيْ يوم سفرُكَ؟)، [صبيحة ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر مقدم: وهو مضاف لأي الاستفهامية وسفرك مبتدأ مؤخر]. (وإنما وجب تقديم الخبر هنا لأن لاسم الاستفهام أو ما يضاف اليه صدر الكلام). الثالثُ: إذا اتصلَ بالمبتدأ ضميرٌ يعود الى شيء من الخبر نحو: (في الدار صاحبها) ومنه قوله تعالى: {أم على قلوبٍ أقفالُها}. وقولُ نُصَيب: أهابُكِ إِجلالاً، وما بكِ قدرةٌ عليَّ، ولكن ملءُ عينٍ حبيبُها (وإنما وجب تقديم الخبر هنا، لأنه لو تأخر لاستلزم عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، وذلك ضعيف قبيح منكر (راجع الكلام على عود الضمير) في الجزء الأول من هذا الكتاب). الرابعُ: أن يكون الخبرُ محصوراً في المبتدأ. وذلك بأن يقترن المبتدأ بإلاّ لفظاً، نحو: (ما خالقٌ إلا اللهُ)، أو معنًى، نحو: (إنما محمودٌ من يجتهدُ). (إذ المعنى: (ما محمود إلا من يجتهد). ومعنى الحصر هنا أن الخبر (وهو خالق، في المثال) منحصر في الله. فليست صفة الخلق إلا له سبحانه، فلو قيل: (وما الله إلا خالق) بتقديم المبتدأ. فسد المعنى، لأنه يقتضي أن لا صفة لله إلا الخلق، وهو ظاهر الفساد. وهكذا الحال في المثال الثاني). |
المبتدأُ الصِّفَة
قد يُرفعُ الوصفُ بالابتداءِ، إن لم يطابق موصوفَةُ تثنيةً أو جمعاً، فلا يحتاجُ الى خبر، بل يكتفي بالفاعل أو نائبه، فيكون مرفوعاً به، ساداً مَسَدَّ الخبر، بشرط أن يتقدَّمَ الوصفَ نفيٌ أو استفهامٌ. وتكونُ الصفةُ حينئذٍ بمنزلة الفعل، ولذلك لا تُثنى ولا تُجمَعُ ولا تُوصفُ ولا تُصغّرُ ولا تُعرَّفُ. ولم يشترط الأخفش والكوفيون ذلك، فأجازوا أن يُقال: (ناجحٌ ولداكَ، وممدوحٌ أبناؤك). ولا فرقَ بينَ أن يكونَ الوصفُ مشتقّاً، نحو: (ما ناجحٌ الكسولان) [ما: نافية،وناجح: مبتدأ، والكسولان: فاعل ناجح أغنى عن الخبر] و (هل محبوبٌ المجتهدون) [هل: حرف استفهام، ومحبوب: مبتدأ، والمجتهدون: نائب فاعل لمحبوب أغنى عن الخبر]، أو اسماً جامداً فيه معنى الصفة، نحو: (هل صَخْرٌ هذانِ المُعاندان؟) [صخر: مبتدأ، وهو اسمٌ جامد بمعنى الوصف، لأنه بمعنى صلب، وهذان: فاعل لصخر أغنى عن الخبر] و (ما وحشيٌّ أخلاقُكَ) [وحشي: مبتدأ، وهو اسم جامد فيه معنى الصفة، لأنه اسم منسوب، فهو بمعنى اسم المفعول، وأخلاقك: نائب فاعل له أغنى عن الخبر]. ولا فرقَ أيضاً بينَ أن يكونَ النفيُ والاستفهام بالحرف، كما مُثلَ، او بغيره، نحو: (ليسَ كسولٌ ولداكِ) و (غيرُ كسولٍ أبناؤكَ) و (كيف سائرٌ أخواكَ)، غير أنهُ معَ (ليسَ) يكونُ الوصفُ اسماً لها، والمرفوعُ بعدَهُ مرفوعاً به سادّاً مسَدَّ خبرها، ومع (غيرٍ) ينتقلْ الابتداءُ إليها، ويُجر الوصفُ بالإضافة إليها، ويكونُ ما بعدَ الوصفِ مرفوعاً به سادّاً مسدَّ الخبر. وقد يكونُ النفيُ في المعنى نحو: (إنما مجتهدٌ ولداكَ)، إذ التأويلُ: (ما مجتهدٌ إلاّ ولداكَ). فان لم يقع الوصفُ بعد نفيٍ أو استفهامٍ، فلا يجوز فيه هذا الاستعمالُ، فلا يقالُ: (مجتهد غلاماكَ)، بل تجبُ المطابقةُ، نحو: (مجتهدانِ غلاماك). وحينئذٍ يكونُ خبراً لما بعده مُقدَّماً عليه. وقد يجوزُ على ضعفٍ، ومنه الشاعر: خَبِيرٌ بَنُو لِهْبٍ، فَلا تَكُ مُلْغِياً مَقالةَ لِهْبيٍّ، إِذا الطَّيْرُ مَرَّتِ [بنو لِهْب، بكسر اللام وسكون الهاء، حي من الأزد مشهورون بزجر للطير وعيافتها، وذلك أن يستسعدوا ويتشاءموا بأصواتها ومساقطها. واللهب في الأصل: هو الصدع في الجبل أو المهواة بين جبلين. وجمعه ألهاب ولهوب ولهاب ولهابة] والصفةُ التي تقعُ مبتدأ، إنما ترفعُ الظاهرَ، كقول الشاعر: أَقاطِنٌ قَوْمُ سَلْمَى، أمْ نَوَوْا ظَعَنا؟ إِنْ يَظْعَنُوا فَعَجِيبٌ عَيْشُ ومَنْ قَطَنا [قاطن: مقيم. والظعن: الرحيل] او الضميرَ المنفصلَ، كقول الآخر: خَليليَّ، ما وافٍ بِعَهْدِيَ أنتُما إذا لم تكونا لي على مَنْ أُقاطِعُ فان رفعتِ الصفةُ الضميرَ المستترَ، نحو: (زُهيرٌ لا كسولٌ ولا بَطيءٌ) لم تكن من هذا الباب، فهي هنا خبرٌ عمّا قبلَها. وكذا إن كانت تكتفي بمرفوعها، نحو: (ما كسولٌ أخواهُ زُهيرٌ)، فهي هنا خبر مقدَّمٌ، وزهيرٌ: مبتدأ مؤخر، وأخواهُ: فاعلُ كسول. واعلم أن الصفةَ، التي يُبتدأُ بها، فتكتفي بمرفوعها عن الخبر، إنما هي الصفةُ التي تُخالفُ ما بعدها تثنيةً أو جمعاً، كما مَرَّ. فان طابقتهُ في تثنيتهِ أو جمعه، كانت خبراً مُقدَّماً، وكان ما بعدها مبتدأ مؤخراً، نحو: (ما مُسافرانِ أخوايَ، فهل مسافرونَ إخوتُكَ؟). أمَّا إن طابقته في إفراده، نحو: (هل مسافرٌ أخوكَ؟)، جاز جعل الوصفِ مبتدأً، فيكونُ ما بعدَه مرفوعاً به، وقد أغنى عن الخبر، وجاز جعلُهُ خبراً مُقدماً وما بعدهُ مبتدأً مؤخراً. |
الفعل الناقص
الفعل الناقصُ: هو ما يدخل على المبتدأ والخبر، فيرفعُ الأول تشبيهاً له بالفاعل، وينصبُ الآخرَ تشبيهاً له بالمفعول به، نحو: "كان عُمرُ عادلاً". ويُسمّى المبتدأُ بعد دخوله اسماً له، والخبرُ خبراً له. (وسميت هذه الافعال ناقصة، لأنها لا يتم بها مع مرفوعها كلام تام، بل لا بد من ذكر المنصوب ليتم الكلام. فمنصوبها ليس فضلة، بل هو عمدة، لأنه في الأصل خبر للمبتدأ، وإنما نصب تشبيهاً له بالفضلة، بخلاف غيرها من الافعال التامة، فان الكلام ينعقد معها بذكر المرفوع، ومنصوبها فضلة خارجة عن نفس التركيب). والفعلُ الناقصُ على قسمينِ: كانَ وأخواتُها. وكاد وأخواتها. (وهي التي تُسمى أفعالَ المُقارَبة). كان وأَخواتها كانَ وأَخواتُها هي: (كان وأمسى وأصبحَ وأضحى وظلَّ وباتَ وصارَ وليسَ وما زالَ وما انفكَّ وما فَتيءَ وما بَرِحَ وما دامَ). وقد تكونُ (آض ورجَعَ واستحال وعادَ وحارَ وارتدَّ وتَحوَّل وغدا وراحَ وانقلبَ وتَبدَّل)، بمعنى (صارَ)، فان أتت بمعناها فلها حُكمُها. ويتعلّقُ بكانَ وأخواتها ثمانيةُ مباحثَ: (1) مَعاني كانَ وأَخواتِها معنى (كان): اتصافُ المُسنَدِ في الماضي. وقد يكون اتصافهُ به على وده الدَّوام، إن كان هناك قرينةٌ، كما في قوله تعالى: {وكانَ اللهُ عليماً حكيماً}، أي: إنه كان ولم يَزلْ عليماً حكيماً. ومعنى (أمسى): اتصافُه به في المساء. ومعنى (أصبحَ): اتصافُهُ به في الصباح. ومعنى (أضحى): اتصافه به في الضحا. ومعنى (ظلَّ): اتصافه به وقتَ الظلِّ، وذلك يكون نهاراً. ومعنى (بات): اتصافُهُ به وقتَ المَبيت، وذلك يكون ليلاً. ومعنى (صار): التَّحوُّل، وكذلك ما بمعناها. ومعنى (ليس): النفي في الحال، فهي مختصةٌ بنفي الحال، إلا إذا قُيّدت بما يُفيدُ المُضيّ أو الاستقبال، فتكون لِما قُيّدتْ به، نحو: (ليس عليٌّ مُسافراً أمسِ أو غداً). و (ليس): فعلٌ ماضٍ للنفي، مختصٌّ بالأسماءِ: وهي فعلٌ يُشبهُ الحرفَ. ولولا قَبولها علامةَ الفعلِ، نحو: (ليستْ وليسا وليسوا ولسنا ولسن)، لحكمنا بحرفيّتها. ومعنى (ما زال وما انفكَّ وما فتيءَ وما برحَ): مُلازمة المُسنَد للمسنَد إليه، فإذا قلتَ (ما زالَ خليلٌ واقفاً) فالمعنى أنه ملازمٌ للوقوف في الماضي. ومعنى (ما دام) استمرارُ اتصافِ المُسندِ إليه بالمُسندِ. فمعنى قولهِ تعالى: {وأوصاني بالصلاة والزكاةِ ما دُمتُ حياً}: أوصاني بهما مدةَ حياتي. وقد تكون (كان وأمسى وأصبح وأضحى وظلَّ وبات) بمعنى(صار)، إن كان هناك قرينةٌ تدلُّ على أنه ليسَ المرادُ اتصافَ المسنَد إليه بالمسنَد في وقت مخصوص، مما تدلُّ عليه هذه الأفعال، ومنه قوله تعالى: {فكان من المُغرَقينَ} أي: صار، وقوله: {فأصبحتم بنعمتهِ إخواناً}، أي: صرتم، وقوله: {فظلتْ أعناقُهم لها خاضعين}، أي: صارت، وقوله: {ظلَّ وجهُهُ مسوداً}، أي: صار. |
(2) شُروط بعضِ أَخواتِ (كان)
يُشترَطُ في (زالَ وانفكَّ وفتيءَ وبرحَ) أن يتقدَّمَها نفيٌ، نحو: {لا يزالونَ مختلفينَ} و {لن نبرحَ عليه عاكفين}، أو نهيٌ، كقول الشاعر: صاحِ شَمِّرْ، ولا تَزَلْ ذاكِرَ الْمَوْ تِ فَنسْيانُهُ ضَلالٌ مُبِينُ أو دُعاءٌ، نحو: (لا زِلتَ بخيرٍ). وقد جاء حذفُ النهي منها بعد القسم، والفعلُ مضارعٌ منفيٌّ بلاَ وذلك جائزٌ مُستملَحٌ، ومنه قولهُ تعالى: {تاللهِ تَفتأُ تذكُرُ يوسفَ}، والتقديرُ: (لا تفتأُ) وقولُ امرئ القيس: فقُلْتُ: يَمينُ اللهِ أَبرحُ قاعداً ولَوْ قَطَعُوا رأْسي لَدَيْكِ وأَوصالي والتقديرُ: (لا أبرح قاعداً). ولا يُشترطُ في النفي أن يكون بالحرف، فهو يكونُ به، كما مرَّ، ويكونُ بالفعل، نحو: (لستَ تبرحُ مجتهداً)، وبالاسم، نحو: (زُهيرٌ غيرُ مُنفكٍّ قائماً بالواجب). وقد تأتي "وَنَى يني، ورامَ يَريمُ" بمعنى (زالَ) الناقصة، فيَعملانِ عمَلها. ويُشترطُ فيهما ما يُشترطُ فيها، ومنه قولُ الشاعر: فأَرحامُ شِعْرٍ يَتَّصِلْنَ ببابهِ وأرحامُ مالٍ لا تَني تَتَقَطَّعُ أي: لا تزالُ تتقطّعُ، وقول الآخر: إذا رُمتَ، مِمَّنْ لا يَريمُ مُتَيَّماً، سُلُوّاً فَقَدْ أَبعَدْتَ في رَوْمِكَ المَرْمَى، أي: (لا يزالُ، أو لا يبرحُ مُتَيَّماً). وأصل معنى الونى: الفتور والضعف، وأصل معنى الريم: البراح. فإن قلت: (ما ونى فلان في عمله) و (ما رمت الدار) فهما تامتان. وإن قلت: (ما ونى فلانٌ مجتهداُ، وما رمت عاملاً)، فهما ناقصتان. بمعنى ما زال وما برح. وكل فعل تام تضمن معنى فعل ناقص عمل عمله. ويشترطُ في (دامَ) أن تتقدَّمها (ما) المصدريَّةُ الظرفيّةُ، كقوله تعالى:{وأوصاني بالصلاة والزَّكاةِ وما دُمتُ حَيًّا}. (ومعنى كونها مصدرية أنها تجعل ما بعدها في تأويل مصدر. ومعنى كونها ظرفية أنها نائبة عن الظرف وهو المدة، لأن التقدير: (مدة دوامي حياً)). (تنبيه)- زال الناقصة مضارعها (يزال). وأما (زال الشيء يزول) بمعنى (ذهب) و (زال فلان هذا عن هذا)، بمعنى (مازه عنه يميزه، فهما فعلان تامان. ومن الأول قوله تعالى: {إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا}. وقد يُضَمرُ اسمُ "كانَ" وأخواتها، ويُحذفُ خبرُها، عند وجودِ قرينةٍ دالةٍ على ذلك، يُقالُ: (هل أصبح الرَّكبُ مسافراً؟) فتقولُ: (أصبح)، والتقديرُ: (أصبحَ هو مسافراً). |
أَقسامُ كان وأَخَواتها
تنقسمُ (كان وأخواتُها)إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما لا يتصرفُ بحالٍ؛ وهو: (ليسَ ودام) فلا يأتي منهما المضارعُ ولا الأمرُ. الثاني: ما يتصرَّفُ تَصرُّفاً تاماً، بمعنى أنه تأتي منه الأفعال الثلاثةُ، وهو: (كان وأصبَحَ وأمسى وأضحى وظَلَّ وباتَ وصارَ). الثالث: ما يتصرَّفُ تصرُّفاً ناقصاً، بمعنى أنهُ يأتي منه الماضي والمضارع لا غيرُ، وهو: (ما زالَ وما انفكَّ وما فتيءَ وما بَرِحَ). واعلم أن ما تصرَّفَ من هذه الأفعال يعملُ عملَها، فيرفع الاسم وينصبُ الخبرَ، فعلاً كان أو صفةً، أو مصدراً، نحو: يمسي المجتهدُ مسروراً، وأمسِ أديباً، وكونُكَ مجتهداً خيرٌ لك، قال تعالى: {قُلْ كونوا حجارةً أو حديداً}، وقال الشاعر: وما كُلُّ مَنْ يُبْدِي البَشاشةَ كائناً أَخاكَ، إذا لم تُلْفِهِ لَكَ مُنْجِدا غيرَ أنَّ المصدرَ كثيراً ما يُضافُ الى الاسم، نحو: (كونُ الرجلِ تقيّاً خيرٌ لهُ). (فالرجل: مجرور لفظاً، لأنه مضاف إليه، مرفوع محلاً، لأنه اسم المصدر الناقص). وإن أُضيفَ المصدرُ الناقصُ الى الضمير أو الى غيرهِ من المبنيّات، كان له محلاّنِ من الإعراب: محلٌّ قريبٌ وهو الجرُّ بالإضافة، ومحلٌّ بعيدٌ، وهو الرفع، لأنه اسمٌ للمصدر الناقص، قال الشاعر: بِبَذْلٍ وحِلْمٍ سادَ في قَوْمِهِ الْفَتَى وكونُكَ إِيَّاهُ عَلَيْكَ يَسيرُ تَمامُ "كانَ" وأَخواتِها قد تكونُ هذه الأفعال تامَّةً، فتكتفي برفع المُسنَدِ إليه على أنهُ فاعلٌ لها، ولا تحتاجُ الى الخبر، إلاّ ثلاثةَ أفعالٍ منها قد لَزِمَتْ النّقصَ، فلم تَرِد تامَّةً، وهي: (ما فتيءَ وما زال وليس) فإذا كانت (كان) بمعنى: حصل، و (أمسى) بمعنى: دخل في المساء، و (أصبح) بمعنى: دخل في الصباح، و (أضحى) بمعنى: دخل في الضحى، و (ظل) بمعنى: دام واستمر، و (بات) بمعنى نزل ليلاً، أو أدركه الليل، أو دخل مبيته، و (صار) بمعنى انتقل، أو ضم وأمال أو صوت، أو قطع وفصل، و (دام) بمعنى :بقي واستمر، (وانفك) بمعنى: انفصل أو انحل، و (برح) بمعنى: ذهب، أو فارق، كانت تامة تكتفي بمرفوع هو فاعلها). ومن تمام هذه الأفعال قولهُ تعالى: {إنما أمرُهُ إذا أراد شيئاً أن يقولَ له كُن فيكونُ}، وقوله: {وإن كان ذو عُسرةٍ فنَظرةٌ الى ميسَرةٍ}، وقولهُ: {فسبحانَ الله حينَ تُمسونَ وحين تُصبحون}، وقولهُ: {خالدينَ فيهما ما دامت السمواتُ والأرضُ} وقوله: {فخُذْ أربعةً من الطَّير فَصُرْهُنَّ إليك}، قُريءَ بضم الصاد، من صارَهُ يَصورُهُ، وبكسرها، من صارهُ يَصرُهُ، وقول الشاعر: َتطاوَلَ لَيْلُكَ بالإثْمِدِ وباتَ الخَليُّ، ولم تَرْقُدِ |
أسام كان وأخواتها
مجهود رائع ومفيد .. شكرا لك
واصل هذا البحث القيم كثير من التلاميذ يستفيدون منه |
أشكركم أخي الفاضل على مروركم الكريم
|
أَحكامُ اسم (كانَ) وخَبَرُها
كل ما تَقدَّمَ من أحكامِ الفاعلِ وأقسامه، يَعطى لاسم (كانَ) وأخواتها لأن لهُ حُكمَهُ.وكلُّ ما سبقَ لخبر المبتدأ من الأحكامِ والأقسامِ، يُعطى لخبر (كان) وأخواتها، لأنَّ لهُ حُكمَهُ، غيرَ أنه يجبُ نصبُهُ، لأنهُ شبيهٌ بالمفعول به. وإذا وقع خبرُ (كانَ) وأخواتها جملةً فعليةً، فالأكثرُ أن يكونَ فعلُها مضارعاً، وقد يجيءُ ماضياً، بعد (كانَ وأمسى وأضحى وظلَّ وبات وصارَ). والأكثرُ فيه، إن كانَ ماضياً، أن يقترن بِقدْ، كقول الشاعر: فأَصبَحُوا قَدْ أَعادَ اللهُ نِعْمَتَهُمْ إذْ هُمْ قُرَيْشٌ، وإِذْ ما مِثْلُهُمْ أَحدُ وقد وقعَ مجرَّداً منها، وكثر ذلكَ في الواقعِ خبراً عن فعلِ شرطٍ، ومنه قولهُ تعالى: {وإن كانَ كبُرَ عليكم مَقامي}، وقوله: "إن كانَ كبُرَ عليكَ إِعراضُهم" وقولهُ: {إن كنتُ قُلْتَهُ فَقدْ علِمتَهُ} وقلَّ في غيره، كقول الشاعر: أَضْحَتْ خَلاءَ، وأَضْحَى أَهلُها احتَمَلوا أَخنى عَلَيها الذي أَخنى على لُبَدِ وقولِ الآخر: وكانَ طَوَى كَشْحاً على مُسْتَكِنَّةٍ فَلا هُوَ أَبداها، ولم يَتَقَدَّمِ أَحكامُ اسمِها وخَبَرِها في التَّقديم والتأخير الأصلُ في الاسمِ أن يَليَ الفعلَ الناقصَ، ثمَّ يجيء بعدَه الخبرُ. وقد يُعكَسُ الأمرُ، فيُقدَّمُ الخبرُ على الاسمِ، كقوله تعالى: {وكانَ حقاً علينا نَصرُ المؤْمنين}، وقولِ الشاعر:: لا طِيبَ لِلعَيشِ ما دامتْ مُنَغَّصَةً لذَّاتُهُ بادِّكارِ الشَّيْبِ والهَرَم وقول الآخر: سَلي، إن جَهِلْتِ الناسَ عَنَّا وعنهُمُ فَلَيْسَ سَواءَ عالمٌ وجَهولٌ. ويجوزُ أن يتقدَّمَ الخبرُ عليها وعلى اسمها معاً، إلا (ليسَ) وما كان في أوَّلهِ (ما) النافيةُ أو (ما) المصدريَّةُ، فيجوزُ أن يُقالَ (مُصحِية، كانتِ السماءُ) و(غزيراً أمسى المطرُ)، ويَمتنعُ أن يُقالَ: (جاهلاً ليس سعيدٌ)، و (كسولاً ما زال سليمٌ) و (أقفُ، واقفاً ما دام خالدٌ). وأجازه بعضُ العلماءِ في غير (ما دام). أمّا تقدُّمُ معمولِ خبرِها عليها فجائزٌ أيضاً، كما يجوزُ تقدُّمُ الخبر، قال تعالى: {وأنفسَهم كانوا يَظلمون}، وقال: "أهؤلاءِ إياكم كانوا يعبُدون}. واعلَمْ أن أحكامَ اسمِ هذه الأفعال، وخبرها في التقديم والتأخير، كحكم المبتدأ وخبره، لأنهما في الاصل مبتدأٌ وخبرٌ. |
خَصائِصُ (كانَ)
تختصُّ (كان) من بينِ سائرِ أخواتها بستَّةِ أشياءَ: 1ـ أنها قد تُزادُ بشرطينِ: أحدهما أن تكونَ بلفظ الماضي، نحو: ((ما (كان) أصحَّ عِلمَ من تقدَّمَ؟)). وشذت زيادتها بلفظ المضارع في قول أُم عَقيل ابن أبي طالب: أَنتَ (تَكُونُ) ماجِدٌ نَبِيلٌ إذا تَهبُّ شَمْأَلٌ بَليلُ والآخر أن تكون بينَ شيئينِ مَتلازمينِ، ليسا جاراً ومجروراً. وشذَّت زيادتُها بينهما في قول الشاعر: جِيادُ بَني أَبي بَكْرٍ تَسَامَى على (كانَ) المُسَوَّمَةِ العِرابِ وأكثرُ ما تزادُ بينَ (ما) وفعلِ التَّعجُّبِ، نحو((ما (كان) أعدلَ عُمرَ!)) . وقد تُزادُ بينَ غيرهما ومنه قولُ الشاعر: (وقد زادّها بينَ "نِعْمَ" وفاعلها). ولَبِسْتُ سِرْبالَ الشبابِ أَزورُها وَلَنِعْمَ (كانَ) شَبيبَةُ المُحتالِ وقولُ بعضِ العرَبِ: (وقد زادّها بين الفعل ونائب الفاعل) وَلَدتْ فاطمةُ - بنتُ الخُرْشُبِ الكَمَلةَ من بني عَبْس، لم يُوجَدْ (كانَ) مِثلُهُم، وقول الشاعر: (وقد زادَها بينَ المعطوف عليه والمعطوف): في لُجَّةٍ غَمَرَتْ أَباكَ بُحُورُها في الجاهِلِيَّة (كانَ) والإِسلامِ [فاطمة بنت الخُررشب: هي فاطمة الأنمارية، ولدت لزياد العبسي. والكَمَلَة: (جمع كامل) وهم ربيع الكامل، وقيس الحافظ، وعمارة الوهاب، وأنس الفوارس. وقد قيل لها أي بنيكِ أحب إليكِ؟ فقالت: ربيع، بل عمارة، بل قيس، بل أنس، ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل، والله إنهم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها؟ والخُرشب: الغليظ الجافي، والطويل السمين]. وقول الآخر: (وقد زادَها بينَ الصفة والموصوف): في غُرَفِ الجَنَّةِ العُلْيا التي وَجَبَتْ لَهم هُناكَ بِسَعْيٍ (كان) مَشكور (واعلم أن (كان) الزائدة معناها التأكيد، وهي تدل على الزمان الماضي. وليس المراد من تسميتها بالزائدة أنها لا تدل على معنى ولا زمان، بل المراد أنها لا تعمل شيئاً، ولا تكون حاملة للضمير، بل تكون بلفظ المفرد المذكر في جميع أَحوالها. ويرى سيبويه أنها قد يلحقها الضمير، مستدلاً بقول الفرزدق): فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا (كانوا) كرام 2ـ أنها تُحذَفُ هي واسمها ويبقى خبرُها، وكثرَ ذلك بعدَ (أنْ ولو) الشرطيَّتينِ. فمثالُ (إنْ) : (سِرْ مُسرعاً، إن راكباً، وإن ماشياً)، وقولهم (لناسُ مَجزِيُّونَ بأعمالهم، إنْ خيراً فخيرٌ، وإن شرّاً فَشرٌّ)، وقولُ الشاعر: لا تَقْرَبَنَّ الدَّهرَ آلَ مُطَرِّفٍ إنْ ظالماً أَبداً، وإِنْ مَظْلوما وقولُ الآخر: حَدَبَتْ عَلَيَّ بُطونُ ضَبَّةَ كُلُّها إنْ ظالماً فيهم، وإنْ مَظلوماً [ والتقدير: إن كنت ظالماً، وإن كنت مظلوماً] وقول غيرهِ: قَدْ قيلَ ما قِيلَ، إِنْ صِدْقاً، وإِنْ كَذِباً فَما اعتِذارُكَ من قَولٍ إذا قيلا؟! ومثالُ (لو) حديثُ: (التَمِسْ ولو خاتماً من حديد). وقولهم (الإطعامَ ولو تمراً)، وقول الشاعر: لا يأْمَنِ الدَّهرَ ذو بغْيٍ، وَلَوْ مَلِكاً جُنُودُهُ ضاقَ عنها السَّهْلُ والجَبَلُ 3ـ أنها قد تُحذفُ وحدَها، ويبقى اسمُها، وخبرُها، ويعوَّضُ منها "ما" الزائدةُ، وذلك بعدَ "أن" المصدريَّةِ، نحو: "أمّا أنتَ ذا مال تَفتخرُ!"، والأصلُ: (لأنْ كنتَ ذا مالٍ تَفتخرُ!). (فحذفت لام التعليل، ثم حذفت (كان) وعوض منها (ما) الزائدة وبعد حذفها انفصل الضمير بعد اتصاله، فصارت (أن ما أنت)، فقلبت النون ميماً للإدغام، وأدغمت في ميم (ما) فصارت (أما). ومن ذلك قول الشاعر: أَبا خُراشةَ، أَمَّا أَنتَ ذا نَفَر! فإنَّ قَوْمِيَ لَمْ تأْكُلْهُمُ الضَّبُعُ [والتقدير: لأن كنت ذا نفر افتخرت علي أو هددتني، لا تفتخر علي، فإن قومي لم تأكلهم الضبع. وأراد بالضبع السنة المجدبة مجازاً، أو الضبع حقيقة، فيكون الكلام كناية عن عدم ضعف قومه، لأن القوم إذا ضعفوا عاثت فيهم الضباع] 4ـ أنها قد تُحذَف هي واسمها وخبرُها معاً، ويَعوَّضُ من الجميع (ما) الزائدةُ، وذلك بعد (إن) الشرطيةِ، في مثل قولهم: (افعل هذا إِما لا). ((والأصل (افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره). فحذفت (كان) مع اسمها وخبرها وبقيت (لا) النافية الداخلة على الخبر، ثم زيدت (ما) بعد (أن) لتكون عوضاً، فصارت (إن ما)، فأدغمت النون في الميم، بعد قلبها ميماً، فصارت (إما) )). 5ـ أنها قد تُحذَفُ هي واسمها وخبرُها بلا عِوَضٍ، تقولُ: (لا تعاشر فلاناً، فانه فاسدُ الاخلاقِ)، فيقولُ الجاهلُ: (أني أُعاشرُهُ وإن)، أي: وإن كان فاسدَها، ومنه: قالَتْ بَناتُ الْعَمِّ: يا سَلْمَى، وإنْ كان فَقيراً مُعْدِماً؟! قالَتْ: وإنْ تُريدُ: إني أَتزَوَّجهُ وإن كان فقيراً مُعدِماً. 6ـ أنها يجوزُ حذفُ نونِ المضارع منها بشرط أن يكون مجزوماً بالسكون، وأن لا يكونَ بعده ساكنٌ، ولا ضميرٌ متصلٌ. ومثال ما اجتمعت فيه الشروطُ قولهُ تعالى: {لم أكُ بَغِيّاً}، وقول الشاعر: ألَمْ أَكُ جارَكُمْ ويَكونَ بَيْني وبَيْنَكُمُ الْمَودَّةُ والإِخاءُ والأصلُ: (ألمْ أكنْ). وأما قولُ الشاعر: فإن لم تَكُ المِرآةُ أبدَت وسَامَةً فَقَدْ أَبدَت المِرآة جَبْهَةَ ضَيغَم [ الضيغم: الأسد، وأصله يعض، من ضغمه ضغماً، إذا عضه] وقول الآخر: إذا لَمْ تَكُ الحاجاتُ مِنْ هِمَّة الْفَتَى فَلَيْسَ بِمُغْنٍ عَنْكَ عقْدُ الرَّتائِم [الرتائم: جمع رتيمة، وهو خيط رفيع يعقد في الإصبع للتذكير] فقالوا: انه ضرورة. وقال بعضُ العلماءِ: لا بأسَ بحذفها إن التقت بساكن بعدَها. وما قوله ببعيدٍ من الصواب. وقد قُريءَ شُذوذاً: {لم يَكُ الذينَ كفروا}. خصوصيَّةُ (كانَ ولَيْسَ). تختصُّ (ليسَ وكانَ) بجوازِ زيادةِ الباء في خبريهما، ومنهُ قولهُ تعالى: {أليسَ اللهُ بأحكمِ الحاكمين}. أما (كان) فلا تزادُ الباءُ في خبرها إلاّ إذا سبقها نفيٌ أو نهيٌ نحو: (ما كنتُ بحاضرٍ) و (لا تكنْ بغائب)، وكقول الشاعر: وإن مُدَّتِ الأَيدي إلى الزَّادة، لَمَّ أَكُنُ بأَعْجَلهمْ، إِذْ أَجْشَعُ الْقَوْمِ أَعجَلُ على أنَّ زيادةَ الباء في خبرها قليلةٌ، بخلافِ (ليس)، فهي كثيرة شائعة. |
كاد وأخواتها
أو أفعالُ المقارَبةِ (كادَ وأخواتُها) تعملُ عملَ (كان)، فترفعُ المبتدأ، ويُسمّى اسمها، وتنصبُ الخبرَ، ويُسمّى خبرها. وتُسمّى: أفعالُ المقاربة. (وليست كلها تفيد المقاربة، وقد سمي مجموعها بذلك تغليباً لنوع من أنواع هذا الباب على غيره. لشهرته وكثرة استعماله). وفي هذا المبحث ستةُ مباحثَ: 1ـ أقسامُ (كادَ) وأَخواتِها (كادَ وأخواتها) على ثلاثة أقسام: أ ـ أفعال المقارَبة، وهيَ ما تَدُل على قُرب وقوع الخبر. وهي ثلاثةٌ: (كادَ وأوشكَ وكرَبَ)، تقولُ: (كادَ المطرُ يَهطِلُ) و (أوشكَ الوقتُ أن ينتهي) و (كرَبَ الصبحُ أن يَنبلج). ب ـ أفعال الرَّجاءِ، وهي ما تَدُل على رجاءِ وقُوع الخبر. وهي ثلاثةٌ أيضا: (عَسى وحرَى واخلولقَ)، نحو: (عسى الله أن يأتيَ بالفتح)، وقول الشاعر: عَسَى الْكرْبُ الْذي أمسَيْتُ فيه يَكونُ وَراءَهُ فَرَجٌ قريبُ ونحو: (حَرَى المريضُ ان يشفى) و (اخلولقَ الكسلانُ أن يجتهدَ). [خَلِقَ واخلولق: استوى واملاس، اخلولقت الغيمة أي املست واستوت وأصبحت جاهزة للمطر: من ابن منظور ـ لسان العرب] ج ـ أفعال الشروع، وهي ما تدل على الشروعُ في العمل، وهي كثيرةٌ، منها: (أنشأ وعَلِقَ وطَفِقَ وأخذَ وهَبَّ وبَدأَ وابتدأ وجعلَ وقامَ وانبرى). ومثلُها كلُّ فعلٍ يَدُلُّ على الابتداء بالعمل ولا يكتفي بمرفوعه، تقولُ: (أنشأ خليلٌ يكتُبُ، عَلِقوا ينصرفون، وأخذُوا يَقرءُونَ، وهَبَّ القومُ يتسابقونَ، وبَدَءُوا يَتبارَونَ، وابتدءُوا يتقدَّمونَ، وجعلوا يَستيقظونَ، وقاموا يتنبَّهونَ، وانبَروْا يسترشدونَ). وكلُّ ما تقدَّمَ للفاعل ونائبهِ واسم (كانَ)، من الأحكام والأقسام، يُعطَى لاسمِ (كادَ) وأخواتها. 2ـ شُروطُ خَبَرِها يُشترَطُ في خبر (كاد وأخواتها) ثلاثةُ شروطٍ: أ ـ أن يكون فعلاً مضارعاً مُسنَداً الى ضميرٍ يعودُ الى اسمها، سواءٌ أكان مُقترناً بِـ (أنْ)، نحو: (أوشك النهارُ أن ينقضيَ)، أم مُجرَّداً منها، نحو: (كادَ الليلُ ينقضي)، ومن ذلك قولُه تعالى: {لا يكادونَ يفقهونَ حديثاً}، وقولهُ: {وطفِقا يخصِفانِ عليهما من وَرَقِ الجنَّةِ}. ويجوزُ بعدَ (عسى) خاصَّة أن يُسنَدَ الى اسمٍ ظاهرٍ، مُشتملٍ على ضميرٍ يعودُ الى اسمها، نحو: (عسى العاملُ أن ينجحَ عملُه) ومنه قولُ الشاعر: ومَاذا عَسى الحَجَّاجُ يَبْلُغُ جُهْدُهُ إِذا نحنُ جاوَزْنا حَفِيرَ زِيادِ ولا يجوزُ أن يقَعَ خبرُها جملةً ماضيةً، ولا اسميةً، كما لا يجوزُ أن يكون اسماً. وما وَرَدَ من ذلكَ، فشاذٌّ لا يُلتفتُ إليه. وأما قولهُ تعالى: {فطَفِقَ مَسحاً بالسوق والأعناقِ}، فمسحاً ليس هو الخبرَ، وإنما هو مفعولٌ مطلقٌ لفعلٍ محذوفٍ هو الخبرُ، والتقديرُ: (يمسح مسحاً). ب ـ أن يكون متأخراً عنها. ويجوزُ أن يتوسَّطَ بينها وبينَ اسمها، نحو: (يكادُ ينقضي الوقتُ). ونحو (طَفِقَ ينصرفون الناسُ). ويجوزُ حذفُ الخبرِ إذا عُلِمَ، ومنهُ قولهُ تعالى، الذي سبق ذكرهُ: {فطفقَ مسحاً بالسُّوقِ والأعناقِ}، ومنه الحديثُ: (من تأنّى أصاب أو كادَ، ومن عَجلَ اخطأ أو كادَ)، أي: كادَ يُصيبُ، وكادَ يخطئ، ومنه قولُ الشاعر: ما كانَ ذَنْبيَ في جارٍ جَعَلْتُ لهُ عَيْشاً، وقدْ ذاقَ طَعْمَ المَوْتِ أو كَرَبا أي: كربَ يَذوقُهُ، وتقولُ: (ما فعلَ، ولكنهُ كادَ)، أي: كادَ يفعلُ. ج ـ يُشترطُ في خبر(حَرَى واخلولقَ) أن يقترنَ بِـ (أن). |
3ـ الخَبرُ المُقْترنُ بأن
(كادَ وأخواتها) من حيثُ اقترانُ خبرِها بأنْ وعدَمُه على ثلاثة أقسام: أ ـ ما يجب أن يقترنَ خبرُه بها، وهما: (حرَى واخلولقَ)، من أفعال الرّجاءِ. ب ـ ما يجبُ أن يتجرَّدَ منها، وهي أفعال الشروع. (وإنما لم يجز اقترانها بأن، لان المقصود من هذه الأفعال وقوع الخبر في الحال، و(أن) للاستقبال، فيحصل التناقض باقتران خبرها بها). ج ـ ما يجوزُ فيه الوجهانِ: اقترانُ خبرهِ بأنْ، وتَجردُه منها، وهي أفعال المقارَبة، و (عسى) من أفعال الرَّجاءِ، غير أنَّ الأكثر في (عسى وأوشكَ) أن يقترنَ خبرُهما بها، قال تعالى: {عسى رَبُّكم أن يرحمَكم}، وقال الشاعر: ولَوْ سُئِلَ النّاسُ التُّرابَ لأَوشَكوا إِذا قِيلَ: هاتوا، أنْ يَمَلّوا ويمنعُوا وتجريدُه منها قليلٌ، ومنه قول الشاعر: عَسى الْكَرْبُ، الْذي أَمسَيْتُ فيهِ، يَكُونُ وَراءَهُ فرجٌ قَريبُ وقول الآخر: ُيوشكُ مَنْ فَرَّ مِنْ مَنيَّتِهِ في بَعْضِ غِرَّاتهِ يُوافقُها والأكثرُ في (كادَ وكَرَبَ) أن يتجردَ خبرُهما منها، قال تعالى: {فذبحوها وما كادوا يفعلون}، وقال الشاعر: كَرَبَ الْقَلْبُ مِنْ جَواهُ يَذوبُ حينَ قالَ الْوُشاةُ: هِنْدٌ غَضُوبُ واقترانُهُ بها قليلٌ، ومنه الحديثُ: (كادَ الفقرُ أن يكون كفراً) وقولُ الشاعر: سَقاها ذَوُو الأَحلامِ سَجْلاً على الظَّما وقَدْ كَرَبت أعناقُها أَنْ تَقَطَّعا [السَجْل: الدلو العظيمة التي فيها ماء، قَلّ أو كَثُر، وهو مذكر. فإن كانت الدلو فارغة فلا يُقال لها سَجْل] 4ـ حكمُ الخَبَرِ المُقْتَرِن بأَنْ والمُجَرَّدِ منْها إن كان الخبرُ مُقترِناً بأن، مثلُ: (أوشكتِ السماءُ أن تُمطِرَ. وعسى الصديقُ أن يحضُرَ)، فليس المضارعُ نفسهُ هو الخبرَ، وإنما الخبرُ مصدرُهُ المؤَوْلُ بأن، ويكونُ التقديرُ: (أوشكت السماءُ ذا مطرٍ. وعسى الصديقُ ذا حضور) غير انه لا يجوزُ التصريح بهذا الخبر المؤَوَّل، لأنَّ خبرَها لا يكونُ في اللفظ اسماً. وإن كان غيرَ مُقترنٍ بها، نحو: (أوشكتِ السماءُ تمطِر)، فيكونُ الخبرُ نفسَ الجملة، وتكونُ منصوبةً محلاً على أنها خبرٌ. 5ـ المُتَصَرِّفُ من هذهِ الأَفعالِ وغيرُ المُتَصَرِّف منها هذه الأفعالُ كلُّها مُلازمة صيغة الماضي، إلا (أَوشكَ وكادَ)، من أفعال المقاربة، فقد وردَ منهما المضارع. والمضارع من (كادَ) كثيرٌ شائعٌ، ومن (أوشكَ) أكثرُ من الماضي، ومن ذلك قولهُ تعالى: {يكادُ زَيتُها يُضيءُ ولو لم تمسَسْه نارٌ}، والحديثُ: (يُوشِكُ أن يَنزِلَ فيكم عيسى بنُ مريمَ حَكَماً عدلاً). 6ـ خَصائِصُ عَسَى واخلَوْلَقَ وأَوْشَكَ تختصُّ (عسى واخلولقَ وأوشك)، من بين أفعال هذا الباب، بأنهن قد يَكُنَّ تاماتٍ، فلا يَحتجنَ الى الخبر، وذلك إذا وَلِيَهنَّ (أن) والفعلُ، فيُسنَدْنَ الى مصدره المؤَوْل بأنْ، على أنه فاعلٌ لهنَّ، نحو: (عسى أن تقومَ. واخلولقَ أن تُسافروا. وأوشكَ أن نَرحلَ)، ومنه قوله تعالى: {عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم. وعسى أن تُحبُّوا شيئاً، وهو شرٌّ لكم} وقولهُ: {عسى أن يَهديَني ربي}، وقولهُ: {عسى أن يَبعثَكَ ربُّك مقاماً محموداً}. هذا إذا لم يتقدّم عليهنَّ اسمٌ هو المُسنَدُ إِليه في المعنى (كما رأيت)، فان تقدّم عليهنَّ اسمٌ يَصحُّ إسنادُهنَّ الى ضميرهِ، فأنت بالخيار، إن شئتَ جعلتهنَّ تامّاتٍ (وهو الأفصح)، فيكونُ المصدرُ المؤوَّلُ فاعلاً لهنَّ، نحو: (علي عسى أن يذهب، وهندٌ عسى أن تذهب. والرجلانِ عسى أن يذهبا. والمرأتان عسى أن تذهبا. والمسافرون عسى أن يحضُروا. والمسافرات عسى أن يحضُرْن) بتجريد (عسى) من الضمير. وإن شئت جعلتهنَّ ناقصاتٍ، فيكونُ اسمُهنَّ ضميراً. وحينئذ يَتحملنَ ضميراً مستتراً، أو ضميراً بارزاً مطابقاً لِما قبلَهنَّ، إفراداً أو تثنية أو جمعاً، وتذكيراً أو تأنيثاً، فتقول فيما تقدَّمَ من الأمثلة: (عليٌّ عسى أن يذهبَ. وهندٌ عسَتْ أن تذهبَ. والرجلان عَسَيا أن يذهبا، والمرأتانِ عَسَتا أن تذهبا. والمسافرونَ عَسَوْا أن يحضُروا. والمسافراتُ عسَيْنَ أن يَحضُرونَ). والأولى أن يُجعلنَ في مثل ذلك تامّاتٍ، وأن يُجرَّدْنَ من الضمير، فيَبقَيْنَ بصيغة المفرد المذكر، وأن يُسنَدْنَ الى المصدر المؤوَّل من الفعل بأن على أنهُ فاعلٌ لهنَّ، وهذه لغة الحجاز، التي نزل بها القرآنُ الكريمُ، وهي الأفصحُ والأشهر، وقال تعالى: {لا يَسْخَرْ قومٌ من قومٍ عسى أن يكونوا خيراً منهم، ولا نساءٌ من نساءٍ، عسى أن يَكُنّ خيراً منهنَّ} ولو كانت ناقصةً لقال: (عَسَوْا وعَسَيْن)، بضمير جماعة الذكور العائد الى (قوم) وضميرِ جَماعةِ الإناث العائد الى (نساء). واللغةُ الأخرى لغةُ تميم. وتختصُّ (عسى) وحدَها بأمرين: أ ـ جوازُ كسر سينها وفتحها، إذا أُسندت الى تاءِ الضميرِ، أو نون النسوةِ، أو (نا)، والفتحُ أولى لأنه الأصل. وقد قرأ عاصمٌ: {فهلْ عَسيتُمْ إن تَولَّيتم}، بكسر السين، وقرأ الباقونَ: (عَسَيتم)، بفتحها. ب ـ أنها قد تكونُ حرفاً، بمعنى (لعلَّ)، فتَعملُ عملها، فتنصبُ الاسمَ وترفعُ الخبرَ، وذلك إذا اتصلت بضمير النصب (وهو قليل)، كقول الشاعر: فَقُلْتُ: عساها نارُ كأْسٍ، وعَلَّها تَشَكَّى، فآتي نَحْوَها فَأَعُودُها فَتَسْمَعُ قَوْلي قَبْلَ حَتفٍ يُصِيبُني تُسَرُّ بهِ، أو قَبْلَ حَتْفٍ يَصيدُها [كأس في صدر البيت الأول: اسم امرأة] |
أحرف ليس
أَو الأَحرُفُ المُشَبْهَة بِلَيْسَ في العَمَل أحرفُ (ليسَ) هي: أحرُفُ نفيٍ تعمل عملَها، وتُؤَدّي معناها وهي أربعةٌ (ما ولا ولاتَ وإنْ). (ما) المشبهة بليس تعملُ (ما) عملَ (ليسَ) بأربعة شروطٍ: أ ـ أن لا يَتقدَّمَ خبرُها على اسمها، فان تقدَّمَ بَطل عملُها، كقولهم: (ما مسيءٌ من أعتَب). ب ـ أن لا يتقدَّمَ معمولُ خبرِها على اسمها، فان تقدَّمَ بطلَ عملُُها، نحو: (ما أمرَ اللهِ أنا عاصٍ)، إلا أن يكون معمولُ الخبر ظرفاً أو مجروراً بحرف جرّ، فيجوز، نحو: (ما عندي أنت مُقيما) و (ما بكَ أنا مُنتصراً). أما تقديمُ معمولِ الخبر على الخبر نفسهِ، دُونَ الاسمِ بحيث يتوَسَّطُ بينهما، فلا يُبطلَ عملها، وإن كان غيرَ ظرفٍ أو جار ومجرورٍ، نحو: (ما أنا أمرَكَ عاصياً). ج ـ أن لا تُزادَ بعدها (إِنْ). فان زيدَت بعدَها بطلَ عملُها، كقول الشاعر: بََني غُدانَةَ، ما إنْ أَنتُم ذَهَبٌ ولا صَريفٌ، ولكنْ أَنتمُ الخَزَفُ [الصريف: الفضة الخالصة. والخزف: الفخار.] د ـ أن لا ينتقضَ نفيُها بـ (إلاّ). فإن انتقض بها بطلَ عملُها، كقوله تعالى: {وما أمرُنا إلاّ واحدةٌ}، وقوله: {وما محمدٌ إلاّ رسولٌ}، وذلك لأنها لا تعملُ في مُثبتٍ. فان فُقدَ شرطٌ من الشروط بطلَ عملُها، وكان ما بعدَها مبتدأً وخبراً، كما رأيت. ويجوز أن يكون اسمُها معرفةً كما تقدّمَ، وأن يكون نكرةً، نحو: (ما أحدٌ أفضلَ من المُخلصِ في عمله). وإذْ كانت (ما) لا تعملُ في مُوجَبٍ، ولا تعملُ إلا في منفي، وجبَ رفعُ ما بعدَ (بلْ ولكنْ)، في نحو قولك: (ما سعيد كسولاً، بل مجتهدٌ وما خليلٌ مسافراً، ولكن مقيمٌ)، على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ تقديرهُ: (هو)، أي: بل هو مجتهدٌ، ولكن هو مقيمٌ. وتكونُ (بلْ ولكنْ) حرفي ابتداء لا عاطفتينِ، إذْ لو عَطفَتا لاقتضى أن تعمل (ما) فيما بعدَ (بل ولكنْ)، وهو غيرُ منفيٍّ، بل هو مُثبتٌ، لأنهما تقتضيانِ الإيجاب بعد النفي. فاذا كان العاطفُ غيرَ مُقتضٍ، للإيجاب كالواو ونحوها، جاز نصبُ ما بعدَهُ بالعطف على الخبر (وهو الأجود) نحو: (ما سعيدٌ كسولاً ولا مُهملاً) وجازَ رفعُهُ على انهُ خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ، نحو: (ما سعيدٌ كسولاً ولا مُهملٌ)، أي: ولا هوَ مُهمل. وهكذا الشأن في (ليسَ)، فيجبُ رفعُ ما بعدَ (بلْ ولكنْ) في نحو: (ليس خالدٌ شاعراً، بل كاتبٌ). ويجوز النصبُ والرفعُ بعدَ الواوِ ونحوها مثلُ (ليسَ خالدٌ شاعراً ولا كاتباً) أو (ولا كاتبٌ). والنصبُ أولى. واعلم أنَّ (ما) هذه لا تعملُ عملَ (ليس) إلا في لغة أهل الحجاز (الذين جاء القرآنُ الكريمُ بلغتهم)، وبلغةِ أهلِ تِهامةَ ونجدٍ. ولذلك تُسمى (ما النافية الحجازية). وهي نافيةٌ مُهملةٌ في لغة تميمٍ على كل حال، فما بعدَها مبتدأ وخبر. (لا) المشبهة بليس (لا)، المشبهةُ بليس، مُهملة عندَ جميع العرب وقد يُعمِلُها الحجازيُّون إعمالَ (ليسَ)، بالشروط التي تقدّمت لِما، ويُزاد على ذلك أن يكونَ اسمُها وخبرُها نكرتينِ. وندَرَ أن يكون اسمُها معرفةً، كقول الشاعر: وَحَلَّتْ سَوادَ الْقَلْبِ، لا أَنا باغياً سِواها، ولا في حُبِّها مُتراخِيا وقد جاء مثل ذلك للمتنبي في قوله: إذا الجُودْ لم يُرْزَقْ خَلاصاً منَ الأذى فلا الحَمْدُ مَكسُوباً، ولا المالُ باقِيا وقد أجازَ ذلك بعضُ علماء العربية الفُضلاءُ. والغالبُ على خبرِ (لا) هذه أن يكون محذوفاً كقوله: مَنْ صَدَّ عَنْ نِيرانِها فأنا ابنُ قَيْسٍ، لا بَراحُ أي: لا بَراحٌ لي. ويجوزُ ذكرهُ، كقول الآخر: تَعَزَّ، فلا شَيءٌ على الأرْضِ باقيا ولا وَزَرٌ مِمَّا قَضى اللهُ واقِيا واعلم أنَّ (لا) المذكورةَ، يجوزُ أن يُرادَ بها نفيُ الواحدِ، وأن يرادَ بها نفيُ الجميع. فهي محتملةٌ لنفي الوَحدة ولنفي الجنس، والقرينةُ تُعَيّنُ أحدَهما: (فان قلت: (لا رجلٌ حاضرٌ). صح أن يكون المراد: ليس احدٌ من جنس الرجال حاضراً، وأن يكون المراد: (ليس رجل واحد حاضراً). فيحتمل أن يكون هناك رجلان أو أكثر. ولذلك صح أن تقول: (لا رجل حاضراً، بل رجلان)، أو رجال. أما (لا) العاملة عمل (أنَّ)، فلا معنى لها إلا نفي الجنس نفياً عاماً، فان قلت: (لا رجل حاضر) كان المعنى: (ليس أحد من جنس الرجال حاضراً)، لذا لا يجوز أن تقول بعد ذلك (بل رجلان، أو رجال)، لأنها لنفي الجميع. واعلم أن الأولى في (لا) هذه أن تُهمَلَ ويُجعلَ ما بعدَها مبتدأً وخبراً. وإذا أُهملت، فالأحسنُ حينئذٍ أن تُكرَّرَ، كقوله تعالى: {لا خوفٌ عليهم، ولا هُم يَحزنونَ}. (لات) المشبهة بليس تَعملُ (لاتَ) عَملَ (ليسَ) بشرطين: أ ـ أن يكون اسمُها وخبرها من أسماءِ الزمانِ، كالحينِ والساعةِ والأوانِ ونحوها. ب ـ أن يكون أحدُهما محذوفاً. والغالبُ أن يكونَ المحذوفُ هو اسمَها، كقوله تعالى: {ولاتَ حينَ مَناصٍ}، ومنه قول الشاعر: ندِمَ الْبُغاةُ، ولاتَ ساعةَ مَنْدَم والْبَغْيُ مَرْتَعُ مُبْتَغِيهِ وخِيمُ ويجوزُ أن ترفع المذكورَ على أنه اسمُها، فيكون المحذوفُ منصوباً على أنهُ خبرُها، غيرَ أنَّ هذا الوجهَ قليلٌ جداً في كلامهم. واعلم أن (لات) إن دخلت على غير اسم زمانٍ كانت مهملةً، لا عملَ لها، كقوله: لَهْفي عَلَيْكَ لِلَهْفَةٍ من خائفٍ يَبغِي جِواركَ حينَ لاتَ مُجيرُ واعلم أن من العرب من يجرُّ بلاتَ، والجرُّ بها شاذ، قال الشاعر: طَلبوا صُلْحنا ولاتَ أَوانٍ فأجبْنا: أَنْ ليْسَ حين بقاء وعليه قولُ المتنبي: لَقَدْ تَصبَّرْتُ، حَتَّى لاتَ مُصْطَبَرٍ والآنَ أَقْحَمُ، حتَّى لاتَ مُقْتَحَمِ (إِنْ) المشبهة بليس قد تكونُ (إنْ) نافيةً بمعنى (ما) النافية، وهي مُهمَلةٌ غير عاملةٍ. وقد تعملُ عملَ (ليس) قليلاً، وذلك في لغة أهل العالية من العرَبِ،[ العالية: اسم لكل ما كان لجهة نجد،من القرى والعمائر الى تهامة] ومنه قولهم: (إنْ أحد خيراً من أحدٍ إلاّ بالعافية) وقولُ الشاعر: إنْ هوَ مُسْتَوْلياً على أَحَدٍ إلاّ على أَضعَفِ الْمجانِين وقولُ الآخر: إنِ الْمَرْءُ مَيْتاً بانْقِضاءِ حياتهِ ولكنْ بأَنْ يُبْغَى عَلَيْهِ فَيُخذَلا وإنما تعملُ عملَ (ليس) بشرطين: أ ـ أن لا يَتقدَّمَ خبرُها على اسمها. فان تقدَّمَ بَطلَ عملُها. ب ـ أن لا ينتقضَ نفيها بِـ (إِلا). فان انتقضَ بطلَ عملُها، نحو: (إنْ أنت إلاّ رجلٌ كريمٌ)، وانتقاضُ النفيِ المُوجبُ إبطالَ العملِ، إنما هو بالنسبة الى الخبر، كما رأيتَ، ولا يَضُرُّ انتقاضُهُ بالنسبة الى معمول الخبر، نحو: (إن أنت آخذاً إلاّ بيد البائسينَ)، ونحو البيت: (إنْ هو مستولياً على أحدٍ الخ). واعلم أن الغالبَ في (إنْ) النافيةِ أن يقترنَ الخبرُ بعدها بِـ (إلاّ) كقوله تعالى: {إنْ هذا إلاّ مَلَكٌ كريمٌ}. وقد يستعملُ الكلامُ معها بدون (إلاّ)، كالبيت: (إنِ المرءُ ميتاً بانقضاءِ حياته الخ). ومنهُ قولهم: (إن هذا نافعَكَ ولا ضارّكَ). فائدة سمعَ الكسائي أعرابيّاً يقولُ: (إنّا قائماً)، فأنكرها عليه، وظنَّ أنها (إنَّ) المشدَّدةُ الناصبةُ للاسم الرافعةُ للخبر. فحقُّها أن ترفعَ (قائماً)، فاستثبته. فإذا هو يُريدُ (إنْ أنا قائماً) أي: ما أنا قائماً، فتركَالهمزةَ - همزة أنا - تخفيفاً وأدغم، على حد قوله تعالى: {لكنّا هو اللهُ ربي}، أي: (لكن أنا). |
الأحرف المشبهة بالفعل
الأحرفُ المشبَّهةُ بالفعل ستَّة، هي: (إنَّ وأنَّ وكأنَّ ولكنَّ وليتَ ولعلَّ). وحكمُها أنها تدخلُ على المبتدأ والخبرِ فتنصبُ الأولَ، ويُسمّى اسمَها، وترفعُ الآخرَ، ويُسمّى خبرَها، نحو: (إن اللهَ رحيمٌ. وكأنّ العلمَ نورٌ). (وسميت مشبهة بالفعل لفتح أواخرها، كالماضي، ووجود معنى الفعل في كل واحدة منها. فان التأكيد والتشبيه والاستدراك والتمني والترجي، هي من معاني الأفعال). ويجوزُ في (لعلَّ) أن يقالَ فيها (علَّ) كقوله: فَقُلْتُ عساها نارُ كأْسٍ وعَلّها تَشَكّى، فآتي نَحْوَها فأعُودُها وفيها لُغاتٌ أُخَرُ قليلةُ الاستعمال. وفي هذا الفصل ثمانيةَ عشرَ مبحثاً. 1ـ مَعاني الأَحرُفِ المُشَبَّهَةِ بالفعْلِ معنى: (إنَّ وأنَّ) التوكيدُ، فهما لتوكيدِ اتصافِ المُسنَدِ إليه بالمُسند. ومعنى: (كأنَّ) التشبيهُ المؤكدُ. لأنها في الأصل مُركبةٌ من (أنَّ) التوكيدية وكافِ التشبيه، فإذا قلتَ: (كأنّ العلمَ نورٌ) فالأصل: (إنَّ العلمَ كالنور) ثم إنهم لما أرادوا الاهتمامَ بالتشبيه، الذي عَقَدوا عليه الجملة، قدّموا الكافَ، وفتحوا همزةَ (إنّ)، مكان الكاف، التي هي حرفُ جرّ، وقد صارت وإيّاها حرفاً واحداً يُرادُ به التشبيهُ المؤكد. ومعنى: (لكنَّ) الاستدراكُ، والتوكيد، فالاستدراكُ نحو: (زيدٌ شجاعٌ، ولكنه بخيل)، وذلك لانَّ من لوازم الشجاعةِ الجودَ، فإذا وصفنا زيداً بالشجاعة، فرُبما يُفهمُ أنهُ جوادٌ أيضاً، لذلك استدركنا بقولنا: (لكنه بخيل). والتوكيدُ نحو: (لو جاءني خليلٌ لأكرمتُهُ، لكنه لم يجيء)، فقولك: (لو جاءني خليلٌ لأكرمتُه) يفهم منه أنه لم يجيء، وقولك: (لكنه لم يجيء) تأكيدٌ لنفي مجيئه. ومعنى (ليتَ) التمني، وهو طلبُ مالا مطمع فيه، أو ما فيه عُسرٌ، فالأول كقول الشاعر: أَلا لَيْتَ الشَّبابَ يَعُودُ يَوماً فأُخبرَهُ بما فَعَل المَشِيبُ والثاني كقول المعسر: (ليتَ لي ألفَ دينارٍ). وقد تُستعمل في الأمر الممكن، وذلك قليلٌ، نحو: (ليتك تذهب). ومعنى (لعلَّ) الترجّي والإشفاق. فالترجي طلبُ الأمر المحبوب، نحو: (لعلَّ الصديقَ قادمٌ). والإشفاق هو الحذَرُ من وقوع المكروه، نحو: (لعلّ المريضَ هالكٌ). وهي لا تُستعملُ إلاّ في الممكن. وقد تأتي بمعنى (كي)، التي للتعليل، كقولك: (ابعث إليّ بدابتك، لعلي أركبها)، أي: كي أركبها. وجعلوا منه قوله تعالى: {لعلكم تتَّقون. لعلّكم تعقلون. لعلّكم تَذكّرون}، أي: (كي تَتقوا، وكي تَعقلوا، وكي تَتذكّروا). وقد تأتي أيضا بمعنى الظنَّ، كقولك (لعلي أزورُك اليوم). والمعنى: أظنَّني أزورك. وجعلوا منه قولَ امريء القيس: وبُدِّلْتُ قَرْحاً دامِياً بَعْدَ صِحَّةٍ لَعَلَّ مَنايانا تَحُولَنَّ أَبْؤُسا وبمعنى: (عسى)، كقولك: (لعلَّكَ أن تجتهدَ). وجعلوا منه قولَ مُتَمّمٍ: لَعَلَّكَ يَوْماً أَنْ تُلِمَّ مُلِمَّةٌ عَلَيْكَ، منَ اللاَّتي يَدَعْنَكَ أَجدَعا بدليل دخول (أنْ) في خبرها، كما تدخل في خبر (عسى). 2ـ الْخَبرُ المُفْرَدُ، والْجُمْلَةُ، والشبيهُ بالجملة يقع خبر الأحرف المشبّهة بالفعل مفرداً (أي غيرَ جملةٍ ولا شبْهَها) نحو: (كأنَّ النّجمَ دينارٌ)، وجملةً فعليّةً، نحو: (لعلك اجتهدتَ. وإنَّ العلمَ يُعَزَّزُ صاحبهُ)، وجملة اسمية، نحو: (إنَّ العالمَ قدرُهُ مرتفعٌ) وشِبْهَ جُملةٍ (وهو أن يكون الخبر مُقدَّراً مدلولاً عليه بظرفٍ أو جارّ ومجرورٍ يتعلقانِ بهِ)، نحو: (إنّ العادلَ تحتَ لِواءِ الرَّحمن، وإن الظالمَ في زُمرة الشيطان). (والخبر هنا يصح أن تقدره مفرداً: ككائن وموجود، وأن تقدره جملة ككان ووجد، أو يكون ويوجد. فهو مفرد. باعتبار تقديره مفرداً، وجملة، باعتبار تقديره جملة، فالحقيقة فيه أنه شبيه بالمفرد وبالجملة، وتسميته بشبه الجملة فيها اكتفاء واقتصار). 3ـ حَذْفُ خَبَرِ هذهِ الأَحرُف يجوز حذف خبرِ هذه الاحرفِ. وذلك على ضربينِ: جائز وواجب: فيُحذَفُ جوازاً، اذا كان كوناً خاصاً (أي: من الكلماتِ التي يُرادُ بها معنًى خاصّ)، بشرطِ أن يدُلَّ عليه دليلٌ، كقوله تعالى: {إنَّ الذينَ كفروا بالذّكر لمّا جاءهم. وإنهُ لكتابٌ عزيزٌ}. (أي: إن الذين كذبوا بالذكر معاندون، أو هالكون، أو معذبون). وقال الشاعر: أَتَوْنِي، فَقالوا: يا جَميلُ، تَبَدَّلتْ بُثَيْنَةُ أَبْدالاً، فَقُلْتُ: لَعَلَّها (أي: لعلها تبدَّلت، أو لعلها فعلت ذلك). ويحذفُ وجوباً، إذا كان كوناً عاماً (أي: من الكلمات التي تدُلُّ على وجودٍ أو كونٍ مُطلقَينِ، فلا يُفهَمُ منها حَدَثٌ خاصٌّ أو فعلٌ معيَّنٌ، ككائنٍ، أو موجود، أو حاصلٍ) وذلك في موضعينِ: أ ـ الأول بعدَ (ليتَ شِعري)، إذا وَلِيَها استفهامٌ، نحو: (ليتَ شِعري هل تنهضُ الأمةُ؟ وليتَ شِعري متى تنهضُ؟)، قال الشاعر: ألاَ لَيْتَ شِعْري كَيْفَ جادَتْ بِوَصْلِها؟ وكيفَ تُراعي وُصْلةَ المُتَغَيِّبِ (أي: ليت شعري (أي: علمي) حاصل. والمعنى: ليتني أشعر بذلك، أي: أعلمه وأدريه. وجملة الاستفهام في موضع نصب على أنها مفعول به لشعري، لأنه مصدر شعر). ب ـ أن يكونَ في الكلام ظرفٌ أو جار ومجرورٌ يتعلقانِ به، فيُستغنى بهما عنهُ، نحو: (إنَّ العلمَ في الصدور. وإنَّ الخيرَ أمامك). (فالظرف والجار متعلقان بالخبر المحذوف المقدر بكائن أو موجود أو حاصل). |
4ـ تَقَدُّمُ خبَرِ هذِه الأَحرُف
لا يجوزُ تقدُّمُ خبرِ هذه الأحرف عليها، ولا على اسمها. أما معمولُ الخبرِ، فيجوزُ أن يتقدَّم على الاسم، إن كان ظرفاً أو مجروراً بحرف جرٍّ، نحو: (إنَّ عندَك زيداً مُقيمٌ)، قال الشاعر: فَلا تَلْحَني فيها، فإنَّ بِحُبِّها أَخاكَ مُصابُ الْقَلْبِ جُمٌّ بَلابِلُهْ (لا تلحني: لا تلمني، وهو بفتح الحاء، من لحاه يلحاه إذا لامه، ولحا العود: يعني أزال اللحاء عنه وقشره. البلابل: الهموم والوساوس) ومن ذلك أن يكون الخبرُ محذوفاً مدلولاً عليه بما يتعلقُ به من ظرفٍ أو جارٍّ ومجرورٍ مُتقدمين على الاسم، نحو: (إنَّ في الدَّار زيداً)، ومنهُ قولهُ تعالى: {إنَّ فيها قوماً جبّارينَ}، وقولهُ: {إنَّ مع العُسرِ يُسراً}. (فالظرف والجار متعلقان بالخبر المحذوف غير أنه يجب أن يقدر متأخراً عن الاسم، إذ لا يجوز تقديمه عليه، كما علمت، وليس الظرف أو الجار والمجرور هو الخبر، كما يتساهل بذلك كثير من النحاة، وإنما هما معمولان للخبر المحذوف، لأنهما متعلقان به). ويجبُ تقديمُ معمولِ الخبر، إن كان ظرفاً أو مجروراً، في موضعين: أ ـ أن يَلزمَ من تأخيره عودُ الضمير على متأخرٍ لفظاً ورتبةً وذلك ممنوعٌ نحو: (إنَّ في الدَّارصاحبَها). (فلا يجوز أن يقال (إن صاحبها في الدار)، لأن (ها) عائدة على الدار. وهي متأخرة لفظاً، وكذلك هي متأخرة رتبة، لأن معمول الخبر رتبته التأخير كالخبرِ). ب ـ أن يكون الاسمُ مُقترِناً بلامِ التأكيد، كقوله تعالى: {وإنَّ لنا للآخرة والأولى}، وقولهِ: {إنَّ في ذلك لَعِبْرةً لأولي الأبصارِ}. أما تقديمُ معمولِ الخبرِ على الخبر نفسهِ، بحيثُ يَتوَّسطُ بينَ الاسمِ والخبر، فجائزٌ، سواءٌ أكانَ معمولهُ ظرفاً أو مجروراً أم غيرَهما، فالأول نحو: (إنكَ عندَنا مقيمٌ)، والثاني نحو: (إنكَ في المدرسة تتعلّمُ)، والثالث نحو: (إنَّ سعيداً دَرْسَهُ يكتبُ). فائدة متى جاء بعد (إن) أو إحدى أخواتها ظرف أو جار ومجرور، كان اسمها مؤخراً. فليتنبه الطالب الى نصبه، فان كثيراً من الكتاب والمتكلمين يخطئون فيرفعونه، لتوهمهم أنه خبرها نحو: (إن عندك لخبراً)، ونحو: (لعل في سفرك خيراً). 5ـ لامُ التأْكيدِ بعدَ "إنَّ" المَكسورةِ الهمزة تختصُّ (إنَّ)، المكسورةُ الهمزةِ، دونَ سائرِ أخواتها، بجوازِ دخولِ لامِ التأكيد،ِ، وهي التي يُسمونها (لامَ الابتداءِ) على اسمها، نحو: (إنَّ في السماءِ لخَبَراً، وإنَّ في الأرض لَعِبَراً)، وعلى خبرها نحو: (إنَّ الحقَّ لمنصورٌ)، وعلى معمول خبرها، نحو: (إنه للخيرَ يفعلُ)، وعلى ضمير الفصلِ نحو: (إنَّ المجتهدَ لَهُوَ الفائزُ). 6ـ شَروطُ ما تَصحَبُهُ لامُ التأكيد أ ـ يُشترطُ في دخول لام التأكيد على اسم "إنَّ" أن تقع بعدَ ظرفٍ أو جارٍّ ومجرورٍ يتعلقان بخبرها المحذوف، نحو: (إن عندَك لخَيراً عظيماً، وإنَّ لك لخُلُقاً كريماً). (فان وقع قبلهما لم يجز اقترانه باللام فلا يقال: (إن لخيراً عندك، وإن لخلقاً كريماً لك). ب ـ يُشترط في دخولها على الخبر أن لا يقترنَ بأداةِ شرطٍ أو نفي، وأن لا يكون ماضياً مًتصرفاً مُجرَّداً من (قد). فان كان الخبرُ واحداً منها لم يَجُز دخولُ هذه اللام عليه. فمثالُ المستكملِ للشرط: {إن ربي لسميع الدُّعاء}. {وإنَّ رَبَّكَ لَيعلمُ}. {وإنَّا نحنُ نُحيي الموتى}. ومتى استَوفى خبرُ (إنَّ) شروط اقترانه بِلام التأكيد، جاز دخولها عليه، لا فرقَ أن يكون مفرداً، مقترنٌ بقد، نحو: (إن الحق لمنصور)، أو جملة اسمية، نحو (إنَّ الحقَّ لصَوتُهُ مرتفعٌ، أو جملةً مضارعيّةً، نحو: (إنَّ ربّكَ ليَحكُمُ بينهم)، أو جملةً ماضيَةً فعلها جامدٌ، نحو: (إنك لَنِعْمَ الرجل)، أو متصرف مقترن بقد، نحو: (إن الفرجَ قد دنا). وإذا حُذفَ الخبرُ، جازَ دخولُ هذهِ اللامِ على الظرف أو الجار المتعلّقينِ به، نحو: (إن أخاكَ لعندي، وإنَّ أباكَ لَفي الدّار)، ومنهُ قولهُ تعالى: {وانك لَعَلى خُلُقٍ عظيم}. ج ـ يُشترطُ في دخولها على مفعول الخبر شرطان، الأول: أن يتوسَّطَ بين اسمها وخبرها. والثاني أن يكونَ الخبرُ ممّا يَصلُحُ لدخول هذه اللامِ عليه، نحو: (إنَّ سليماً لفي حاجتك ساعٍ، وإنه لَيومَ الجمعةِ آتٍ، وإنهُ لأمرَكَ يُطيعُ). د ـ أما ضميرُ الفصلِ، فلا يُشترطُ في دخولها عليه شيءٌ، كقوله تعالى: {إنَّ هذا لَهُوَ القَصَصُ الحقُّ}. (وضمير الفصل: هو ما يؤتى به بين المبتدأ والخبر، أو بين ما أصله مبتدأ وخبر: للدلالة على أنه خبر لا صفة. وهو يفيد تأكيد اتصاف المسند إليه بالمسند. وهو حرف لا محل له من الإعراب، على الأصح من أقوال النحاة، وصورته كصورة الضمائر المنفصلة: وهو يتصرف تصرفها بحسب المسند إليه، إلا أنه ليس إياها. ثم إن دخوله بين المبتدأ والخبر المنسوخين بكان وظن وأن واخواتهن تابع لدخوله بينهما قبل النسخ، نحو: (إن زهيراً هو الشاعر). وكان علي هو الخطيب وظننت عبد الله هو الكاتب). (وضمير الفصل حرف كما قدمنا: وإنما سمي ضميراً لمشابهته الضمير في صورته. وسمي ضمير فصل لأنه يؤتى به الفصل بين ما هو خبر أو صفة، لأنك إن قلت: (زهير المجتهد)، جاز أنك تريد الإخبار وأنك تريد النعت. فان أردت أن تفصل بين الأمرين. وتبين أن مرادك الإخبار لا الصفة. أتيت بهذا الضمير للإعلان من أول الأمر بأن ما بعده خبر عما قبله لا نعت له، ثم انه يفيد تأكيد الحكم، لما فيه من زيادة الربط. ومن العلماء من يسمي ضمير الفصل (عماداً) لاعتماد المتكلم أو السامع عليه في التفريق بين الخبر والصفة). |
7ـ شرحُ لامِ الابتداء
تدخلُ لامُ الابتداء في ثلاثة مواضع. الاولُ: في باب المبتدأ. وذلك في صورتين: أ ـ أن تدخلَ على المبتدأ، والمبتدأ مُتقدّمٌ على الخبر، ودخولها عليه هو الأصل فيها نحو: {لأنتم أشد رَهبةً في صُدورهم}. فإن تأخرَ عن الخبر امتنعَ دخولها عليه، فلا يُقال: (قائمٌ لَزيدٌ). وما سُمعَ من ذلك فلضَرورةِ الشعر، وهو شاذٌّ لا يُقاس عليه. ب ـ أن تدخل على الخبر بشرط أن يتقدم على المبتدأ، نحو: (لمُجتهدٌ أنت) فان تأخرَ عنهُ امتنع دخولها عليه، فلا يقال: (أنت لمجتهدٌ). وما سُمعَ من ذلك فشادٌّ لا يُلتفتُ إليه. ومن العلماءِ من لا يُجيزُ دُخولها على خبر المبتدأ، سواءٌ أتقدَّمَ أم تأخر. الموضع الثاني: في باب (إن) المكسورةِ الهمزة. وقد سبقَ أنها تدخل على اسمها المتأخر، وعلى خبرها، اسماً كان، او فعلاً مضارعاً، او ماضياً جامداً أو ماضياً متصرفاً مقروناً بِقَدْ، أو جملة اسميَّة. وعلى الظرف والجارّ المُتعلقينِ بخبرها المحذوف دالين عليه، وعلى معمول خبرها. الموضعُ الثالثُ: في غير بابيِ المبتدأ وإنّ. وذلك في ثلاث مسائل: أ ـ الفعلُ المضارع، نحو: (لَتَنهض الأمة مُقتفيةً آثارَ جدودها). ب ـ الماضي الجامد، نحو: {لَبئسَ ما كانوا يعملون}. ج ـ الماضي المتصرف المقرون بِقَدْ، نحو: {لَقد كان لكم في يوسفَ وإخوتِهِ آياتٌ}. ومن العلماء من يجعلُ اللامَ الداخلةَ على الماضي، في هذا الباب، لامَ القسم فالقسم عنده محذوف، ومصحوب اللام جوابُه. واعلم أنَّ للام الابتداء فائدتين. الفائدة الأولى: توكيدُ مضمونِ الجملة المُثبتة. ولذا تُسمّى: (لام التوكيد) وإنما يُسمونها لامَ الابتداء لأنها في الأصل، تدخل على المبتدأ، أو لأنها تقع في ابتداء الكلام. وإذْ كانت للتوكيد فإنها متى دخلت عليها (إنَّ) زحلقوها الى الخبر، نحو: {إنَّ ربي لَسميع الدعاء}، وذلك كراهية اجتماع مُؤكدينِ في صدر الجملة، وهما: (إنَّ واللام). ولذلك تُسمّى (اللامَ المزحلقَةً أيضاً). وإِذْ كانت هذه اللام للتوكيد في الإثبات، امتنعت من الدخول على المنفيِّ لفظاً أو معنى، فالأول نحو: (انكَ لا تكذبُ)، والثاني نحو: (إنك لو اجتهدتَ لأكرمتُكَ. وإنك لولا إهمالك لَفُزتَ). فالاجتهادُ والإكرامُ مُنتفيانِ بعدَ (لو)، والفوزُ وحدَهُ مُنتفٍ بعدَ (لولا). الفائدةُ الثانيةُ: تَخليصها الخبرَ للحال، لذلك كان المضارع بعدها خالصاً للزمان الحاضر، بعد أن كان مُحتملاً للحال والاستقبال. وإذ كانت لتوكيد الخبرِ في الحال امتنعت من الماضي والمضارع المُستقبل، إلا أن يكون الماضي جامداً أو مُتصرِّفاً مقترناً بِقدْ. إما الجامدُ فلأنه لا يَدلُّ على حدثٍ ولا زمان. وأما المقترنُ بِقدْ فلأنّ (قد) تُقرِّبُ الماضيَ من الحال. ولا فرقَ بينَ أن يكون المضارعُ المستقبلُ مسبوقاً بأداةٍ تَمحَضُه الاستقبالِ كالسين وسوفَ وأدواتِ الشرطِ الجازمة وغيرها، أو غيرَ مسبوقٍ بها، وإنما القرينةُ تدلُّ على استقباله، نحو: (إنه يجيءُ غداً). وأما قوله تعالى: {إنَّ ربكَ لَيحكُمُ بينَهم يوم القيامة}، فإنما جازَ دخولُ اللام لأنَّ المستقبل هنا مُنزَّلٌ مَنزلةَ الحاضرِ لتحقُّق وقوعهِ، لأنَّ الحكمَ بينهم واقعٌ لا محالةَ. فكأنهُ حاضر، وكذا قولهُ تعالى: {ولَسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى}، فانَّ الإعطاءَ مُحقَّقٌ، فكأنه واقعٌ حالاً. وأما قوله عز وجلَّ على لسان يعقوبَ: {انهُ ليحزُنُني أن تذهبوا به}، فإنّ الذهابَ، وان كان مُستقبلاً فان أثرَهُ، وهو الحزنُ، حاضرٌ، فانهُ حَزِنَ لمُجرَّدِ علمهِ أنهم ذاهبُون به، فلم يخرُج المضارعُ هنا، وهو (يُحزُنني)، عن كونهِ للحال. ويرى بعض العلماء (وهمُ الكوفيُّون) أنها لا تمحَضُ المضارع الحالَ، بل يجوز ان تدخل عَليه مُستقبل، بالأداة او بِدونها، وجعلوا الاستقبالَ في الآياتِ على حقيقته. 8ـ (ما) الكافَّةُ بعدَ هذهِ الأحرُف إذا لحقت (ما) الزائدةُ الأحرف المُشبّهةَ بالفعل، كفتّها عن العمل، فيرجعُ ما بعدها مبتدأً وخبراً. وتُسمّى (ما) هذه (ما الكافةَ) لأنها تَكُفُّ ما تلحقُهُ عن العمل، كقوله تعالى: {إنما إِلهكُم إِلهٌ واحدٌ"}، ونحو: {كأنما العلمُ نورٌ} و (لَعلَّما اللهُ يرحمُنا). غير أنَّ (ليتَ) يجوزُ فيها الإِعمالُ والإِهمالُ، بعدَ أن تَلحقَها (ما) هذه، تقولُ: (ليتما الشبابَ يعودُ) و (ليتما الشبابُ يعودُ). وإعمالها حينئذ أحسنُ من إهمالها. وقد رُوِيَ بالوجهينِ، نصبِ ما بعدَ (ليتما) ورفعه، قولُ الشاعرِ: قالتْ: أَلاَ لَيتَما هذا الحمامَ لنا إلى حَمامَتِنا، أو نِصْفَهُ فَقَدِ (فالنصب على أن (ليتما) عاملة، و (ذا) اسمها، و (الحمام) بدل منه. والرفع على أنها مهملة مكفوفة بما، و (ذا) مبتدأ، و (الحمام) بدل منه. وكذا (نصفه) إن نصبت الحمام نصبته، وإن رفعته رفعته، لأنه معطوف عليه). ومتى لحقت ( ما الكافَّة) هذهِ الأحرف زالَ اختصاصُها بالأسماء. فَلِذا أُهملت، وجازَ دخولُها على الجملة الفعليّة، كما تدخلُ على الجملة الاسميَّة، إلاَّ (ليتَ). فمن دخولها على الجملةِ الفعلية قولهُ تعالى: {كأنما يُساقونَ الى الموت} وقول الشاعر: أَعِدْ نَظَراً يا عَبْدَ قَيْسٍ، لَعَلَّما أَضاءَتْ لكَ النَّارُ الحِمارَ المُقَيَّدا ومن دخولها على الجملة الاسميَّة قوله تعالى: {قل إنما أنا بشرٌ مثلُكُم يُوحى إلي إنما إلهكم إلهُ واحدٌ}، وقولهُ: {إنما اللهُ إِلهٌ واحدٌ}. وأما (ليتَ) فإنها باقيةٌ على اختصاصها بالأسماءِ، بعدَ أن تلحقها (ما الكافةُ) فلا تدخلُ على الجُمل الفعليَّة، لذلك يُرَجَّحُ أن تبقى على عملها: من نصب الاسمِ ورفعِ الخبر، كما تقدَّم. فائدة وتنبيه (إن كانت (ما) اللاحقة لهذه الأحرف اسماً موصولاً، أو حرفاً مصدرياً، فلا تكفها عن العمل، بل تبقى ناصبة للاسم: رافعة للخبر. فإن لحقتها (ما الموصولة) كانت (ما) اسمها منصوبة محلاً، كقوله تعالى: {إن ما عندكم ينفد}، أي: إن الذي عندكم ينفد. وإن لحقتها (ما المصدرية) كان ما بعدها في تأويل مصدر منصوب، على انه اسم (إن) نحو (إن ما تستقيم حسن)، أي: إن استقامتك حسنة. وحينئذ تكتب (ما) منفصلة. كما رأيت. بخلاف (ما الكافة)، فإنها تكتب متصلة كما عرفت فيما سلف. وقد اجتمعت (ما) المصدرية و (ما) الكافة في قول امرئ القيس: فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب، قليل من المال ولكنما أسعى لمجد مؤثلٌ وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي [قليل: فاعل (كفاني)، وجملة (لم أطلب) اعتراضية. والمعنى لو كنت أسعى لحياة ساذجة لكفاني قليل المال، ولم أطلب ما فوق ذلك من عزٍ ومجد، يعني مُلك أبيه الذي كان يسعى له] [المؤثل: المؤصَّل الثابت] فما في البيت الأول مصدرية. والتقدير: لو أن سعيي. وفي البيت الآخر زائدة كافة، أي: ولكني أسعى لمجد مؤثل). |
9ـ العَطْفُ على أسماء هذهِ الأَحرُف
إذا عطفتَ على أسماء الأحرف المشبَّهة بالفعل، عطفت بالنصب، سواءٌ أوقعَ المعطوفُ قبلَ الخبر أم بعدَهُ، فالأول نحو: (إنَّ سعيداً وخالداً مسافرانِ)، والثاني نحو: (إنَّ سعيداً مُسافرٌ وخالداً). وقد يُرفعُ ما بعدَ حرف العطف، بعدَ استكمالِ الخبر، على انهُ مبتدأٌ محذوفُ الخبر، وذلك بعد (إنَّ وأنَّ ولكنَّ) فقطْ، فمثالُ (إنَّ) (إنَّ سعيداً مسافرٌ وخالدٌ). [خالد: مبتدأ، وخبره محذوف. والتقدير وخالد مسافرٌ أيضاً] ومنهُ قولُ الشاعر: فَمَنْ يَكُ لم يُنْجِبْ أَبُوهُ وأُمُّهُ فَإنَّ لَنا الأُمَّ النَّجيةَ، والأَبُ [الأب: مبتدأ محذوف الخبر، والتقدير: (ولنا الأب النجيب أيضاً).] وقول الآخر: إنَّ الخِلافَة والمُروءَةَ فيهمُ والمَكْرُماتُ وسادةٌ أطهارُ ومثالُ (أنَّ) قوله تعالى: {وأذان من الله ورسولهِ الى الناس يومَ الحجِّ الأكبر أنَّ اللهَ بريءٌ من المشركينَ، ورسولهُ}. ومثالُ (لكنَّ) قولُ الشاعر: وما زِلتُ سَبَّاقاً إلى كُلِّ غايةٍ بها يُبْتَغَى في النَّاس مَجدٌ وإِجلالُ وما قَصَّرَتْ بِي في التَّسامي خُؤُولةٌ ولكنَّ عمِّي الطَّيِّبُ الأَصلِ والخالُ [أي: والحال الطيب الأصل أيضاً و(الخؤولة جمع خال)، كالعمومة جمع عم أو هي المصدر للخال. و(الطيب): خبر لكن، أي: لكن عمي هو الأصل، والخال كذلك] وقد يُرفعُ ما بعدَ العاطف قبل استكمالِ الخبر، لغرضٍ معنوي، على أنه مبتدأٌ محذوفُ الخبر فتكونُ جُملتُهُ مُعترِضةً بينَ اسمِ (إنّ) وخبرِها، كقول الشاعر: فَمَنْ يَكُ أَمسَى بالمدينَةِ رَحْلُهُ فإنِّي، وقَيَّارٌ، بِها لَغَريبُ (غريب: خبر عن اسم، (إن)، وقيار: مبتدأ محذوف الخبر، والتقدير: وقيار غريب بها أيضا. وقيار اسم فرسه أو جمله. وإنما قدمه واعترض بجملته بين اسم إن وخبرها لغرض أن هذا الفرس أو الجمل استوحش في هذا البلد، وهو حيوان، فما بالك بي، فلو نصب بالعطف على اسم (ان) فقال: (فإني وقياراً بها لغريبان)، لم يكن من ورائه شدة تصوير الاستيحاش الذي يعطيه الرفع في هذا المقام). ومنهُ قولهُ تعالى: {(إنَّ) الذينَ آمنوا والذينَ هادُوا، والصابئون، والنصارى، مَن آمنَ منهم باللهِ واليومِ الآخرِ وعملَ صالحاً، فلا خَوفٌ عليهم ولا هم يَحزنون}. فالصابئون: مبتدأ محذوف الخبر. والتقدير: والصابئون كذلك، أي: لهم حكم الذين آمنوا والنصارى واليهود. والجملة معترضة بين اسم (إن) وخبرها، وخبر (إن): هو جملة الجواب والشرط، والغرض من رفع (الصابئون) وجعله مبتدأ محذوف الخبر أنه لما كان الجواب والشرط، والغرض من رفع (الصابئون) وجعله مبتدأ محذوف الخبر أنه لما كان الصابئون، مع ظهور ضلالهم وميلهم عن الأديان كلها، يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان، واعتصموا بالعمل الصالح، فغيرهم ممن هو على دين سماوي وكتاب منزل، أولى بذلك). 10ـ إنَّ المكسورةُ، وأَنَّ المفتوحة يجبُ أن تُكسرَ همزةُ (إنَّ) حيث لا يصحُّ أن يقومَ مقامَها ومقام معمولَيها مصدرٌ. ويجبُ فتحُها حيثُ يجبُ أن يقوم مصدرٌ مقامَها ومقامَ معموليها. ويجوزُ الأمران: الفتحُ والكسرُ، حيثُ يَصحُّ الاعتبارانِ. (فإن وجب أن يؤول ما بعدها بمصدر مرفوع أو منصوب أو مجرور (بحيث تضطر الى تغيير تركيب الجملة)، فهمزتها مفتوحة وجوباً، نحو: (يعجبني أنك مجتهد)، والتأويل: (يعجبني اجتهادك) ونحو: (علمت أن الله رحيم)، والتأويل: (علمت رحمة الله)، ونحو: (شعرت بأنك قادم)، والتأويل (شعرت بقدومك). وإنما وجب تأويل ما بعد (أن) هنا بمصدر لأننا لو لم نؤوله، لكانت (يعجبني) بلا فاعل، (وعلمت) بلا مفعول، و (الباء) بلا مجرور فالمصدر المؤول: فاعل في المثال الأول، ومفعول في المثال الثاني، ومجرور بالباء في المثال الثالث. وإن كان لا يصح أن يؤول ما بعدها بمصدر (بمعنى أنه لا يصح تغيير التركيب الذي هي فيه) وجب كسر همزتها على أنها هي وما بعدها جملة، نحو: (إن الله رحيم). وإنما لم يصح التأويل بالمصدر هنا لأنك لو قلت: (رحمة الله) لكان المعنى ناقصاً. وان جاز تأويل ما بعدها بمصدر، وجاز ترك تأويله به، جاز الأمران، فتحها وكسرها نحو: (أحسن إليّ علي، أنه كريم)، فالكسر هنا على أنها مع ما بعدها جملة تعليلية، والفتح على تقدير لام الجر، فما بعدها مؤول بمصدر. والتأويل (أحسن إليه لكرمه). وحيث جاز الأمران فالكسر أولى وأكثر لأنه الأصل، ولأنه لا يحتاج معه الى تكلف التأويل). 11ـ مَواضعُ (إِنَّ) المكسُورة الهمزة وجوباً تُكسرُ همزةُ (إنَّ) وجوباً حيثُ لا يصحُّ أن يُؤَوّلَ ما بعدَها بمصدر، وذلك في اثنيْ عَشر موضعاً: أ ـ أن تقعَ في ابتداءِ الكلام، إمَّا حقيقةً، كقوله تعالى: {إنا انزلناهُ في ليلة القَدْرِ}، أو حُكماً، كقوله عَزَّ وجلَّ: {ألا إنَّ اولياءَ الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزَنون}. وإن وقعتْ بعدَ حرف تنبيه، كألا، اوِ استفتاحٍ، كألا وأمَا، او تحضيضٍ كهَلاً، أو رَدْعٍ، كَكَلاَّ، أو جوابٍ، كنَعْم ولا، فهي مكسورةُ الهمزةِ، لأنها في حكم الواقعة في الابتداء. وكذا إن وقعت بعدَ (حتّى) الابتدائية، نحو: (مَرِضَ زيدٌ، حتى إنهم لا يَرجونه، وقَلَّ مالُه، حتى إنهم لا يُكلّمونه). والجملة بعدَها لا محلَّ لها من الإعراب لأنها ابتدائيةٌ، او استئنافيّة. ب ـ أن تقعَ بعد (حيث) نحو: (اجلِسْ حيث إنَّ العلم موجود). ج ـ أن تقعَ بعد (إذْ) نحو: (جئتُكَ إذْ إنِّ الشمسَ تطلُعُ). د ـ أن تقعَ صدرَ الواقعةِ صِلَةً للموصول، نحو: (جاء الذي إنه مجتهدٌ)، ومنهُ قولهُ تعالى: {وآتيناهُ من الكنوزِ ما إن مَفاتحَهُ لتَنوء بالعُصبةِ أولي القوَةِ}. هـ ـ أن تقعَ ما بعدَها جواباً للقسَم، نحو: واللهِ، (إن العلمَ نورٌ)، ومنه قولهُ تعالى: {والقرْآنِ الحكيمِ، إنكَ لَمنَ المُرسلينَ}. و ـ أن تقعَ بعد القولِ الذي لا يَتضمَّنُ معنى الظنِّ، كقوله تعالى: {قال إني عبدُ اللهِ}، فان تَضمَّنَ معناهُ فُتحت بعدهُ، لأنَّ ما بعدَها مَؤوَّلٌ حينئذٍ بالمفعول به، نحو: (أتقولُ أن عبدَ الله يَفعلُ هذا؟)، أي: (أتظنُّ أنهُ يَفعلهُ؟). ز ـ أن تقعَ معَ ما بعدها حالاً، نحو: (جئتُ وإِنَّ الشمس تَغرُبُ)، ومنه قولهُ تعالى: {كما أخرجَكَ رَبُّكَ من بيتكَ بالحقِّ، وإنّ فريقاً منَ المُؤمنينَ لكارهون}. ح ـ أن تقعَ معَ ما بعدَها صفةً لما قبلها، نحو: (جاءَ رجلٌ إنه فاضل). ط ـ أن تقعَ صدرَ جملةٍ استئنافيَّةٍ، نحو: (يَزعُمُ فلانٌ أني أسأتُ إليه، إنه لكاذبٌ}. وهذهِ من الواقعة ابتداءً. ي ـ أن تقعَ في خبرِها لامُ الابتداء نحو: (علمتُ إنكَ لمجتهدٌ). ومنه قولهُ تعالى: {واللهُ يَعلمُ إنكَ لرسولُه، واللهُ يشهدُ إنَّ المُنافقينَ لكاذبون}. ك ـ أن تقعَ مع ما بعدَها خبراً عن اسم عين، نحو: (خليلٌ إنه كريمٌ) ومنه قولهُ تعالى: {إنَّ الذين آمنوا والذين هادوا والصّابِئينَ والنَّصارى والمجُوسَ والذينَ اشركوا، إنَّ اللهَ يَفصِلُ بينهم يومَ بالقيامة}. [اسم العين: هو ما دل على ذات، أي شيء قائم بنفسه. ويقابله اسم المعنى، وهو ما دل على شيء قائم بغيره: كالعلم والشجاعة ونحوهما * وجملة (إن الله يفصل بينهم ) خبر عن (إن الذين آمنوا وما عُطف عليه] |
Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.